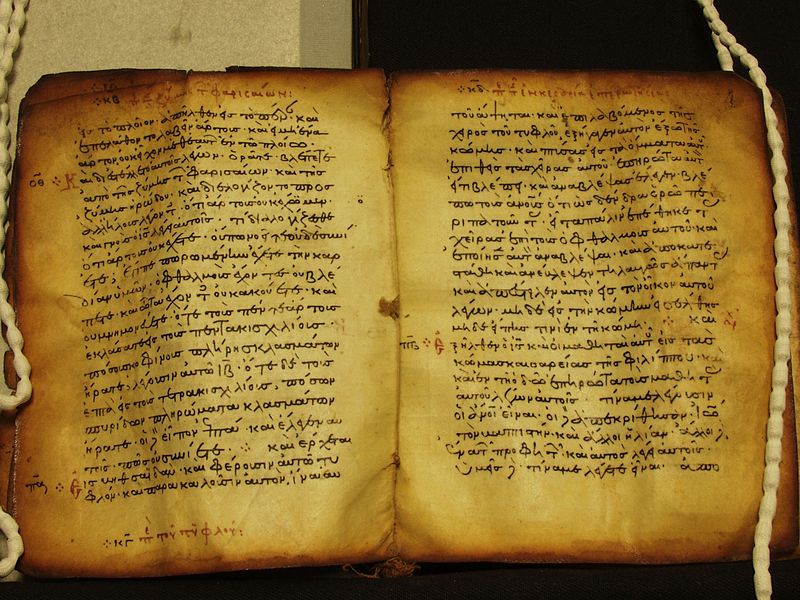الثالوث القدوس – دائرة المعارف الكتابية
الثالوث القدوس – دراسة دائرة المعارف الكتابية

تنبية: هذا الشرح وفقاً لدائرة المعارف الكتابية، وهناك بعض مما هو مذكور هنا لا نوافق عليه ولا نقرّه، لكن نقلنا ما جاء في دائرة المعارف للفائدة فحسب.
أولاً – كلمة الثالوث:
لم ترد كلمة “الثالوث” في الكتاب المقدس، حيث لا يَذكر الكتاب المقدس هذا اللفظ بالذات تعبيراً عن مفهوم أنه ليس هناك سوى الله الواحد الحقيقي، وأن في وحدانية الله ثلاثة أقانيم هم واحد في الجوهر ومتساوون في الأزلية والقدرة والمجد، لكنهم متمايزون في الشخصية. وعقيدة الثالوث القدوس عقيدة كتابية، ليس باعتبار ورودها نصاً في الكتاب المقدس، لكن باعتبارها روح الكتاب المقدس. والتعبير عن عقيدة كتابية بعبارات كتابية أفضل لحفظ الحق الكتابي.
وتظهر عقيدة الثالوث في نسيج الأسفار المقدسة، لا في صيغة محددة وإنما في إشارات متفرقة. وعندما نتحدث عن عقيدة الثالوث القدوس فإننا لا نخرج عن دائرة الكتاب ولكننا نجمع شتات هذه الإشارات في مفهوم عقائدي واضح. وقد نعبر عن هذه العقيدة بأسلوب فلسفي وبعبارات فنية لكنها لا تخرج بذلك عن كونها عقيدة كتابية.
ثانياً – الثالوث عقيدة مُعلنَة:
إن أساس عقيدة الثالوث هو الإعلان الإلهي، فهي تجسد الحق الذي لم يقدر العقل البشري الطبيعي أن يكتشفه، لن يقدر من ذاته، لآن الإنسان بكل ثاقب عقله، ليس في مقدوره أن يكتشف أمور الله العويصة، وبالتالي لم يكن لدى الفكر الوثني أي مفهوم ثالوثي عن الله، كما لم تقدم أي ديانة وثنية في تمثيلها لآلهتها شيئاً شبيهاً بعقيدة الثالوث القدوس.
وقد ظهرت – بلا شك – ثلاثيات من الآلهة في كل الديانات الوثنية تقريباً، وإن كانت الدوافع لظهور تلك الثلاثيات مختلفة. ففي الثلاثي أوزوريس وإيزيس وحورس صورة لعائلة بشرية مكونة من أب وأم وابن. وقد يظهر ثلاثي آلهة كمجرد محاولة للتوفيق بين ثلاثة آلهة تعبد في أماكن مختلفة، لتصبح موضع عبادة الجميع.
بينما يبدو من ثلاثي الديانة الهندوسية المكون من “براهما” و”فشنو” و”شيفا” أن هذا ثلاثي يمثل الحركة الدورية لتطور وحدة الوجود، ويرمز إلى المراحل الثلاثة من الكيان والصيرورة والانحلال. وفي بعض الأحيان يكون ثلاثي الآلهة نتيجة لميل طبيعي في الإنسان إلى التفكير في “ثلاثيات” مما أضفى على الرقم “ثلاثة” صبغة مقدسة.
وليس من غير المتوقع، أن تعتبر إحدى هذه الثلاثيات – بين الحين والآخر – أساساً لعقيدة الثالوث الأقدس في المسيحية. فجلادستون يرى هذا الثلاثي في أساطير هوميوس. في رمح بوسيدون ذي الشعب الثلاث. أما هيجل فقد رأى ذلك في الثلاثي الهندوسي، وهو ما يتفق مع عقيدته في وحدة الوجود.
وقد رأى البعض الآخر ذلك في الثلاثي البوذي، أو في بعض مفاهيم ديانة زرادشت، أو على الأغلب في الثلاثي العقلاني عند الفلسفة الأفلاطونية. بينما يؤكد جولز مارتن وجوده في المفهوم الرواقي الجديد عند “فيلو” عن “القوي” وبخاصة عند تفسيره لزيارة الثلاثة الرجال لإبراهيم.
ثم تحولت الأنظار إلى بابل حيث يجد “ه. زيمرن” مثالاً “للثالوث” متمثلاً في “أب وابن وشفيع” التي اكتشفها في ميثولوجيا بابل.
ولسنا في حاجة إلى التأكيد بأنه ما من ثلاثي من كل هذه، له أدنى شبه بالعقيدة المسيحية في الثالوث القدوس . فالعقيدة المسيحية عن الثالوث القدوس تجسد ما هو أكثر من مفهوم “الثلاثة”، وكل تلك الثلاثيات ليس فيها شيء شبيه بالعقيدة المسيحية سوى العدد “ثلاثة”.
ثالثاً – عقيدة الثالوث ليس لها برهان عقلاني:
لا يمكن إثبات عقيدة الثالوث القدوس بالعقل لأنها تسمو عن إدراك العقل، إذ ليس لها شبيه في الطبيعة ولا حتى في الطبيعة الروحية للإنسان المخلوق على صورة الله. فالثالوث الأقدس فريد لا مثيل له في الكون كله، عليه فليس ثمة ما يعيننا على فهمه. ومع ذلك بذلت محاولات عديدة لإيجاد برهان عقلاني على الثالوث القدوس الإلهي. وهناك اثنان من الأدلة العقلية لهما جاذبية خاصة لدى المفكرين عبر كل العصور المسيحية.
أولهما مشتق من مضمون “الإدراك الذاتي” والآخر من “الحب”، فكلاهما – الحب والإدراك الذاتي – يتطلبان وجود من يتجه إليه فعلهما. فإذا علمنا أن الله محب وذاتي الإدراك، فلا بد أن يكون في وحدانيته نوع من التعدد، ومن هذا المنطلق قام العديد من المفكرين بتقديم هاتين الحجتين في صور مختلفة.
قام بشرح البرهان الأول عالم لاهوتي كبير من القرن السابع عشر هو “بارثولوميو كيكرمان” (Bargholomew Keckrmann 1614 – م)، فقال: الله فكر ذاتي الإدراك، ولابد لفكر الله من موضوع كامل يتجه إليه فعل التفكير، ويكون أزلياً معه، ولكي يكون كاملاً فلابد أن يكون هو الله، ولما كان الله واحداً، فلابد أن يكون هذا الموضوع هو الله الواحد.
وينطبق نفس الأمر على البرهان المشتق من طبيعة الحب، ولعل أول من شرح هذا البرهان هو فالنتيوس حيث قال إن “الله محبة” ولكن الحب لا يكون حباً بغير وجود محبوب. ثم أثرى أوغسطينوس هذا المفهوم – ليس على أساس نظرية انبعاث – فهو يحلل هذا “المحب” الذي هو الله في الثلاثي المكون من “المحب” و”المحبوب” و” الحب ذاته”، ويرى في هذا الثلاثي تشبيهاً لله المثلث الأقانيم.
ولا يمكن أن ينصب حب الله المحب على العالم كمحبوب لأن هذا يعتبر تطرفاً، إذ لابد أن يكون المحبوب شخصاً، وأن يكون شخصاً مساوياً لله في سرمديته وقوته وحكمته، ولما كان من المحال وجود جوهرين إلهيين، فلابد أن يكون الأقنومان جوهراً واحداً، وبذلك يؤدي مفهوم الحب إلى ثالوث “الحب والمحب والمحبوب”.
ولكن كل هذه التشبيهات عرضة للجدل وللشطط، فالله لا مثيل له ولا شبيه وهو القائل:” فيمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس” (إش 40: 25).
رابعاً – تأييد العقل لهذه العقيدة:
وعلى أي حال، فإن التفكير على هذا النمط لشرح حقيقة الثالوث القدوس شرحاً عقلانياً لا يخلو من فائدة، فإنه يثبت لنا بوضوح أن مفهوم الثالوث عن الله يسمو عن مفهومه كوحدة بسيطة مطلقة، وبذلك يقدم سنداً عقلانياً لعقيدة الثالوث بعد أن أعلنها لنا الله ذاته، فإذا لم يكن من الممكن أن نقول: إننا نستطيع أن نفهم الله كالإدراك الذاتي الأزلي، كالمحبة الأزلية دون أن نفهمه كثالوث، فإنه يبدو من المحتم أن نقول: إننا عندما نفهمه كثالوث، فإن مفهومنا عن الكائن الأسمى المدرك في ذاته والمحب، يزداد عمقاً وقوةً وثراءً، وبذلك نفهمه فِهما أوفى مما لو حاولنا فهمه كوحدة بسيطة.
ومتى عرفه الإنسان كالله المثلث الأقانيم، فلا يمكن أن يقنع بمفهوم وحدوي عن الله. وعليه فإن العقل لا يؤدي هذه الخدمة السلبية للإيمان بعقيدة الثالوث القدوس ، بإظهار إتساق هذه العقيدة في ذاتها، واتساقها مع الحقائق المعلومة فحسب، بل ويقدم التأييد العقلاني الإيجابي باكتشاف أنه المفهوم الوحيد الشافي الوافي عن الله كروح مدرك بذاته، ومحبة حية. ومهما كانت الصعوبة في عقيدة الثالوث القدوس في ذاتها، فإنها لا تضيف عبئاً على ذكائنا، بل بالحري تأتي لنا بحل أعمق المعضلات وأعتاها في مفهومنا عن الله كالكائن الأدبي اللامتناهي، وتنير كل فكرنا عن الله وتثريه وتسمو به.
لذلك أصبح من الحق أن نقول إن التوحيد في المسيحية هو التوحيد الوحيد الراسخ، أي أن عقيدة الثالوث القدوس تزيد التوحيد ثراء وقوة ورسوخاً في العقل البشري، فالعقل يجد صعوبة في فكرة الوحدانية المطلقة في الله، والقلب البشري يلتمس بشوق ولهفة، الله الحي الذي في كيانه يوجد هذا الملء من الحياة، وهو ما يمدنا به مفهوم الله المثلث الأقانيم.
خامساً – عقيدة الثالوث غير معلنة بوضوح في العهد القديم:
تحس دوائر عريضة بأن مفهوم الثالوث القدوس أمر جوهري لأي فكرة صحيحة عن الله، حتى ليرفضون بشدة فكرة أن يعلن الله عن ذاته دون أن يعلن ثالوثه، ومن هذا المنطلق يرون أنه ليس من المعقول ألا يذكر العهد القديم شيئاً عن الثالوث. ولا نستطيع أن نتكلم بتوسع عن إعلان عقيدة الثالوث في العهد القديم، ولكن من الحقائق الواضحة أنه لم يستطع أحد – اعتماداً على الإعلان الموجود في العهد القديم فحسب – أن يصل إلى عقيدة الثالوث.
ولكن من الآخر، ألا توجد في أسفار العهد القديم تعبيرات أو أحداث يستطيع شخص قد عرف عقيدة الثالوث تماماً، أن يجد في هذه التعبيرات والأحداث، تلميحات معقولة تنم عن هذه العقيدة؟ لقد وجد الكتّاب الأقدمون تلميحات عن الثالوث في مثل استخدام صيغة الجمع في كلمة “إلوهيم” (صيغة الجمع من “الله”) وكذلك الإشارة إلى الله بضمائر الجمع كما في القول: “وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا” (تك1: 26، 3: 22، 11: 7، إش 6: 8) أو الأفعال في صيغة الجمع في العبرية (كما في تك 20: 13، 35: 7).
وتكرار اسم الله مما يبدو منه أن ثمة تمييز بين الله والله (كما في مزمور 45: 6و7، 110: 1، هو 1: 7)، والأناشيد التي لها صورة ثلاثية (تث 6: 4، عدد 6: 24-26، إش 6: 3)، وتجسيد مفهوم الحكمة (أمثال 8)، والظواهر الملفتة للنظر التي صاحبت ظهورات “ملاك الرب” (تك 16: 7-13، 22: 11و16، 31: 11و13، 48: 15و16، خر 3: 2و4و5، قض ض3: 20-22….).
وهناك اتجاه قوي عند الكثيرين من الكتّاب في الوقت الحاضر إلى الاستناد، ليس على آيات محددة في العهد القديم، بل على إعلان العهد القديم ككل، حيث يلاحظون هذا الفكر الكامن فيه، بأن كل الأشياء تدين بوجودها وبقائها إلى مصدر مثلث، سواء فيما يتعلق بالخليقة الأولى، أو بأكثر وضوح فيما يتعلق بالخليقة الثانية، ويستشهدون بالفصول التي تجمع بين الله وكلمته وروحه (كما في مز 33: 6، إش 61: 1، 63: 9-12، حجي 2: 5و6).
ويشيرون إلى الاتجاه الملحوظ لتجسيد كلمة الله من ناحية (كما في تك 1: 3، مز 33: 6، 107: 20، 119: 87، 147: 15-18، إش 55: 11، 63: 10، حز 2: 2، 8: 3، زك 7: 12)، وما جاء بنبوة إشعياء عن ألوهية المسيا ( كما في إش 7: 14، 9: 6). وإذا كانت صيغة الجمع في اسم الله أو في الضمائر والأفعال التي تسند إلى الله، ليست بدلائل كافية على أن الله مثلث الأقانيم، ولكن لها وزنها كشاهد على أن “إله الوحي ليس وحدة بسيطة مطلقة، بل هو الله الحي الذي يحتض في ملء كيانه أعظم تنوع” (كما يقول بافينك).
وخلاصة القول هي أن الإحساس العام هو أن في تطور الفكر عن الله في العهد القديم، تكمن فكرة أن الله ليس مجرد وحدة بسيطة، وأنه بذلك كان يمهد الطريق لإعلان الثالوث فيما بعد. ويبدو أنه من الواضح أن علينا أن ندرك من العهد القديم التعليم المتعلق بالعلاقة بين الله وإعلانه من خلال الكلمة الخالق والروح، وهو ما أوضحه الإعلان المسيحي.
ولا نستطيع الوقوف هنا، إذ أنه بعد كل ما قيل، وفي ضوء الإعلان الكامل في العهد الجديد، نجد أن التفسير الثلاثي يظل هو التفسير الطبيعي للظواهر التي فسرها قدامى الكتّاب كتلميحات للثالوث، وبخاصة تلك المتعلقة بأوصاف ملاك الرب، وكذلك بعض صيغ الكلام التي تواجهنا في العهد القديم مثل: “نعمل الإنسان على صورتنا” (تك 1: 26) لأن العدد السابع والعشرين: “فخلق الله الإنسان على صورته” يحول بيننا وبين اعتبار أن العدد السابق يعلن أن الإنسان قد خلق على صورة الملائكة.
وليست هذه قراءة متعسفة لأفكار العهد الجديد في ثنايا العهد القديم، بل هي قراءة نصوص العهد القديم في ضوء إعلان العهد الجديد، فيمكن تشبيه العهد القديم بغرفة فاخرة الأثاث ولكنها ضعيفة الإضاءة، وتسليط نور أقوى عليها لا يضيف إليها شيئاً لم يكن فيها من قبل، ولكنه يكشف بوضوح عما فيها مما لم يكن يرى مطلقاً. إن العهد القديم لا يعلن سر الثالوث، ولكن سر الثالوث يكمن في إعلان العهد القديم، وتظهر لمحات منه في بعض أجزائه، فإعلان العهد الجديد عن الله لم يصوب إعلان العهد القديم بل بالحري أكمله ووسّعه وأوضحه.
سادساً – العهد القديم مهّد الطريق لهذه العقيدة:
من الأقوال المتواترة منذ القديم، أن ما يبدو واضحاً جلياً في العهد الجديد كان كامناُ مستتراً في العهد القديم، ومن أهم الأمور أن نضع في أذهاننا بجلاء استمرارية إعلان الله في العهدين القديم والجديد، وإذا عسرت علينا رؤية بعض النقاط في العهد القديم فيما يتعلق بإعلان “الثالوث”، فإنه لا يفوتنا أن نرى بكل وضوح وجلاء – في العهد الجديد – وفرة من الأدلة على أن كتّاب العهد الجديد لم يروا أي تعارض بين تعليمهم عن الثالوث، ومفهوم العهد القديم عن الله.
لم يشعر كتّاب العهد الجديد مطلقاً بأنهم “ينادون بآلهة غريبة”، بل كانوا يعرفون تماماً أنهم يعبدون ويكرزون بإله إسرائيل، ولم يكن تأكيدهم على وحدانيته بأقل من تأكيد العهد القديم (يو 17: 3، كو 8: 4، 1تي 2: 5). فهم لم يضعوا إلهين جديدين بجانب “يهوه”، بل رأوا في يهوه نفسه الآب والابن والروح القدس، ولم يراودهم اطلاقاً الاحساس بأنهم يبتدعون شيئاً جديداً. وبلا أدنى خوف أو تردد استشهدوا بأقوال العهد القديم، وطبّقوها على “الآب والابن والروح القدس” الله الواحد، الله المعلن في العهد القديم، ولم يكونوا يرون اطلاقاً أن ثمة ثغرة بينهم وبين الآباء في تقديم مفهومهم الواضح عن الكائن السماوي.
ولكن ليس معنى هذا أنهم كانوا يرون تعليم الثالوث ظاهراً في كل جزء من العهد القديم، ولكنه يعني – بكل تأكيد – أنهم كانوا يرون أن الله المثلث الأقانيم الذي يعبدونه، هو نفسه الله المعلن في العهد القديم، ولم يجدوا أي تناقض في حديثهم عن الله المثلث الأقانيم فإله العهد القديم هو إلههم، وإلههم إله مثلث الأقانيم، وكان إدراكهم أن الإثنين واحد، إدراكاً واعياً كاملاً حتى إنه لم يثر في أذهانهم من نحو هذه الحقيقة أي تساؤل.
سابعاً – العهد الجديد يفترض العلم بذلك مسبقاً:
إن البساطة واليقين اللذين يبدوان في كتابات العهد الجديد عن الله المثلث الأقانيم، لهما مضمون أعمق، فهما يدلان على أنه لم يكن ثمة إحساس بوجود أمر جديد في الحديث عن الله بهذه الصورة، وبعبارة أخرى، إننا عندما نقرأ العهد الجديد لا نجد مولد مفهوم جديد عن الله، بل ما نجده على صفحاته إنما هو مفهوم ثابت راسخ عن لله يتخلل كل نسيجه، وينطق في كل صفحاته.
فالعهد الجديد حتى الصميم يعلن الله المثلث الأقانيم، وكل تعليمه ينبني على افتراض التسليم بعقيدة الثالوث، والإشارات الضمنية إلى ذلك كثيرة وتأتي طبيعية وقاطعة وحاسمة وواثقة. إن عقيدة الثالوث تبدو في العهد الجديد، لا كتعليم في طور النمو، بل كتعليم في ملء النضح والكمال، حتى ليقول أحدهم (سانداي): “لا يوجد في تاريخ الفكر البشري ما هو أعجب من الطريقة الصامتة بالغة الدقة التي أخذت بها هذه العقيدة (عقيدة الثالوث) مكانها – رغم صعوبتها لنا – بين الحقائق المسيحية الثابتة، بدون أي مجادلة أو مقاومة”.
ولكن تعليل هذه الظاهرة الرائعة بسيط، فالعهد الجديد ليس سجلاً لتطور العقيدة أو استيعابها، ولكنه في كل أجزائه يفترض أنها العقيدة الثابتة الراسخة في المجتمع المسيحي.
ثامناً – ظهرت في الابن والروح القدس:
إذا توخينا الدقة، فإننا لا نستطيع أن نقول إن عقيدة الثالوث قد أعلنت في العهد الجديد، مثلما لا نستطيع أن نقول إنها قد أعلنت في العهد القديم، فالعهد القديم سبق إعلانها، والعهد الجديد جاء بعدها، فالإعلان ذاته لم يكن بالأقوال بل بالأعمال والواقع. لقد حدث إعلانها في تجسد الله الابن، وفي انسكاب الله الروح القدس. وعلاقة العهدين بهذا الإعلان هي أن أولهما مهد الطريق له، وأن ثانيهما كان حصيلة هذا الإعلان، أما الإعلان ذاته فقد تجسد في المسيح والروح القدس. وهذا معناه أن إعلان الثالوث كان النتيجة الحتمية لإتمام عمل الفداء.
لقد حدث هذا في مجيء ابن الله في شبه جسد الخطية ليقدم نفسه ذبيحة عن الخطية، وفي مجيء الروح القدس ليبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. هكذا تم إعلان الأقانيم الثلاثة في الله الواحد. والذين عرفوا الله الآب الذي أحبهم وبذل ابنه ليموت عنهم، والرب يسوع المسيح الذي أحبهم وأسلم نفسه لأجلهم قرباناً وذبيحة، والروح القدس، روح النعمة، الذي أحبهم ومنحهم قوة في داخلهم – ليست منهم – تعمل للبر، هم الذين عرفوا الله المثلث الأقانيم، ولا يمكنهم أن يفكروا في الله أو يتحدثوا عنه بصورة أخرى.
وبعبارة أخرى، إن عقيدة الثالوث هي ببساطة، تعبير عن مفهوم الله الواحد الوحيد في ضوء إعلانه الكامل لنفسه في عملية الفداء. لذلك كان لابد أن يتم عمل الفداء قبل إعلانها الكامل، ففي عمل الفداء أُعلنت بكمالها.
ومن هذه الحقيقة المركزية نستطيع أن نفهم – بأكثر وضوح – ظروفاً كثيرة ارتبطت بإعلان عقيدة الثالوث، فمثلاً نستطيع أن نفهم لماذا لم يعلن الثالوث في العهد القديم. ولعله يلزمنا أن نرجع إلى الملحوظة التي ترددت كثيراً منذ عهد جريجوري النازيانزي، وهي أن العهد القديم اهتم بأن يثبت في أذهان شعب الله وقلوبهم الحق الأساسي العظيم عن وحدانية الله، وكان من العسير أو من الخطر التحدث إليهم عن التعدد داخل هذه الوحدانية إلا بعد أن يتم عمل الفداء.
فالسبب الحقيقي في تأخير إعلان حقيقة الثالوث، إنما يرجع إلى التقدم الزمني نحو إتمام قصد الله في الفداء، فلم يكن الزمان قد نضح لإعلان الثالوث في وحدانية الله، إلى أن جاء ملء الزمان وأرسل الله ابنه للفداء، وروحه للتقديس. كان يجب أن ينتظر الإعلان بالقول، حتى يتم الإعلان واقعياً، ليقدم التفسير اللازم، فهو – بلا شك- يستمد من هذا الواقع كل معناه وقيمته.
فإن إعلان الثالوث في وحدانية الله، كحق مجرد، بدون الاستناد إلى حقيقة ظاهرة، وبدون ارتباط بتقدم ملكوت الله، كان يبدو غريباً عن كل أسلوب خطة الله، كما تعرضها لنا صفحات الأسفار المقدسة، فإن خطوات إتمام القصد الإلهي تمدنا بالمبدأ الأساسي الذي يستند إليه كل شيء آخر، حتى مراحل تقدم الإعلان ذاته، فمراحل تقديم الإعلان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمراحل إتمام الفداء.
ونستطيع أيضاً أن نفهم من نفس تلك الحقيقة المركزية لماذا نجد العهد الجديد يعلن “الثالوث” في تلميحات ضمنية وليس بعبارات واضحة، ولماذا يفترضه دائماً، ولا يذكره إلا في عبارات متفرقة وليس في صيغة عقائدية محددة، وذلك لأن الإعلان بعد أن تم واقعياً في الفداء، أصبح يملأ قلوب كل المؤمنين، فكان المسيحيون في كتاباتهم وأحاديثهم بعضهم مع بعض، يتكلمون عن هذا الحق المشترك، ويذكر أحدهم الآخر بذخيرة الإيمان التي لهم جميعاً، لابد أن يعلموا بعضهم بعضاً ما أصبح معروفاً لهم جميعاً.
وعلينا أن نرجع إلى العهد الجديد، لنجد في كل التلميحات للثالوث، دليلاً على كيفية فهم المعلمين القادة في الكنيسة لحقيقة الثالوث التي كان يؤمن بها الجميع، وليس على محاولتهم إقناع الكنيسة بأن الله مثلث الأقانيم.
تاسعاً – كل العهد الجديد يبتضمن هذه العقيدة:
إن البرهان الأساسي لحقيقة أن الله مثلث الأقانيم، يقدمه لنا الإعلان الأساسي للثالوث واقعياً، أي في تجسد الله الابن وانسكاب الله الروح القدس. وبالإيجاز، إن يسوع المسيح والروح القدس هما البرهان الأساسي لحقيقة الثالوث، ومعنى هذا أن كل دليل – مهما اختلف نوعه أو مصدره – على أن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وأن الروح القدس أقنوم إلهي، وهو دليل على صحة عقيدة الثالوث، وأننا عندما نرجع إلى العهد الجديد بحثاً عن دليل على الثالوث، فعلينا أن نبحث عنه ليس في التلميحات المتفرقة فحسب – مع تنوعها ووضوحها – بل نبحث عنه أساساً في الأدلة الكثيرة التي يقدمها لنا العهد الجديد على ألوهية الابن، وأقنومية الروح القدس.
وهذا يعني أن كل العهد الجديد هو دليل على الثالوث، فالعهد الجديد زاخر بالأدلة على ألوهية المسيح وأقنومية الروح القدس. وعلى وجه التحديد، ما العهد الجديد إلا توثيق لعقيدة تجسد الابن وانسكاب الروح القدس، أي لعقيدة الثالوث. وما نعنيه “بعقيدة الثالوث” هو الصياغة لمفهوم الله في عقيدة الابن المتجسد والروح القدس المسكب، في عبارة دقيقة. ونستطيع تحليل هذا المفهوم وإثبات كل عنصر فيه من أقوال العهد الجديد، كما يمكننا إثبات أن العهد الجديد يؤكد وحدانية الله، وأنه على الدوام يعتبر الآب الله، والابن الله، والروح القدس الله، وأن كلاً منهم أقنوم متميز.
ولا يسعنا هنا التكلم بتوسع عن هذه الحقائق الواضحة، ويكفينا أن نلاحظ أنه في العهد الجديد لا يوجد سوى الله الحي الحقيقي الواحد الوحيد، وأن يسوع المسيح هو الله، بكل ما في الكلمة من معنى، وأن الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم متميزون.
وفي هذه الحقيقة المركبة، يقدم لنا العهد الجديد عقيدة الثالوث، لأن عقيدة الثالوث ماهي إلا التعبير الدقيق عن هذه الحقيقة المركبة. وفي كل المحاولات لصياغة هذه العقيدة بدقة، كان المبدأ الأساسي الذي يحكم كل صياغة هو التعبير بدقة عن مفهوم العلاقة بين الله الآب، والله الابن والله الروح القدس من ناحية، ووحدانية الله من الناحية الأخرى، وكذلك عن ألوهية الابن وألوهية الروح القدس، وتميز كل أقنوم.
وبقولنا هذه الحقائق الثلاث، أي أنه لا يوجد إلا إله واحد، وأن الآب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله، وأن كلاً من الآب والابن والروح القدس، أقنوم متميز، نكون قد عبّرنا عن عقيدة الثالوث في كمالها.
إن عقيدة الثالوث هي الحقيقة الأساسية التي لابد أن نلحظها في كل العهد الجديد كافتراض ثابت، في جميع أجزائه وبمختلف الصور، وعلينا ألا نهمل القول إنها في بعض المواضع قد لا يعبر عنها بكل كماله، ولكن الفصول التي يذكر فيها الأقانيم الثلاثة معاً، أكثر مما نظن بوجه عام، ولكن علينا أن نذكر أيضاً أن الجمع بين الأقانيم الثلاثة قد يكون في الكتابات العملية، أقل منه في الكتابات التعليمية، فنرى الأقانيم الثلاثة في البشارة بمولد ربنا يسوع المسيح إذ يقول الملاك لمريم: “الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله” (لو 1: 35، انظر أيضاً متى 1: 18-23).
وهنا نرى أن الروح القدس هو العامل في إتمام الأمر، كما أن ذلك ينسب إلى قوة العلي وأن المولود هكذا في العالم يطلق عليه هذا الاسم الجليل “ابن الله”. كما نرى الأقانيم الثلاثة بكل وضوح في انجيل متى (1: 18-23)، وإن كنا نجد أن التلميحات للأقانيم الثلاثة متفرقة في ثنايا القصة التي يشار فيها مرتين إلى ألوهية المولود (عدد 21: “لأنه يخلص شعبه من خطاياهم”. وفي عدد 23: “ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا”).
وفي مشهد المعمودية – الذي يسجله كل البشيرين في بداية خدمة يسوع – نرى الأقانيم الثلاثة في صورة درامية تؤكد ألوهية كل أقنوم بشدة (مت 3: 16و17، مرقس 1: 10و11، لو 3: 21و22، يوحنا 1:23-34)، فمن السماء المفتوحة، ينزل الروح القدس في هيئة منظورة، وصوت من السماء: “أنت ابني الحبيب الذي به سررت” (مرقس 1: 11). ويبدو أن ثمة قصداً واضحاً في أن يكون مجيء الابن هو الوقت المناسب لإعلان الله المثلث الأقانيم، لكي يهيء – بأيسر سبيل – عقول الناس للتكيف مع متطلبات الفداء الإلهي، الذي كان في طريقه إلى الإتمام.
عاشراً – هذه العقيدة تتخلل كل تعليم يسوع:
إن هذه العقيدة تتخلل كل تعليم يسوع، فقد ذكر الكثير عن الله أبيه الذي هو متميز عنه وفي نفس الوقت واحد معه. كما ذكر الكثير عن الروح القدس الذي يمثله كما يمثل هو الآب، والذي يعمل بواسطته، كما أن الآب يعمل بواسطته. ولا يقتصر هذا على تعليم يسوع في إنجيل يوحنا، بل وفي الأناجيل الثلاثة الأولى، يعلن يسوع بنوته الفريدة لله (مت 11:27، 24: 36، مرقس 13: 32، لو 10: 22).
كما أن لقب “ابن الله” ينسب إليه، ويقبله هو (مت 4: 6، 8: 29، 14: 33، 27: 40و43و54، مرقس 3: 11، 12: 6-8، 15: 39، لو 4: 41، 22: 7، انظر ايضاً يوحنا 1: 34و49، 9: 35، 11: 27)، والذي يتضمن مشاركة تامة في العلم والسلطان. ويسجل متى (11: 27) ولوقا (10: 22) إعلانه العظيم بأنه يعرف الآب كما أن الآب يعرفه تلك المعرفة المتبادلة الكاملة: “ليس أحد يعرف الابن إلا الآب. ولا أحد يعرف الآب إلا الابن”.
كما أنه في الأناجيل الثلاثة الأولى، يقول يسوع إنه يعمل أعماله بروح الله: “ولكن إن كنت أنا بروح الله”، أو كما يقول لوقا: “ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين” (مت 12: 28، لو 11: 20، مع الوعد بالروح القدس في مرقس 13: 11، لو 12: 12).
حادي عشر – الآب والابن في إنجيل يوحنا:
يتكلم المسيح كثيراً في أحاديثه المدونة في إنجيل يوحنا عن وحدته – هو كالابن – مع الآب، وعن عمل الروح القدس كالمنفذ للأعمال الإلهية، فهو لا يكتفي بالتصريح بكل جلاء أنه والآب واحد (10: 30 مع 17: 11و21و22و25) في وحدة متداخلة أو متبادلة: “الآب فيَّ وأنا في الآب” (10: 38 مع 16: 10و11).
وأن من رآه فقد رأى الآب (14: 9 مع 15:21) بل يزيل كل شك في طبيعة وحدته مع الآب بتأكيد أزليته تأكيداً صريحاً قاطعاً: “قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن” (يو 8: 58)، وأنه كائن مع الآب منذ الأزل: “الذي كان لي عندك قبل كون العالم” (يو 17: 5 مع 17: 18، 6: 62)، ومقاسمته المجد منذ الأزل مع الآب: المجد الذي كان لي عندك” الذي كان مشتركاً معك “قبل كون العالم” (17: 5)، يعلن هذا بكل هذا الوضوح حتى إنه كثيراً ما قال عن نفسه “ابن الله” (5: 25، 9: 35، 11: 4، انظر أيضاً 10: 36)، وكان معنى هذا – كما فهم اليهود بحق – أنه “معادل لله” (5: 18)، أو بعبارة أوضح يجعل نفسه “إلهاً” (10: 33).
ولكن كيف وهو المعادل لله، بل بالحري هو الله، يأتي إلى العالم؟ يفسر هو نفسه هذا بأنه “خرج” – هو بنفسه – ليس من محضر الآب (16: 28، 13: 3) أو من الشركة مع الآب (16: 27، 17: 8) بل من الآب نفسه (8: 42، 16: 30)، وهو يؤكد بذلك أن موضعه الأزلي هو صميم الكيان الإلهي، كما أنه يؤكد أقنوميته المتميزة مع الآب: “لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني لأني خرجت من (قِبَل) الله وأتيت. لأني لم آت من نفسي بل ذاك أرسلني” (8: 42).
كما يقول أيضاً: “في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من “عند”. الآب وقد أتيت إلى العالم” كما يقول أيضاً: “هم قبلوا وعلموا يقيناً أتي خرجت من عندك (من الشركة معك) وآمنوا أنك ارسلتني” ولا يتسع المجال للتوسع في شرح تعبير، تميزت به أحاديث الرب يسوع المسجلة في إنجيل يوحنا، وهو تعبير يقابلنا في كل صفحة من صفحات هذا الإنجيل.
ويجمع بين التصريح الواضح بوحدة الآب والابن في الجوهر، والتصريح الواضح أيضاَ بالتمييز بين الأقنومين تمييزاً لا يسمح بتبادل العواطف كالمحبة مثلاً (17: 24 مع 15: 9، 3: 35، 14: 31) فحسب، بل وتبادل الفعل ورد الفعل إلى أبعد الحدود، فنجد مثلاً أن من أبرز الحقائق في أحاديث الرب أنه يذكر مراراً بأن الله “قد أرسله” من ناحية، ومن الناحية الأخرى أنه “خرج من قِبَل الآب” (كما في يوحنا 8: 42، 10: 36، 17: 3، 5: 23).
وليس هذا قاصراً على إنجيل يوحنا فقط، بل يذكر أيضاً في الأناجيل الثلاثة الأخرى (كما في لو 4: 43، مرقس 1: 38، لو 9: 48، 10: 16، 4: 34، 5: 32، 7: 19، 19: 10).
ثاني عشر – الروح في أحاديث الرب يسوع في إنجيل يوحنا:
وهناك أمر بالغ الأهمية، وهو أن هذه الظاهرة، أي العلاقة المتبادلة، ليست قاصرة على الآب والابن فحسب، ولكنها تمتد أيضاً إلى الروح القدس. فمثلاً في حديث للرب أكد فيه كل التأكيد، وحدته الجوهرية مع الآب: “لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً، “الذي رآني فقد رأى الآب”، “أنا في الآب والآب فيَّ، الآب الحال فيِّ هو يعمل الأعمال” (يو 14: 7و 9و10)، في هذا الحديث نفسه.
نقرأ أيضاً: “وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر (وهنا تأكيد واضح على أنه أقنوم متمييز عن أقنوم الابن) ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق. لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى. إني آتي إليكم.. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي. إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي (أي الآب والابن كلاهما) وعنده نصنع منزلاً… بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم” (يو 14: 16-26). وليس هناك كلام أوضح من هذا عن الأقانيم الثلاثة الذين هم في نفس الوقت “الله الواحد”. فهنا نرى الآب والابن والروح القدس متميزين كل منهم عن الآخر.
فالابن يطلب من الآب، والآب يستجيب للطلب ويرسل المعزي الآخر” (أي أنه غير الابن)، ويرسله باسم الابن، ومع ذلك لا تغيب وحدة هؤلاء الأقانيم الثلاثة، حتى إن مجيء “المعزي الآخر”، يذكر – بكل بساطة ووضوح – باعتباره مجيء الابن نفسه (الأعداد 18و19و20و21)، بل وفي الحقيقة باعتباره مجيء الآب والابن (عدد 23)، فنجد هنا المفهوم بأنه متى ذهب المسيح، فإن الروح القدس يأتي بدلاً منه، كما نجد أيضاً المفهوم بأنه عندما يأتي الروح القدس، يأتي المسيح فيه، وبمجيء المسيح يأتي الآب أيضاً.
فهناك تمييز بين الأقانيم الثلاثة، وهناك أيضاً وحدة بينهم. ونجد نفس الظاهرة في فصول أخرى، فنقرأ في يوحنا (15: 26): “ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند (الشركة مع) الآب ينبثق فهو يشهد لي”، وفي هذه الآية بالذات نرى بجلاء أن الروح متميز عن الابن، ومع ذلك فهو نظيره منذ الأزل مع (في شركة مع) الآب الذي منه ينبثق أو يخرج للقيام بدوره في عمل الخلاص، والذي سيرسله – في هذه المرحلة – ليس الآب بل الابن.
وتظهر هذه الصورة بأقوى تأكيد في فصل آخر يحدثنا عن عمل الروح بالارتباط مع الابن، مماثل لعمل الابن بالارتباط مع الآب (16: 5-15): “وأما الآن فانا ماض إلى الذي أرسلني…. لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء يبكت العالم …على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاً… إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن.
وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي. لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم”. وهنا نرى الابن يرسل الروح القدس لكي يواصل عمل الابن ويطبقه، فهو يأخذ ارساليته من الابن، وليس في ذلك انتقاص من قدر الآب، لأننا عندما نتكلم عن أمور الابن، فمعناه أننا نتكلم عن أمور الآب.
ولسنا نقول إن عقيدة الثالوث مذكورة بالتحديد في مثل هذه الفصول التي تتخلل كل نسيج أحاديث ربنا يسوع المسيح في إنجيل يوحنا، ولكنها بكل تأكيد تفترضها ضمناً، وهذا أفضل وأوقع من ناحية قوة الدليل، فكلما نقرأ، نجد أننا على اتصال مستمر بالثلاثة الأقانيم الذين يعملون كأقانيم متميزين، ومع ذلك فهم واحد بكل ما في هذه الكلمة من قوة وعمق، لأنه لا يوجد سوى “إله واحد” – وما في هذا من شك – ومع ذلك فالابن الذي أرسله الله إلى العالم، لا يمثل الله فحسب، لكنه هو الله.
والروح الذي أرسله الابن بدوره إلى العالم. وهو أيضاً الله نفسه. وليس هناك ما هو أوضح من أن الابن والروح القدس أقنومان متميزان، وأن ابن الله هو الله الابن، وروح الله هو الله الروح.
ثالث عشر – صيغة المعمودية:
إن أقرب التعبيرات إلى أن تكون صيغة رسمية لعقيدة الثالوث، هي الصيغة التي سجلها العهد الجديد من فم الرب نفسه، ونحن لا نجدها في إنجيل يوحنا، بل في أحد الأناجيل الثلاثة الأولى، وهي تأتي عرضا بالارتباط – أساساً – بشيء آخر غير وضع صيغة لعقيدة الثالوث، فقد جاءت ضمناً في إرسالية الرب للتلاميذ بعد القيامة، “كأمر بالمسير”، “إلى إنقضاء الدهر”، حيث قال لهم: “اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس” (مت 28: 19).
وفي محاولة تقييم هذا التصريح العظيم، يجب أن نضع في أذهاننا، ما صاحب هذا النطق السامي من مهابة وجلال، مما يستلزم إضفاء بالغ التقدير لكل كلمة في العبارة التي تستلفت النظر. فهو لا يقول “بأسماء” (بالجمع) “الآب والابن والروح القدس”، أو ما يمكن أن يعادل ذلك: “باسم الآب، وباسم الابن، وباسم الروح القدس” وكأن الأمر يرتبط بثلاثة أشخاص منفصلين. كما أنه لم يقل: باسم الآب وابن وروح قدس” وكأن الألفاظ الثلاثة ألقاب لشخص واحد، ولكن بكل قوة وجلال يؤكد وحدة الثلاثة بربطهم داخل حدود “اسم واحد”، ثم يؤكد أيضاً تميز كل منهم بذكر كل منهم بأداة التعريف “الـ”، “باسم الآب والابن والروح القدس”.
فالآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم متميزون، وهؤلاء الثلاثة الآب والابن والروح القدس يتحدون في معنى سامٍ عميق في “الاسم الواحد”. ولكي ندرك ما يتضمنه هذا الأسلوب من الكلام، يجب أن نضع في أذهاننا أهمية كلمة “اسم” وما ارتبط بها من معان في أذهان من وجهت لهم هذه الارسالية، لأن الشخص العبراني لم يكن يفهم من كلمة “اسم” – كما نفهم نحن – على أنه مجرد رمز خارجي، بل أنه بالحري تعبير وافٍ عن أعماق كيان صاحبه.
فكلمة “باسمه” تعبير عن كل كيان الله، واسم الله – “هذا الاسم الجليل المرهوب الرب إلهك” (تث 28: 58) – كان في الدرجة القصوى من القداسة، لأنه كان يعني الله نفسه، فلا غرابة أن نقرأ : “هو ذا اسم الرب يأتي” (إش 3: 27)، بل والأكثر من ذلك: “فيخافون من المغرب اسم الرب، ومن مشرق الشمس مجده، عندما يأتي … كنهر فنفخة الرب تدفعه” (إش 59: 19). كل هذه المعاني كان يتضمنها الاسم، حتى إن للفظ وحده بدون أي إضافة، كان يكفي كتعبير كافٍ عن جلال الله، فكان من أشنع الخطايا “التجديف على الاسم” (لا 24: 11).
وكل الذين دعي “اسم يهوه” عليهم كانوا له، ملكه وهو المتكفل بحمايتهم، ولأجل اسمه، صرخ شعب يهوذا المتألم إلى رجاء إسرائيل مخلصه في وقت الضيق: “وأنت في وسطنا يا رب وقد دعينا باسمك. لا تتركنا” (ارميا 14: 9). وقد وجد شعبه أن أفضل تعبير عن خزيهم العميق هو في تلك المرثاة: ” قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم ولم يدعَ عليهم باسمك” (إش 63: 19)، بينما يجدون أعظم تعبير عن الفرح في هتافهم: “لأني دعيت باسمك يا رب اله الجنود” (ارميا 15: 16 انظر 2أخ 7: 14، دانيال 9: 18و19).
لذلك عندما يأمر الرب تلاميذه بتعميد من تلمذوهم له: “باسم…” كان يستخدم لغة لها عندهم معناها السامي العميق، فلم يكن ممكناً أن يفهموا إلا أنه كان يستبدل “اسم يهوه” بهذا الاسم الجديد: “اسم الآب والابن والروح القدس”، ولم يكن يعني عند التلاميذ إلا أن “يهوه” يجب أن يعرف عندهم بالاسم الجديد، “اسم الآب والابن والروح القدس”، وإلا كان معنى ذلك أن يسوع كان يضع مكان يهوه إلهاً جديداً للمجتمع الذي كان يؤسسه، ويكون هذا شيئاً مهولاً جداً.
فلا يمكن إذاً أن يكون هناك مفهوم آخر غير أن يسوع كان يعطي لمجتمعه اسماً جديداً ليهوه، وأن هذا الاسم الجديد هو الاسم الثلاثي “اسم الآب والابن والروح القدس” كما لا يوجد أدنى شك في أن المقصود من “الابن” في هذا الاسم الثلاثي هو يسوع نفسه مع كل ما يتضمنه ذلك من تمييز الأقانيم الثلاثة، فهو يعلن بكل جلاء أن يهوه إله اسرائيل، هو الله المثلث الأقانيم، لذلك كانت هذه الصيغة تقريراً واضحاً لعقيدة الثالوث، ونحن لا نجد هنا ميلاد عقيدة الثالوث، بل نراها أمراً مقرراً ضمناً، ولكننا نرى هنا الاعلان القاطع بأن الله مثلث الأقانيم، فهذا ما يقرره مؤسس المسيحية بكل مهابة وجلال.
لقد عبد اسرائيل الإله الواحد الحقيقي باسم “يهوه”، أما المسيحيون فإنهم يعبدون نفس الإله الواحد الحي الحقيقي باسم “اسم الآب والابن والروح القدس”، وهذا هو ما يميز المسيحية، وهو يعني أن عقيدة الثالوث – حسب مفهوم الرب نفسه – هي العلامة المميزة للديانة التي أسسها.
رابع عشر – أصالة صيغة المعمودية:
إن حقيقة لها مثل هذه الأهمية البالغة، لم يكن ممكناً أن تنجو من النقد والتحدي. فثمة محاولة – أقل ما توصف به أنها محاولة طائشة – لاستبعاد هذه العبارة من إنجيل متى. ولكن كل الأدلة الخارجية تنقض هذه المحاولة، كما أن الأدلة الداخلية ليست بأقل جزماً في ذلك.
فعندما يعترضون على أصالتها بحجة “شمولية” العبارة “وصبغتها الكنسية” “ولاهوتها العالي”، فإنهم ينسون أن يسوع – في إنجيل متى – لا تنسب إليه أمثال الخميرة وحبة الخردل فحسب، بل تنسب إليه أيضاً تصريحات مثل تلك الواردة في مت 8: 11و12، 21: 43، 24: 14، وأن هذا الإنجيل، وهو وحده الذي يسجل ذكر يسوع لكنيسته (16: 18، 18: 17) وأنه بعد التصريح العظيم (مت 11: 27- 30) لا يستعصي نسبة شيء – مهما عظم – إليه، فعندما يعترضون على أصالة هذه العبارة وصدورها من فم يسوع نفسه، فالواضح أنهم يفكرون في يسوع آخر غير يسوع الأناجيل.
فهذا التصريح الذي يسجله متى (28: 19) ينسجم كل الانسجام مع يسوع الذي يقدمه انجيل متى كما سبق القول، بل وينسجم تماماً أيضاً مع كل العهد الجديد. ويكفينا هنا أن نقول إن تاريخية هذه العبارة التي يهاجمونها، يؤيدها ارتباطها التاريخي بباقي الأقوال، فليس يسوع وحده هو الذي يتكلم بمفهوم ثلاثي بل كل كتّاب العهد الجديد يفعلون نفس الشيء، فإنَّ تمسك كل أتباعه كل هذا التمسك بهذه العقيدة، يستلزم افتراض أن هذا التعليم – الذي ينسب هنا للرب يسوع – قد ورد حقيقة في أمره لأتباعه.
وأمام كل هذا، ليس من المعقول أن نشك في صدوره منه بينما الإنجيل ينسبه إليه بكل جلاء وتوكيد.
خامس عشر – الثالوث عند بولس:
عندما ننتقل من أحاديث يسوع، إلى كتابات أتباعه لنرى كيف أن العقيدة تتخلل كل النسيج، فمن الطبيعي أن نرجع إلى رسائل بولس، وهي تستلفت النظر بكثرتها، وبالدليل القاطع الذي لا لبس فيه على أنها كتبت في أثناء الجيل الذي عاصر موت الرب وقيامته، مما يضاعف من أهميتها كشاهد تاريخي، وهي – في الحقيقة – تتضمن كل ما يثري الشهادة لمفهوم الله المثلث الأقانيم الذي يتخلل كل نسيجها. ففي جميع الرسائل من تسالونيكي الأولى – التي كتبت حوالي 52 م – إلى الرسالة الثانية إلى تيموثاوس – التي كتبت حوالي 68 م – نجد أن الفداء الذي هو
الموضوع الأساسي الذي تريد إعلانه وتوكيده مع كل البركات التي يتضمنها أو التي ترتبط به، إنما ترجع جميعاً – على الدوام – إلى الله المثلث الأقانيم، فعلى كل موضع من صفحاتها، يظهر أمامنا الله الآب والرب يسوع المسيح والروح القدس، والغرض الوحيد لكل عبادة، والمصدر الواحد الوحيد لكي الأمور.
وبالنسبة للبساطة واليسر في ذكر هذه التلميحات إلى هذه العقيدة، قد نجد في بعض المواضع أن أحد الأقانيم يبرز أكثر من الآخرين، أو يبرز اثنان منهم في توجيه الشكر أو الصلاة، ولكن ليس من النادر أن يذكر الأقانيم الثلاثة معاُ، عندما يحاول أن يعبر عن مديونيته “لإله كل نعمة” أو للتعبير عن شوقه أو شوق قرائه إلى شركة أعمق مع إله كل نعمة.
فالمألوف عنده أن يبدأ رسائله بصلاة طالباً “النعمة والسلام” لقرائه من “الله أبينا والرب يسوع المسيح” كالمصدر الوحيد لكل البركات السماوية (رومية 1: 7، 1كو 1: 3، 2كو 1:2، غل 1: 3، أف 1: 2، في 1: 2، 1تس 1: 1، 2 تس 1: 2، 1تي 1: 2، 2 تي 1: 2، فيليمون 3).
وليس مما يعتبر خروجاً على هذه القاعدة – في حقيقة الأمر – بل مما ينسجم مع نفس الفكر عندما يذكر الروح القدس معهما كما في الرسالة الثانية إلى كورنثوس (13: 14). فهو يذكر أيضاً في الصلاة الختامية لطلب النعمة الذي يختم به بولس رسائله والذي يأخذ عادة هذه الصيغة البسيطة: “نعمة ربنا يسوع المسيح معكم” (رومية 16: 20، 1كو 16: 23، غل 6:18، في 4: 23، 1تس 5: 28، 2تس 3: 18، فيليمون 25). وبصيغة موسعة كما في “من الله الآب والرب يسوع المسيح” (أف 6: 23و24).
أو بصيغة موجزة كما في “النعمة معكم” (كو 4: 18، 1تي 6: 22، 2تي 4: 22، تي 3: 15). وبين الافتتاحية والخاتمة، نجده يذكر باستمرار الله الآب والرب يسوع المسيح والروح القدس، إما تصريحاً – وهو الغالب – أو تلميحاً.
إن الرسول بولس يؤكد بشدة على وحدانية الله، فالأساس الأول لفكره كله هو وحدانية الله (رو 3: 30، 1كو 8: 4، غل 3: 20، إف 4: 6، اتي 2: 5، مع رومية 6: 27، اتي 1: 17). ولكن لم يكن الله الآب – بالنسبة له – أكثر ألوهية من الرب يسوع المسيح أو الروح القدس. فالروح القدس بالنسبة لله، كروح الإنسان بالنسبة للإنسان (اكو 2: 11)، وعليه، إذا كان روح الله ساكناً فينا، فمعنى ذلك أن الله يسكن فينا (رومية 8: 10و11).
ونحن – بناء على هذه الحقيقة – هياكل لله (اكو 3: 16). وقد استخدم أقوى التعبيرات لتأكيد ألوهية المسيح، فهو “الله العظيم” (تي 2: 13)، وهو “الكائن على الكل إلهاً مباركاً” (رو 9: 5). بل يقول بكل جلاء إنه “فيه يحل كل ملء اللاهوت” أي أنه يوجد فيه “كل ما في اللاهوت”. وفي كل مرة يؤكد فيها على وحدانية الله، فإنه يعتبر “الرب يسوع المسيح” في هذا “اللاهوت الفريد”، فهو يؤكد أنه “ليس إله آخر إلى واحداً” ثم يثبت هذا التوكيد بأنه قد يوجد عند الوثنيين آلهة كثيرون وأرباب كثيرون “ولكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء
ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به” (اكو 8: 4و5و6). ومن الواضح أن هذا “الإله الواحد، الآب” “والرب الواحد يسوع المسيح” يجتمعان في الله الواحد” الذي ليس إله آخر غيره. فمفهوم بولس عن الله الواحد الذي يعبده، يتضمن – بعبارة أخرى – أنه داخل كيان الله الواحد، يوجد ثلاثة أقانيم متميزون في “الله الواحد الآب”، “والرب الواحد يسوع المسيح”.
سادس عشر – الجمع بين الثلاثة في كتابات بولس:
في كل كتابات الرسول بولس العديدة من أولى رسائله (1تس 1: 2-5، 2تس 2: 13و14) إلى آخر رسائله (تي 3: 4-6، 2تي 1: 3و13و14) يستحضر أمامنا الأقانيم الثلاثة: الله الآب والرب يسوع المسيح والروح القدس – بطريقة لا افتعال فيها – كالمصدر الوحيد لكل بركات الخلاص التي للمؤمنين بالمسيح. ونجد سلسلة مثالية لذلك في الرسالة إلى أفسس (2: 18، 3:2-5و14و17، 4: 4-6، 6: 18-20).
ولكن لعل أعظم مثال هو ما نجده في الرسالتين إلى أهل كورنثوس حيث يتكلم بولس عن المواهب الروحية الموجودة والتي بارك الله بها الكنيسة (1كو 12: 4-6) من ثلاثة جوانب، يربط بينها وبين الأقانيم الثلاثة: “فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد. وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل”. وقد يظن البعض أن هناك نوعاُ من الافتعال في اعتبار المواهب عطايا من الروح القدس، وأنها خدمات للمسيح، وأعمال لله، ولكنها بهذه الصورة تعلن بصورة مذهلة، الأقانيم الثلاثة.
فبولس يكتب ذلك، ليس لأن المواهب والخدم والأعمال تبدو أمام فكره كأشياء عظيمة متنوعة، بل لأن الله والرب والروح يشغلون فكره باستمرار، كالعلة المثلثة وراء كل إظهار للنعمة. وهنا نرى تلميحاً للثالوث أكثر منه تصريحاً، ولكنه تلميح يثبت أن عقيدة الثالوث تشكل أساس كل فكر بولس عن الله، إله الفداء. ولعل الأعمق من ذلك ما جاء في كورنثوس الثانية (13: 14) والتي أصبحت تستخدم في الكنائس وتسمى البركة الرسولية: “نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم”.
وهنا يجمع بين بركات الفداء العظمى الثلاث، ويربط كلا منها بأقنوم من أقانيم اللاهوت الثلاثة. ولسنا نجد هنا أيضاً صياغة رسمية لعقيدة الثالوث القدوس ، ولكنه مثال آخر لورود هذا المفهوم – عن الله المثلث الأقانيم – في سياق الحديث.
فبولس هنا يتكلم عن المصدر الإلهي لهذه البركات العظمى، ولكنه كأمر مألوف عنده – يفكر في المصدر الإلهي لبركات الفداء بأسلوب ثلاثي، فهو لا يقول – كما كان يحتمل أن يقول “نعمة ومحبة وشركة الله تكون معكم” بل “نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس، مع جميعكم” وهكذا يقدّم شهادة قوية – والأرجح أنه لم يقصد إلى ذلك، ولكن بكل وضوح – على أن الله مثلث الأقانيم.
سابع عشر – الثالوث عند سائر كتّاب العهد الجديد:
يتكرر مفهوم بولس عن الثالوث القدوس في سائر كتابات العهد الجديد، ففي كل هذه الكتابات نجد هذا المفهوم بأن كل أعمال الله في الفداء، ترجع إلى مصدر ثلاثي: الله الآب والرب يسوع المسيح والروح القدس. ويبرز هؤلاء الأقانيم الثلاثة معاً مراراً وتكراراً تعبيراً عن الرجاء المسيحي وموضوع تعبد المسيحيين (مثلاً عب 2: 3و4، 6: 4- 6، 10: 29- 31، 1بط 1:2، 2: 3- 12، 4: 13- 19، 1يو 5: 4- 8، يهوذا 20و21، رؤ 1: 4- 6).
ولعل خير مثال لذلك: “بمقتضى علم الله السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح” (1بط 1: 2)، “مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية” (يهوذا 20و21)، ويمكن أن نضيف إلى هذين، العبارة النموذجية الواردة في رؤيا يوحنا: “نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض” (رؤ 1: 4و5).
ومن الواضح الجلي أن هؤلاء الكتاب يكتبون عن عقيدة ثابتة بالثالوث القدوس ويقدمون شهادتهم للمفهوم الشامل الذي كان سائداً في الدوائر الرسولية. فكان الجميع في كل مكان يعلمون أن الله الواحد الذي يعبده المسيحيون، والذي منه وحده نالوا الفداء وكل ما أتى به الفداء معه من بركات، كان في وحدانيته: ” الله الآب والرب يسوع المسيح والروح القدس” وأن هذا لا يقلل من وحدانيته. كما فهموا أن لكل أقنوم عمله بالنسبة للآخرين.
هذه هي الشهادة المضطردة المنتشرة في كل العهد الجديد. ومما يزيد في قوتها أنها تأتي بصورة طبيعية بسيطة لا افتعال فيها. وسواء كانت النظرة إلى الله في ذاته أو في أعماله، فإن المفهوم هو نفسه في كل حال.
ثامن عشر – اختلاف في التسمية:
لا يمكن أن تفوت القارئ ملاحظة أن عبارات التثليث التي استخدمها بولس وغيره من كتّاب العهد الجديد، ليست هي بالنص العبارات المسجلة في أحاديث الرب نفسه في الأناجيل (ماعدا إنجيل يوحنا) فبولس وغيره من كتّاب العهد الجديد لا يذكرون نفس العبارة التي كان يستخدمها الرب أي “الآب والابن والروح القدس” بل ذكروا: “الله والرب يسوع والروح القدس”، وهذا الاختلاف في التسمية له ما يبرره إلى أبعد حد في اختلاف العلاقة بين المتكلم وأقانيم الثالوث القدوس .
فلم يكن الرب ليتكلم عن نفسه كواحد من الأقانيم بكلمة “الرب” بينما كانت كلمة “الابن” – التي كانت تعبر بدقة عن معرفته بالعلاقة بالوثيقة بل وبمعادلته الكاملة بالله – تجري على فمه في سهولة ويسر. ولكن “الابن: كان هو “الرب” لبولس، وكان من الطبيعي أن يفكر فيه بولس وأن يتحدث عنه هكذا.
بل لقد كانت كلمة “الرب” من أحب الكلمات لبولس وصفاً للمسيح، حتى لقد أصبحت عنده اسم علم للمسيح، بل بالحري الاسم الإلهي للمسيح، فكان من الطبيعي أن يستخدمه في حديثه عن الثالوث القدوس ، فهو يذكر الأقانيم الثلاثة من حيث علاقته بهم، وليس من حيث علاقتهم بعضهم ببعض. فبولس يرى في الثالوث القدوس إلهه وربه والروح القدس الذي يسكن فيه. وعلى هذا الأساس يذكرهم على هذه الصورة دائماً.
ومن الملفت للنظر أيضاً أن كتَّاب رسائل العهد الجديد، لا يلتزمون دائماً بنفس الترتيب الذي استخدمه الرب في إرساليته العظمية (مت 28: 19)، بل يختلف الترتيب من موضع لآخر، بل قد نجد ترتيباً عكسياُ (اكو 12: 4-6، أف 4: 4-6). وقد يكون ذلك ترتيباً إقتضاه الكلام، ولكنه – مع ذلك – يتفق مع الترتيب الذي ذكره الرب (مت 28: 19). ولكن كثيراً ما يختلف الترتيب بين الأقانيم الثلاثة، ففي كورنثوس الثانية (13: 14) نجد الترتيب “الرب، الله، الروح “، مما يدل على أن ترتيب الأقانيم لم يكن وارداً كأمر جوهري في العقيدة.
تاسع عشر – مضمون “ابن” و “روح”:
هذه الحقائق لها أهميتها في شهادة العهد الجديد للعلاقة المتبادلة بين أقانيم الثالوث. فحقيقة الثالوث القدوس – أي وجود ثلاثة أقانيم في وحدانية الله، لكل منهم عمله الخاص به في إتمام الخلاص – حقيقة يشهد بها العهد الجديد بكل وضوح وشمول وإصرار وجزم. وهذه الشهادة تتضمن أيضاً الجزم بأن الأقانيم الثلاثة متساوون في اللاهوت، وأن الاسم الذي يطلق على كل منهم هو “الاسم الذي فوق كل اسم”. وإذا حاولنا الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك لمعرفة فكر كتَّاب العهد الجديد عن الأقانيم الثلاثة، فستواجهنا صعاب هائلة.
وقد يبدو من المنطقي أن نفترض أن العلاقات المتبادلة بين الأقانيم معلنة في الألقاب “الآب والابن والروح القدس” ذكرها الرب في إنجيل متى (28: 19)، ولكن ثقتنا في هذا الافتراض تهتز بعض الشيء عندما نلاحظ – كما أسلفنا – أن كتَّاب العهد الجديد لا يراعون ذكر نفس هذه الألقاب في إشاراتهم إلى الثالوث القدوس ، ولكنها تقتصر على أحاديث الرب وإشارات الرسول يوحنا التي تشبه إلى حد بعيد أقوال الرب.
فقد يكون من الطبيعي أن نرى في التعبير “الابن” تلميحاً إلى التبعية والاشتقاق. وقد لا يكون من العسير أيضاً تطبيق نفس المفهوم على التعبير “الروح”، ولكن من المؤكد غاية التأكيد أن هذا لم يكن مدلول هذه التعبيرات في الفكر السامي الذي يكمن وراء لغة الكتاب المقدس.
إن مفهوم البنوية في لغة الكتاب هو “المشابهة” فكما يكون الآب هكذا “الابن” أيضاً، فإطلاق لفظة “الابن” على أحد أقانيم الثالوث القدوس إنما يؤكد مساواته للآب وليس تبعيته للآب، ووصفه “بالابن الوحيد” (يو 1: 14و18، 3: 16-18، 1يو 4: 9) إنما ليؤكد – ليس الإشتقاق – بل التفرد أو الذي بلا نظير (مز 22: 20، 25: 16، 35: 17). وكذلك عبارة “بكر كل خليقة” (كو 1: 15) لا تحمل معنى بدء الوجود، يل بالحري تؤكد سبق الوجود.
ونفس الأمر مع التعبير “روح الله” أو “روح الرب”، الذي نلتقي به كثيراً في العهد القديم، فهو لا يحمل أي معنى من الإشتقاق أو التبعية، ولكنه يعني “الله” من وجهة نظر نشاطاته. وليس ثمة ما يجعلنا نفترض أن التعبير قد تغيرت دلالته بالانتقال من العهد القديم إلى العهد الجديد. علاوة على ذلك فإننا نجد في العهد الجديد ما يكاد يكون تعريفاً محدداً لكلمتي “ابن” و”روح”، وفي كلتا الحالتين نجد أن التركيز ينصب على المساواة أو المماثلة، فنقرأ في إنجيل يوحنا: ” فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه.
لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضاً إنَّ الله أبوه معادلاً نفسه بالله” (5: 18). ويسوع وحده هو الذي له الحق في أن يقول إن “الله أبوه” ليس بالمعنى المجازي كما قيل عن إسرائيل إنه ابن الله البكر، بل بالمعنى المباشر الحقيقي. وكان معنى هذا أنه مثل الله تماماً، أي “معادل الله، لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله” (اكو 10و11).
وهنا يبدو الروح أنه هو العامل في معرفة الله لذاته، أو بعبارة أخرى أنه هو الله نفسه بكل عمق جوهر كيانه، فكما أن روح الإنسان هو مقر الحياة البشرية، فهو ذات حياة الإنسان، وهكذا روح الله هو جوهر حياته، فكيف يمكن افتراض أنه أقل من الله. فإذا استقر مفهوم هذا الاستخدام لكلمتي “الابن” و”الروح”، فإننا نرى أنه ليس في العهد الجديد ما يدل على عدم المساواة بين الأقانيم الثلاثة.
العشرين – مسألة التبعية والخضوع:
لا شك في أنه فيما يتعلق بعمل كل أقنوم من الأقانيم في عملية الفداء، أو في الدائرة الأوسع، دائرة معاملات الله مع العالم، نلمح نوعاً من التبعية، فكل ما يعمله الآب، إنما يعمله من خلال الابن بالروح القدس (رومية 2: 16،3: 22، 5: 1، 11، 17، 21، إف 1: 5، 1تس 5: 9، تي 3: 5). والابن قد أرسله الآب وكل مشيئة الآب يتمم (يو 6: 38). والروح القدس قد أرسله الابن، وهو لا يتكلم من نفسه بل يأخذ مما للمسيح ويخبر التلاميذ (يو 16: 7-14). ويقول الرب نفسه: “إنه ليس … رسول أعظم من مرسله” (يو 13: 28).
بل ويعلن صراحة: “أبي أعظم مني” (يو 14: 28). ويقول الرسول بولس إن “المسيح لله” كما أننا نحن للمسيح (1كو 3: 23). لكن كل هذا نجد له تفسيراً فيما قام به المسيح في عمل الفداء. ولابد أن نضع في اعتبارنا أن علاقة التبعية التي نلمحها هنا في العمل، قد لا تكون سوى نتيجة عهد أو اتفاق بين الأقانيم الثلاثة، وبه تولى كل أقنوم عملاً معيناً في الفداء، كما أن هناك حقيقة تجسد المسيح حيث أخذ “الابن” طبيعة البشر، وبذلك دخل في علاقات جديد مع الآب لها صبغة التبعية.
ومع أنه لا شك في أنه في مواضع كثيرة حيث يذكر “الآب” و”الابن”، يمكن حمل ذلك على علاقات تدبيرية، لكن من المؤكد أن “الآب” و”الابن” تدلان أيضاً على علاقة أبدية، ولكنهما لا تدلان مطلقاً على “الأول” أي الأسمى، و “الثاني” أي الأدنى فيما يتعلق بالجوهر. وإن حقيقة اتضاع ابن الله لإتمام عمل الفداء على الأرض، لتضيف عنصراً جديداً في تفسير الفصول التي تشير إلى خضوعه وطاعته للآب.
ويجب أن ندرك أنه في ضوء تعاليم العهد الجديد العظيمة عن عهد الفداء من ناحية، وعن اتضاع ابن الله لكي يتمم عمله على الأرض، والطبيعتين اللتين أصبحتا للمسيح بالتجسد من الناحية الأخرى، تزول الصعوبة في تفسير تلك الفصول التي فيها إشارة للتبعية. ففي ضوء هذه الحقائق، يصبح من غير المنطقي التركيز على تلك الفصول، وبخاصة أن المساواة الكاملة بين الأقانيم تتخلل وتتأكد في كل نسيج العهد الجديد.
الحادي والعشرين – الشهادة للمفهوم المسيحي:
وهكذا نجد أن حقيقة الأقانيم الثلاثة في اللاهوت التي أعلنت في التجسد وعمل الله الابن في الفداء، وحلول الله الروح وعمله المخلِّص، حقيقة واضحة في العهد الجديد، وتتلألأ على كل صفحاته. وحيث أن جذور إعلانها توجد في عملية الفداء، فمن الطبيعي أن نجد صداها في وعي كل فرد قد اختبر هذا الخلاص.
فكل نفس قد تمتعت بالفداء، تعلم أنها قد صولحت مع الله بابنه وأنه قد أحياها بروحه، وترجع إلى الآب والابن والروح القدس بكل إجلال وإقرار بالفضل، هاتفة من الأعماق: “ربي وإلهي”، وإن كان يعسر عليها إدراك عقيدة الثالوث القدوس من اختبارها للخلاص، فإن عناصر اختبارها للخلاص لا يمكن فهمها وتفسيرها إلا بتعليم الثالوث القدوس، الذي تجده متضمناً في كل تعليم الكتاب بخصوص عمل الفداء، ويضفي عليه دلالة واتساقاً.
فبواسطة هذا التعليم يمكن للمؤمن أن يرى بكل وضوح علاقته المثلثة بالله الذي اختبر خلاصه، كالمحبة الأبوية في إرسال الفادي وكالمحبة الفادية في إتمام عمل الفداء، وكالمحبة المخلّصة في العمل في قلب الإنسان لقبول الفداء. وكل هذه الجوانب مع اختلاف الأساليب وتميز الأدوار، إنما هي من محبة الله الواحد، التي تفتش على الإنسان وتخلصه بناء على عمل الفداء.
وبدون عقيدة الثالوث القدوس ، يعتري الارتباك حياته المسيحية الواعية ويحيط بها الغموض والتشويش، ويضفي عليها جواً من الوهم أو الخيالية، ولكن بتعليم الثالوث القدوسيتحقق الاتساق والواقع والحقيقة في كل نواحيها. وعليه فإن عقيدة الثالوث القدوس وعقيدة الفداء تقومان – تاريخياً – معاُ أو تسقطان معاً.
ويقول “أ. كوينج”: ” لقد عرفت أن الكثيرين لا ينكرون كل تاريخ الفداء، إلا لسبب واحد، وذلك لأنهم لم يصلوا إلى مفهوم الله المثلث الأقانيم”. وهذا الارتباط الوثيق بين عقيدتي الثالوث القدوس والفداء، هو الذي جعل الكنيسة لا تستريح إلا بعد أن وصلت إلى صياغة عقيدة الثالوث القدوس في عبارة محددة متقنة، إذ ليس ثمة أساس راسخ آخر لاختبار الخلاص المسيحي. لقد ظل قلب الإنسان قلقاً مضطرباً إلى أن وجد راحته في الله المثلث الأقانيم رئيس الخلاص ومكمله والعامل في قلب الإنسان لقبوله.
الثاني والعشرين – صياغة العقيدة:
لقد كان الحافز القوي لصياغة عقيدة الثالوث القدوس، هو اقتناع الكنيسة المطلق الراسخ بألوهية المسيح الكاملة، التي هي محور كل المفهوم المسيحي عن الله منذ نشأة المسيحية، وكان المبدأ الهادي في صياغة العقيدة، هو صيغة المعمودية كما أعلنها الرب يسوع نفسه (مت 28: 19) فقد كان هذا الإعلان هو أساس إجراء المعمودية و”قوانين الإيمان” التي بدأت صياغتها في كل الكنيسة.
فكان هذان المبدآن الأساسيان: ألوهية المسيح الحقيقية، وصيغة المعمودية، هما المرجع والمحك في كل محاولات صياغة العقيدة المسيحية عن الله، وعلى أساسهما أمكن أن يكون للكنيسة صيغة محددة يتحقق فيها كل ما يتعلق بإعلان الفداء كما يستعرضه العهد الجديد، كما تتحقق فيها مطالب القلب المسيحي في اختباره للخلاص.
وبطبيعة الحال، كان الوصول إلى صياغة العقيدة بطيئاً، فقد كان للعقائد الموروثة وللفلسفات السائدة أثرها في محاولات وضع صياغة محددة للتعبير عن هذا الحق الجوهري من الإيمان المسيحي. وكانت الكنيسة تهتدي في كل المواقف بصيغة المعمودية” (مت 28: 19)، وجعلت منها أساساً “لقانون الإيمان”. وكان لترتليان أكبر الأثر – بقوة حواره – في التعبير عن عقيدة الثالوث القدوس بصيغة قوية محددة. ولعله هو أول من استخدم كلمة “الثالوث”.
وفي منتصف القرن الثالث ظهرت بدعة سابليوس الذي زعم أن “الآب والابن والروح القدس” هي ألقاب مختلفة للكائن الإلهي الواحد في مظاهر نشاطه المتنوعة، فهو مرة الآب، ومرة الابن، مرة الروح القدس. وأعقب ذلك ظهور بدعة أريوس الذي زعم أن الابن مخلوق، وإن كان أسمى من كل المخلوقات لآنه هو خالقها وربها.
وكان هذا سبباً في عقد مجمع نيقية في 325م حيث برز “أثناسيوس” واستطاع بقوة منطقه وغيرته المتقدة، ومعه الأبطال الكبدوكيون الثلاثة (الغريغوريان وباسيليوس) – أن يدحض كل هذه البدع، فيقر المجمع العقيدة الصحيحة:
“نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق كل الأشياء ما يرى، وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود من الآب، المولود الوحيد، من جوهر الآب، إله من إله نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء في السماء وعلى الأرض، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل وتجسد وتأنس وتألم وقام أيضاً في اليوم الثالث وصعد إلى السماء، وسيأتي ليدين الأحياء والأموات، وبالروح القدس….”
وقد قبلت كل الكنيسة هذه الصيغة. وبعد نحو قرن من مجمع نيقية، تبلور قانون الإيمان على يد أوغسطينوس وأصبح القانون الفعلي لكل الكنيسة إلى هذا اليوم. وقد احتاج الأمر – بين الحين والآخر – إلى إعادة التأكيد على المساواة التامة بين الأقانيم، وكان لجون كلفن في القرن السادس عشر دور هام في تأكيد هذا الحق.
الثالوث القدوس – دراسة دائرة المعارف الكتابية
- انجيل توما الأبوكريفي لماذا لا نثق به؟ – ترجمة مريم سليمان
- مختصر تاريخ ظهور النور المقدس
- هل أخطأ الكتاب المقدس في ذِكر موت راحيل أم يوسف؟! علماء الإسلام يُجيبون أحمد سبيع ويكشفون جهله!
- عندما يحتكم الباحث إلى الشيطان – الجزء الأول – ترتيب التجربة على الجبل ردًا على أبي عمر الباحث
- عندما يحتكم الباحث إلى الشيطان – الجزء الثاني – ترتيب التجربة على الجبل ردًا على أبي عمر الباحث