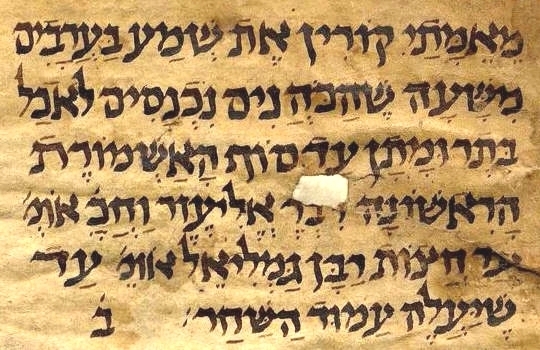الرؤية الإسخاتولوجية للكنيسة – د. سعيد حكيم يعقوب
الرؤية الإسخاتولوجية للكنيسة – د. سعيد حكيم يعقوب

الرؤية الإسخاتولوجية للكنيسة – د. سعيد حكيم يعقوب
ترى التعاليم اللاهوتية الآبائية في الجذور الأولى للخلق والبُعد الأخروي للحياة مسيرة روحية واحدة. فالرؤية الكتابية والتقليد الكنسي، يتحركان في هذا الإطار ويؤكدان على أن الحياة مستمرة وممتدة، ولها بُعد أخروي. إن الحياة الحاضرة التي نحياها لا تنحصر في أُطر تاريخية، إذ هي تتسع لتشمل الخليقة كلها، بكل جوانبها. فالكون، والتاريخ، والإنسان، والمجتمع، كلها أمور تشكل محور الحقيقة الكتابية والكنسية.
التقليد الكنسي يؤكد على هذه الرؤية اللاهوتية، إذ أن الكنيسة تحيا حقيقة الحياة الجديدة، وتتذوق عربون الحياة الأبدية من الآن بالنعمة الإلهية التي تعطي لكل ممارسيها حيوية وإلهام خاص.
هذه العطية الإلهية هي التي تُنبئ بأن تحقيق الوعد بالأرض الجديدة والسماء الجديدة هو أمر مؤكد. لأن حقيقة هذه الأرض الجديدة المملوءة قداسة ومحبة وفرحًا تتجلى في أحشاء الكنيسة التي تتذوق من الآن خيرات الحياة الأبدية. فالتقليد الكنسي يهدف إلى تحقيق الصلاح الإلهي، الذي فقدته البشرية مبكرًا ، ويؤكد على الرجاء في اكتمال المسيرة نحو الحياة الأبدية، حتى يتحقق الكمال الذي نترجاه في الحياة الفردوسية المجيدة. واللاهوت الأرثوذكسي حين يتكلم عن الحياة الفردوسية، فهو يعني بشكل أساسي أمرين:
- المسيرة التي يسلك فيها الإنسان لكي يتجاوز مرحلة العدم ويصل إلى مرحلة الكمال.
- الدخول النهائي إلى ملكوت الله، والتمتع بمجد هذا الملكوت.
هذا ما يؤكده العلاّمة أوريجينوس بقوله: [يوجد في ملكوت الله “أرضًا” موعود بها للودعاء، أرض تسمي بـ ” أرض الأحياء “. أرض موضوعة على مرتفعات والتي قال عنها النبي بحق: ” فيرفعك لترث الأرض ” (مز34:37). هذه هي الأرض التي ترثها النفس المؤمنة بالله بعد الخروج من هذا العالم. والمقصود بها هنا أولئك الذين عاشوا بدون الناموس. وهنالك الذين وضعتهم العناية الإلهية وتدابيرها في الإيمان والنعمة بيسوع المسيح ][1].
لقد وصف الآباء الفردوس وقدموه كحقيقة محسوسة ومُدركة داخل البيئة التاريخية والطبيعية، إلى أن حدث الخروج من الفردوس، حين كسر المخلوق وصية خالقه.
وهنا تبرز حقيقة مهمة للغاية وهى أن الحياة الفردوسية تبدأ من المعطيات الخاصة بهذا العالم الحاضر، في مسيرة متنامية وصولاً إلى مرحلة كمال الكون كله المحسوس والمدرك. إن الفردوس الذي يبدأ في هذا العالم يعني دخول كل ما هو محسوس ومدرك في مجال ملكوت الحياة الإلهية.
وفشل الإنسان في تحقيق هذا الهدف، يفرض عليه إلتزامًا بتصحيح مسيرته مرة أخرى وتوجهه نحو تحقيق الصلاح الأبدي والذي يفوق حالة الإنسان الأولى، فليس هناك حديثًا لا في العهد القديم ولا في التعاليم اللاهوتية الأرثوذكسية عن عودة الإنسان لحالته الأولى فقط. فالإنسان في الفردوس لم يفقد نوعًا من الصلاح كان عليه أن يستعيده، لكنه فقد الشركة مع الله، فانقطعت المسيرة نحو الكمال الذي هو قصد الله من خلق الإنسان.
وطالما أن الحياة الفردوسية هي مسيرة نحو الكمال، نحو التلامس مع المجد الإلهي، الذي يبدأ من الآن ويكتمل في الحياة الأبدية. فإن ملامح هذه الحياة الفردوسية تتضح هنا في هذه الحياة الحاضرة، ويستطيع المرء أن يختبر هذه الحقيقة من خلال إتحاده بالله، ولذلك فإن حياة الجحيم هي على العكس تمامًا، هي فقدان للشركة مع الله، أي عدم الدخول في مجال الحياة الإلهية داخل الزمن، وبناءً عليه فقدان التمتع بالمجد الإلهي.
فالشياطين رغم أنها تؤمن بالله، إلاّ أنه يستحيل عليها رؤية المجد الإلهي، لأنها لا تأتي في شركة مع الله[2]. وهكذا يستطيع المرء أن يُدرك أن حياة الجحيم ليست حالة خاصة يفرضها الله على الإنسان طبقًا لقانون محدد. فالله يحتضن الكل الأبرار والأشرار. إلاّ أن الأشرار لا يستطيعون أن يرون مجد الله، لأنهم يشعرون بأنه يُعاقِب، وهذه الحالة ترتبط بموقفهم تجاه الله، وليس العكس.
إذًا الجحيم بحسب الرؤية الآبائية هو حرمان من التمتع بالمجد الإلهي، وعن هذا الأمر يقول ق. باسيليوس بأنه [ حرمان كبير وخسارة فادحة، ونحن نستطيع أن نتفهم هذا، لو أننا قابلنا بين هذه الحالة وحالة الأعمى، فالأعمى يخسر الكثير، لأنه لا يرى نور الشمس ][3].
إذًا فالجحيم هو عدم الشركة مع الله فالشركة مع الله هي التي تعكس جمال وبهاء الحياة الفردوسية.
توجد في أقوال الآباء الشيوخ قصة تُروى عن ق. مقاريوس الكبير، تُخبرنا بأن القديس مقاريوس بينما كان يمشي في البرية وجد جمجمة لإنسان هرطوقي، فطرق عليها بعصاه، فعلى الفور شعرت نفس ذلك الهرطوقي وهى في الجحيم بالقديس، وطلبت منه الصلاة لأجل تخفيف الآلام عنها. وعندما سأله القديس مقاريوس عن حالتهم في الجحيم، أجاب بأن وجه كل واحد في ظهر الآخر، ولا يستطيع أحد أن يرى وجه الآخرين، وترجاه في النهاية أن يُصلي من أجلهم لكي يروا حتى ولو قليلاً وجه الآخر[4] .
وهذه الحقيقة قد أكد عليها الرسول بولس في رسالته إلى أهل تسالونيكي بقوله: ” فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم ” (1تس17:2)، مما يبرهن على قيمة وأهمية حياة الشركة في المسيرة الروحية للمؤمنين. وهذه الصور تُعبّر عن المحتوى اللاهوتي العميق للتعليم الأرثوذكسي، الذي يرى في الشركة في المجد الإلهي تحقيق للحالة الفردوسية، وأن الخروج من هذه الشركة يؤدى إلى حياة الجحيم. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفهم معنى الشركة بين الأحياء والأموات، والصلوات من أجل الأنفس التي رقدت.
إن الحياة المسيحية تحمل في طبيعتها توجهًا أخرويًا، فهي تتطلع نحو حياة الدهر الآتي. وهي بهذه الرؤية المتفردة، تختلف عن كل الديانات الأخرى، فالديانة اليهودية أيضًا لديها توجه أخروي، ولكن التوجه المسيحي من جهة الحياة الأبدية، يختلف جذريًا عن هذا التوجه اليهودي. اليهود يؤمنون بالله الذي خلق الكون من العدم، ويعترفون بحضوره في العالم والتاريخ، وينتظرون تكميل العمل وتحقيق وعوده في المستقبل، في الأزمنة الأخروية.
هذا الإيمان وهذا الرجاء يرتبط بفكرة الخط المستقيم للزمن. أما الحياة المسيحية فتعتمد أساسًا على تأنس ابن الله، الذي تحقق بالفعل، تتميمًا لوعوده للإنسان. فأساس التوجه المسيحي إذًا نحو الحياة الأبدية، هو مجىء الله في الجسد، وأيضًا انتظار المجىء الثاني للمسيح، الذي يعني كمال عمل الله وتجديد الكون “ولكننا بحسب وعده ننتظر سماءً جديدة وأرضًا جديدة “.
إن المجىء الأول للمسيح والذي حدث زمنيًا في الماضي هو نفسه يُعلن عن المجيء الثاني الذي يُنتظر في المستقبل. إلاّ أن هذا المستقبل لا ينحصر في بُعده التاريخي، إذ أن المستقبل الخاص بالرجاء المسيحي يتجاوز الزمن والتاريخ، لأن ما يرتبط بالزمن، وما يوجد في التاريخ لا يتعدى كونه مجرد ظلال ورموز. فلا يجب أن نضع رجاؤنا في انتظار نهاية الزمن، لأننا من الآن نحن نحيا الحياة الجديدة في المسيح، وننتظر كمال عمل الله.
إذًا على عكس اليهودية التي تُركّز أهدافها واهتماماتها على الزمن والتاريخ، فإن الكنيسة ترى في الزمن والتاريخ وكل ما يرتبط بهما مجرد وعاء يحمل في داخله ملامح الحياة الأبدية التي ننتظرها. وفي نفس الوقت هي تفتح أبعادًا جديدة لا حدود لها، ورؤى متسعة لتقييم الزمن والتاريخ. وإذا كانت الكنيسة تنظر لتاريخ شعب إسرائيل كتاريخ مقدس، إلاّ أنها ترى فيه معنى رمزيًا.
فخروج اليهود من أرض مصر، وانتقالهم إلى أورشليم، يُفسر من قِبَل الكنيسة على أنه نموذج لخروج المؤمنين من العالم وانتقالهم لملكوت الله. يقول ق. إيريناؤس [خروج شعب الله من أرض مصر، هو نموذج وأيقونة لخروج الأمم ودخولهم في الكنيسة ][5].
إن الرؤية الأخروية للكنيسة يمكن أن توصف بأنها خروج. فالعالم يُنظر إليه كمكان إقامة مؤقت وزائل، وفي نفس الوقت هو عمل الله. لكن الله لم يجعل من هذا العالم المؤقت والزائل مكان إقامة دائم للبشر، إذ أن ملكوته الأبدي هو مكان الإقامة الدائم. هذه الحالة تصفها الرسالة إلى ديوجينيتوس بالقول [ إن المؤمنين يعرفون بأنهم غرباء ونزلاء في أوطانهم فإنهم يسكنون البلدان لكنهم غرباء عنها .. وكل بلد أجنبي هو وطن لهم، وكل وطن لهم يُعد بلد غريب ][6].
وهكذا فإن إهتمام المؤمنين لا ينحصر في مجال الأحداث التاريخية وتطوراتها، ولكنه يمتد إلى أبعد من ذلك ” لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة ” (عب14:13). وهذه المدينة العتيدة التي تتطابق مع ملكوت الله، ليست بعيدة عن المؤمنين، لكنها بالفعل داخل قلوبهم كعربون لما سيحدث.
لقد تحدث القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس بشأن هذا الموضوع قائلاً: ” هوذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند اليوم الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت ” (1كو51:15ـ53). هذا التوجه يدعم الرؤية الخاصة بأن هذا العالم هو إلى زوال، وفي ذات الوقت يجعلنا نتطلع نحو ملكوت الله.
إن ملكوت الله لا يوجد فقط بعد نهاية التاريخ، لكنه حاضر في كل لحظة في التاريخ. وعلى الرغم من أننا ننتظر هذا الملكوت بعد نهاية التاريخ إلاّ أنه يتحقق فعليًا في الحاضر ” ننظر الآن في مرآه في لغز” (1كو12:13). وهذا يوصف بوضوح تام في إنجيل يوحنا “الساعة الأخيرة” التي ينتظرها المؤمنين، هي حاضرة بالفعل، وتعمل في التاريخ ” تأتي ساعة وهى الآن ” (يو23:4، 25:5).
وهذا يعني أن ملكوت الله يتحقق في هذا العالم الحاضر ولكنه لا ينتسب إليه، ويصير هذا الملكوت هو المعيار الذي يتم على أساسه تقييم أمور هذا العالم. فعندما يثبت المؤمنون في إيمانهم حتى المجىء الثاني وعندما يبلغوا إلى رؤية ملكوت الله تتضح الحقيقة المؤكدة، وهى أن كل شئ مرتبط بهذه الحياة الحاضرة، باطل. إن الزمن والتاريخ لهما بعد نسبي، بيد أنهما يتسعان بغنى وبلا حدود ويصير الزمن وعاءً للأبدية، والتاريخ مجالاً لاستعلان ملكوت الله.
إن العالم بكل ما فيه وهكذا الزمن أيضًا يشكلان مسألة نسبية أمام ملكوت الله. ” لأن يومًا واحدًا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد ” (2بط8:3). الوقت كما يؤكد الرسول بولس “مُقصر” ” لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. والذين يبكون كأنهم لا يبكون والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون والذين يشترون كأنهم لا يملكون. والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه. لأن هيئة هذا العالم تزول” (1كو29:7ـ31).
إذًا فالمسيحيون هم مواطني الوطن السمائي، الذي أسّسه المسيح وصار أول مواطنيه[7]. التطلع نحو هذا الوطن السمائي، يخلقه فينا هذا الضمير الأخروي ” سيرتنا نحن هي في السموات ” (في20:3، أف19:2). وهذا الضمير يوّحد المؤمنين فيما بينهم، وفي نفس الوقت يجعلهم مختلفين عن أهل العالم.
إن الحياة الأخروية هي الغاية النهائية، التي تتجه إليها الخليقة والتي بها تكتمل كل الأمور السابقة. هي النهاية التي ينتظرها الجميع في المستقبل، وهى قائمة في الحاضر كهدف. ولهذا فإن الغاية المسيحية التي ننتظر تحقيقها، هي ملكوت الله الذي ننتظره في نهاية التاريخ. لكن ملكوت الله قد أتى بالفعل إلى العالم، بمجيء المسيح (لو20:11). فالنهاية صارت حاضرًا. وبرغم من أن المسيح ينتسب إلى الحياة الأبدية، إلاّ أنه موجود يعمل داخل التاريخ الإنساني.
ولهذا فإن الحياة الأخروية المسيحية يمكن أن توصف كحياة منتظرة، وكحياة متحققة ” أيها الأحباء نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أُظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو ” (1يو2:3). فالمسيح الذي استُعلن كإنسان صُلب ومات وقام وصعد إلى السموات، وهو غير الزمني، والأبدي والله الأزلي ” الكائن والذي كان والذي يأتي ” (رؤ4:1). استعلان مجد المؤمنين في ملكوت الله يتطلب إنضمامهم إلى جسد المسيح أي الكنيسة. والكنيسة قائمة بين تخوم الحاضر والحياة الأبدية.
وجود الإنسان داخل الكنيسة يكسبه ملمحًا إسخاتولوجيًا، وخروجه من العالم، ليس هو اختفاء في الفراغ، لكنه اشتراك في الحياة الأبدية، في المجد الإلهي. كما يعبر نيكولا كابيسيلاس عن هذه الحالة بقوله ” إن المؤمنين هم أعضاء جسد المسيح، ورأس هذا الجسد مُختفى في التاريخ، لكنه سيظهر في الأبدية، في حياة الدهر الآتي. وعندما يظهر مجد الرأس، حينئذ سيظهر بهاء الأعضاء”[8].
رجاء الإنسان في دخوله ملكوت الله يرتبط بشكل مباشر بحياة المؤمن اليومية، بينما طريقة معيشته لهذا الرجاء يعتمد على مرحلة النضوج الروحي. وهكذا فإن رجاء المؤمنين في ملكوت الله يتحقق بطريقتين داخل الكنيسة:
- بانتظار المجيء الثاني للمسيح والذي يعني نهاية العالم والتاريخ.
- من خلال اختبار حضور ملكوت الله في التاريخ، وهذا الاختبار ظهر بشكل محدد وواضح في حياة القديسين اليومية.
هذا الملكوت المرتجى يتجاوز المكان والزمان، واستعلان هذا الملكوت في الإنسان، هو عطية محبة من الله، والتي لا تخضع لتحديدات زمنية ومكانية[9]. وإن كان ملكوت الله يتحقق في هذا العالم، إلاّ أنه سيكتمل في الدهر الآتي. إن إحساس الإنسان ببطلان هذا العالم الحاضر، يُحرره من العبودية لهذا العالم، ويُحيله إلى حقيقة ملكوت الله. وهذا في حد ذاته يعطيه قوة لمواجهة الشر، وقدرة على الإحتمال في محاربة الشهوات، ومجال لإقتناء الفضائل. ويصف الرسول بولس الحياة الحاضرة “بالليل” والحياة الأبدية “بالنهار” (رو12:13).
فظلام وخطية هذا العالم يقودان إلى الفناء. بينما الحياة في نور المسيح يقود إلى ملكوت الله. ومن أجل هذا تزول الفوارق بين الزمن والأبدية، بين الحياة الحاضرة والحياة المستقبلية داخل الكنيسة. الحياة الحاضرة هى بداية الحياة المستقبلية، والحياة المستقبلية هى امتداد للحياة الحاضرة. والحياة في المسيح كما يقول نيكولا كابيسيلاس ” تتأسس هنا في هذه الحياة الحاضرة، لكنها تكتمل في الحياة المستقبلية، عندما نصل إلى ذلك اليوم “[10].
هذا يعني أن أي سلوك مُغاير لهذا المسلك الإيماني، سيقود بالضرورة إلى هجرة الجهاد الروحي، وهذا بدوره سيقود إلى الخضوع لأمور هذا العالم الحاضر، فيفقد الإنسان رؤيته الاسخاتولوجية، ويُسبى من عدو الخير والنتيجة الحتمية هى الخروج من الحالة الفردوسية، والدخول في مجال الجحيم. المصير الأخروي للإنسان، هو مصير الخليقة في مجملها، والتعاليم الآبائية اللاهوتية الخاصة بحركة التاريخ، وتطور الخليقة، تنظر إلى هذه الحركة وهذا التطور إنطلاقًا من سر تأنس الكلمة.
إذ أن الكلمة المتجسد يُشكّل السبب، والمركز، والهدف النهائي للخليقة في مُجملها. ولذلك فاليوم الأخير، والذي يُدعى “يوم الرب” هو يوم استعلانه التام والنهائي.
1 العلامة أوريجينوس، عظات على سفر العدد، ترجمة القس برسوم عوض و القس شنودة أمين والآنسة مارسيل عوض الله، مراجعة د. نصحي عبد الشهيد، إصدار المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، الجزء الثاني 2007م، ص197.
2 مت29:8، يع19:2.
[3] M. basile…ou, E…j thn Eza»meron PG. 29-120B.
[4] Makar…ou tou Aigupt…ou, Apofqšgmata PG 34, 257CD-260A.
[5] Eirhna…ou kata airšsewn 4, 30, ekd.A Rousseau “ Sources chretiennes “ tom. 100.785
[6] proj DiÒgnhton 5,5.
[7] Grhg. qeolÒgou, LÒgoj 33, 12 PG 36, 229A.
[8] per… thj en cristè zw»j 2, PG 150, 548 BC.
[9] Arcim. Swfron…ou, oyÒmeqa ton qeÒn kaqèj štsi, sel.208.
[10] per… t»j en cristè zw»j 1, PG 150, 493 p.