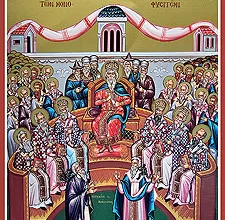في البدء كان البت.»
“هانز كريستيان فون باير” Hans Christian von Baeyer
«في البدء كان الكلمة.»
(يوحنا 1: 1)
المعلومات وحجة التصميم:
إذن وجود معلومات محددة معقدة يمثل تحدياً جباراً أمام الفكر القائل بأن العمليات الطبيعة غير الموجهة يمكن أن تفسر الحياة، ويضفي مقبولية علمية على الطرح القائل بمسؤولية مصدر ذكي عن نشأة الحياة. ومن المهم في هذا الصدد أن ندرك أن الاستدلال على وجود مصدر ذكي، بناءً على طبيعة الـ DNA، ليس مجرد حجة مبنية على مشابهة. فالكثير من حجج التصميم الكلاسيكية كانت من هذا النوع، حيث يسير التفكير المنطقي عكسياً مبتدئاً من آثار مشابهة للآثار المتضمنة في الموضوع المعنى ومنتهياً إلى مسببات تشبه مسببات هذا الموضوع. ومن ثم، غالباً ما اعتمدت صلاحية الحجج على درجة التشابه بين الموضوع المشبه والمشبه به. وقد اشتهر عن “دافيد هيوم” مناقشته لهذا الموقف في نقده لحجج التصميم، كما رأينا قبلاً. إلا أن الاستدلال على التصميم من الـ DNA أقوى بكثير من أسلافه الكلاسيكية للسبب التالي كما أوضح “ستيفن ماير”: «الـ DNA ينطوي على الحاجة لمصمم ذكي لا لأنه يشبه برنامج الكمبيوتر أو اللغة البشرية في بعض الجوانب، بل لأنه…. يتصف بسمة مميزة (ألا وهي محتوى المعلومات) تتصف بها النصوص البشرية ولغات الكمبيوتر المصممة تصميماً ذكياً.» ويؤيد هذا الرأي “هيوبرت يوكي” العالم المتخصص في نظرية المعلومات، قائلاً: «يجب أن نفهم أننا لا نبني تفكيرنا على المشابهات. ففرضية التسلسل sequence hypothesis (أن الشفرة الوراثية تعمل في الأساس مثل الكتاب) تنطبق مباشرة على البروتين والنص الوراثي، تماماً كما تنطبق على اللغة المكتوبة. ومن ثم، فالاثنان متماثلان من حيث التعامل الرياضي معهما.» ولذلك، نحن لا نبني حجتنا على المشابهات، ولكننا نفعل ما يسمى بالاستدلال القائم على أفضل التفسيرات. وكما يعلم أي مخبر سري، المسببات التي نعرف أنها قادرة على إنتاج أثر قابل للملاحظة تمثل تفسيراً أفضل لذلك الأثر من المسببات التي لا نعرف أنها قادة على إنتاج مثل هذا الأثر، فما بالك بالمسببات التي نعرف عنها أنها غير قادرة على ذلك؟
لقد كرس “دمبسكي” كتابه “الاستدلال على التصميم” لتوضيح صميم طبيعة الاستدلالات على التصميم التي نتوصل إليها بناء على خبرتنا بالنظم الغنية بالمعلومات مثل اللغات، والشفرات، وأجهزة الكمبيوتر، والماكينات، ونحوها. هذا النوع من الاستدلالات على التصميم منتشر بنسبة كبيرة في العلم. فبضع علامات صغيرة على قطعة من الحجر كافية أن تُعرف عالم الآثار بأنه يتعامل مع منتج بشري، لا مع مجرد قطعة حجر بالية. والاستدلال على وجود فعل ذكي يمثل نشاطاً معتاداً في بعض العلوم مثل علم الآثار، وعلم التشفير، وعلوم الكمبيوتر، الطب الشرعي.
البحث عن ذكاء من خارج الأرض وتداعياته:
حتى العلم الطبيعي كشف في السنوات الأخيرة عن استعداده للاستدلال على التصميم، وهو ما ظهر بوجه خاص في معهد “البحث عن ذكاء من خارج الأرض” Search for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI). وقد أنفقت “وكالة الفضاء الأمريكية ناسا” North American Space Administration (NASA) ملايين الدولارات لوضع تلسكوبات راديو تراقب ملايين القنوات على أمل رصد رسالة من كائنات ذكية في مكان آخر في الكون.
ورغم أنه بعض العلماء قد ينظرون إلى معهد SETI بشيء من الريبة، فهو يطرح سؤالاً جوهرياً يختص بمدى علمية رصد الذكاء. فكيف يمكن التعرف علمياً على رسالة منبعثة من مصدر ذكي، وتمييزها عن الضوضاء العشوائية المنبعثة من الكون التي تشوش عليها؟ واضح أن السبيل الوحيد لذلك هو مقارنة الإشارات الواردة بأنماط محددة سلفاً تمثل مؤشرات للذكاء واضحة وموثوقة، ولتكن مثلاً سلسلة طويلة من الأعداد الأولية، ثم الاستدلال على التصميم. ومعهد SETI يعتبر أن التعرف على الفعل الذكي يقع داخل الإطار المشروع للعلم الطبيعي. فقد رأى عالم الفلك “كارل ساجان” أن رسالة واحدة من الفضاء تكفي لإقناعنا أن الكون يحوي ذكاءات أخرى بخلاف ذكائنا.
إلا أنه يجب التنويه إلى ملحوظة أخرى جوهرية. ألا وهي أننا إذا كنا مستعدين للبحث عن دلائل علمية على وجود نشاط خارج كوكبنا، فما السر وراء ترددنا الشديد في تطبيق هذا التفكير نفسه على ما هو موجود على كوكبنا؟ هذا الموقف المتضارب للغاية يأتي بنا إلى لب السؤال الذي أشرنا إليه في المقدمة: هل القول بتصميم ذكي للكون يعتبر علماً؟ إننا نؤكد أن العلماء يسعدون بإدماج الطب الجنائي ومعهد SETI في دينا العلم. فلماذا إذن تندلع ثورة عارمة عندما يزعم بعض العلماء وجود دلائل علمية على مسبب ذكي في الفيزياء (ثورة بسيطة) أو علم الأحياء (ثورة عنيفة)؟ مؤكد أنه لا فرق من حيث المبدأ. ألا ينطبق المنهج العلمي على كل شيء؟
وعندما نعبر عن القضية على هذا النحو، ألا يتضح أمامنا أن السؤال التالي الذي يجب أن نطرحه هو: ما الذي يجب أن نستنتجه إذن من كمية المعلومات المهولة المتضمنة حتى في أبسط النظم الحية؟ ألا تزودنا مثلاً بدلائل على أصل ذكي أقوى بكثير من الدلائل التي تزودنا بها الحجة التي تقوم على الضبط الدقيق للكون، وهي، كما رأينا، حجة تقنع الكثير من الفيزيائيين أن وجدنا نحن البشر على هذا الكوكب أمر مقصود؟ ألا يمكن أن يمثل ذلك البديل الحقيقي على ذكاء من خارج الأرض؟
عندما أُعلن اكتمال مشروع الجينوم البشري على الجمهور، قال مديره “فرانسيس كولينز”: «إن إدراكي أننا عاينا أول لمحة من كتاب التعليمات الذي صنعنا على أساسه يملؤني تواضعاً وإجلالاً، وهو الكتاب الذي لم يكن معروفاً إلا لله وحده.» أما “جين مايرز” Gene Myers عالم الكمبيوتر الذي كان دوره رسم خريطة الجينوم في مقر “سلرا جينومكس” Celera Genomics بولاية ماريلاند، فقد قال: «إننا كائنات معقدة ومركبة على المستوى الجزيئي تركيباً مبهجاً… ولكننا حتى الآن لا نفهم أنفسنا، وهو شيء مبهر، فما زال هناك عنصر ميتافيزيقي، سحري… وما يذهلني حقاً هو بنية برنامج الحياة…. فهو نظام في غاية التعقيد. يبدو أنه مصمم…. فهو ينطوي على قدر ضخم من الذكاء. ولا أرى أن هذا الفكر غير علمي. قد يعتقد البعض ذلك، ولكني لست منهم.»
لقد لعبت هذه التصريحات دوراً محورياً في تغيير فكر عدد من أبرز المفكرين. فالعالم المتخصص في علم الكون الرصدي observational cosmologist “آلن سانديج” الذي سبقت الإشارة إليه، قال في حديثه عن تحوله إلى المسيحية في سن الخمسين: «إن العالم شديد التعقيد في كل أجزائه وتشابكاته حتى إنه يستحيل أن يكون وليد الصدفة وحدها. إني مقتنع أن وجود الحياة بكل ما فيها من تنظيم في كل كائن من كائناتها الحية مركب معاً بمنتهى الروعة.» والفيلسوف “أنتوني فلو” منذ وقت قريب جداً أرجع تحوله إلى الإيمان بالله الخالق بعد أكثر من 50 عاماً من الإلحاج إلى أن دراسة علماء الأحياء للـ DNA «أظهرت أنه لا بد أن ذكاء ما تدخل في العملية نظراً لتعقيد الترتيبات اللازمة لإنتاج الحياة تعقيداً يفوق الخيال.»
المعلومات بوصفها كماً جوهرياً:
إن المعلومات والذكاء جوهريات لوجود الكون والحياة، وهما أبعد ما يكونان عن منتجات نهائية لعملية طبيعية غير موجهة تبدأ بالطاقة والمادة، ولكنهما فاعلان منذ البداية. وهذه الفكرة تحظى حالياً بالقبول حتى بين الفيزيائيين. وقد طرح “بول دافيز” اقتراحاً يتماشى مع هذه الفكرة في مقالة رئيس التحري في مجلة “نيو ساينتست” New Scientist حيث كتب: «إن تزايد تطبيق مفهوم المعلومات على الطبيعة يثير استنتاجاً مبدئياً عجيباً. فنحن عادة ما نتصور أن العالم مركب من جسيمات مادية بسيطة تشبه كتب الطين، ومن معلومات باعتبارها ظاهرة مشتقة، ملحقة بحالات خاصة من المادة تتسم بالتنظيم. ولكن ربما يكون الأمر بالعكس: ربما يكون الكون فعلاً لعبة من المعلومات الأولية، والأشياء المادية هي إحدى تجلياتها الثانوية المعقدة.» ويقول “دافيز” إن أول من طرح تلك الفكرة كان الفيزيائي المعروف “جون أرتشيبولد ويلر” John Archibald Wheeler سنة 1989 حين قال: «غداً سنتعلم أن نفهم كل الفيزياء بلغة المعلومات.»
وفي مجلة “نيو ساينتست” أيضاً نقراً مقالة تحت عنوان جذاب: «في البدء كان البت» حيث يقدم “هانز كريستيان فون باير” Hans Christian von Baeyer تقريراً عما قام به الفيزيائي “أنطون زيلينجر” Anton Zeilinger من “جامعة فيينا” University of Vienna الذي يطرح فرضية تقول بأنه إن أردنا فهم ميكانيكا الكم، علينا أن نبدأ بربط المعلومات (وفقاً لمقياس البت) بما يسمى بالأنظمة الابتدائية في ميكانيكا الكم التب “تحمل بت واحداً من المعلومات، مثل حركة الإلكترون المغزلية (يوجد فقط ناتجان يحتمل الحصول عليهما من قياس الحركة المغزلية، إما “لأعلى” أو “لأسفل”). ويرى “زيلينجر” أن مبدأه الأساسي يكتسب مصداقية من أنه يقود مباشرة إلى ثلاث دعائم في نظرية الكم: التعبير الكمي quantization نفسه، وعدم اليقين uncertainty، والتشابك الكمي quantum entanglement. والمقترح القائل بأنه يجب النظر إلى المعلومات باعتبارها كماً جوهرياً يتضمن تداعيات عميقة تتعلق بفهمنا للكون. فهو يزيد ثقل الاستدلال على التصميم.
إلا أن الفكرة ليست جديدة. ولكنها موجودة منذ قرون. فقد كتب الرسول يوحنا كاتب الإنجيل الرابع «في البدء كان الكلمة…. كل شيء به كان.» ولفظ “الكلمة” في اليونانية هو “لوجوس” Logos، هو مصطلح استخدمه الفلاسفة الرواقيون للإشارة إلى القانون العقلاني الذي يكمن وراء الكون، ثم أضفى عليه المسيحيون معنى إضافياً، إذ استخدموه للإشارة إلى أحد أقانيم الثالوث. فمصطلح “الكلمة” نفسه يحمل لنا دلالات الكلمة الآمرة، والمعنى، والشفرة، والتواصل، وبالتالي المعلومات، تماماً كما يحمل لنا معنى القدرة الخلاقة اللازمة لتحقيق ما حددته تلك المعلومات. الكلمة إذن أكثر جوهرية من المادة والطاقة. لأن المادة والطاقة تنتميان إلى فئة المخلوق. وهو ما لا ينطبق على الكلمة.
ومن المدهش حقاً أنه في صميم تحليل أعمال الخلق، طبقاً للكتاب المقدس، وهو ما يتجاهله الكثيرون بنوع من الغطرسة الشديدة، نجد المفهوم نفسه الذي أثبت العلم أيضاً في الآونة الأخيرة مدى أهميته القصوى، ألا وهو مفهوم المعلومات.
وهذه الفكرة المحورية من أن الخالق هو الله الكلمة ينعكس في عبارة «وقال الله [ليكن نور…]» التي تتكرر مراراً في رواية الخلق العبرية، ويؤكدها الكتاب المقدس في كل أقواله تقريباً عن الخلق. والقول الذي يعنينا بوجه خاص في دراستنا هو «بالأيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر.» وهذا الاقتباس من النص الكتابي القديم مبهر حقاً من حيث إنه يلفت انتباهنا إلى سمة أساسية للمعلومات، ألا وهي أن المعلومات غير مرئية. إلا أن حاملات المعلومات يمكن أن تكون مرئية، مثل الحبر والورق، أو إشارات الدخان، أو شاشات التلفاز، أو الـ DNA، ولكن المعلومات نفسها ليس مرئية.
والمعلومات لا تتصف بأنها غير مرئية فحسب، ولكنها أيضاً غير مادية، أليس كذلك؟ فأنت تقرأ هذا الكتاب، والفوتونات تطفر من الصفحات وتستقبلها عيناك، وتتحول إلى إشارات كهربية وتنتقل إلى مخك. والآن هب أنك تنقل بعض المعلومات من هذا الكتاب لأحد أصدقائك نقلاً شفهياً. فموجات الصوت تحمل المعلومات من فمك إلى أذن صديقك، حيث تتحول إلى إشارات كهربية وتنتقل إلى مخه. والآن أصبح صديقك يمتلك المعلومات التي نشأت في عقلك. ولكن ما ينتقل منك إلى صديقك أي شيء مادي. حاملات المعلومات مادية، لكن المعلومات نفسها ليست مادية.
سنة 1961 كتب “رولف لاندور” Rolf Landauer بحثاً شهيراً بعنوان “المعلومات فيزيائية الطابع” Information is Physical. ويبدو العنوان للوهلة الأولى وكأنه يعنى عكس ما بيناه تواً. إلا أنه يقصد أنه بما أن المعلومات عادة ما تشفر استناداً إلى شيء فيزيائي. إذن حاملات المعلومات تخضع لقوانين الفيزياء. وبهذا المعنى، المعلومات نفسها تخضع لقوانين الفيزياء عبر حاملاتها. وبالتالي يمكن التعامل معها وكأنها فيزيائية. إلا أن هذا لا يغير حقيقة أن المعلومات نفسها ليس كياناً فيزيائياً.
فماذا عن حلم التفسيرات المادية لكل شيء؟ كيف يمكن للمسببات المادية المحضة أن تقدم تفسيراً شافياً لما هو غير مادي؟
تعقيد الله: اعتراض قاتل!
يعتقد “ريتشارد دوكينز” أن اعتبارات التعقيد تسهم فعلياً في فوزه بقضيته ضد الله: «أي إله قادر على تصميم كون…. لا بد أن يكون كياناً معقداً على نحو فائق ولا بد أن يكون غير محتمل الحدوث من حيث إنه يتطلب تفسيراً أكبر من التفسير الذي يفترض فيه أن يقدمه.» أي أنه يقول إن هذا ليس بتفسير حيث أن الله بطبيعة الحال أعقد (مما يجعله أقل احتمالاً) من الشيء المراد تفسيره. وفي تعبيره عن الفكرة يزعم قائلاً: «إن تفسير أصل آلة الـ DNA أو البروتين باستجلاب مصمم فائق للطبيعة لا يفسر أي شيء، لأنه يترك أصل المصمم بلا تفسير. فلا يكون بوسعك إلا أن تقول شيئاً من قبيل «الله موجود منذ الأزل» وإن سمحت لنفسك بالكسل والهروب من هذا المخرج السهل، يمكنك بالمثل أن تقول: «الـ DNA موجود منذ الأزل»، أو «الحياة موجودة منذ الأزل»، وهكذا تنهي المسألة.»
إن هذا التفكير يفتقر للمنطق بشدة؛ أولاً، نحن نعلم أن الـ DNA لم يكن موجوداً منذ الأزل، والحياة لم توجد منذ الأزل، وبالمناسبة، الكون أيضاً لم يوجد منذ الأزل. وهو ما يمثل أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع العلماء للسعي وراء تفسيرات لوجودها. إلا أن القضية الحقيقية هنا تكمن في أنه يبدو أن “دوكينز” يعتقد أن التفسير الوحيد الذي يستحق أن يوصف بأنه “علمي” هو تفسير ينطلق من البسيط إلى المعقد. فرغبته الواضحة وضوح الشمس هي تفسير كل شيء وفقاً لما «يفهمه الفيزيائيون من أشياء بسيطة».
فلنفكر في الفيزيائيين إذن في محاولتهم تفسير سقوط تفاحة، وهو بالطبع حدث “بسيط” بمعنى أن الشخص العادي غير المتخصص يسهل عليه فهمه. إلا أن تفسيره طبقاً لقانون نيوتن في الجاذبية هو أصلاً شديد التعقيد بالنسبة للغالبية، والتفسير النسبي طبقاً لخط الزمكان المنحني curved space-time لا يفهمه إلا المتخصصون. فإن رفضنا هذه التفسيرات بدعوى أنها أعقد من الشيء الذي تفسره، سنرفض قدراً كبيراً من العلم.
والذرات أيضاً أبسط من الكائنات الحية لأن الكائنات الحية عبارة عن بنى معقدة مكونة من ذرات. ومع ذلك، الذرات أبعد ما تكون عن البساطة، وهو ما يفسر جزئياً سر اهتمام أقوى العقول الجبارة على الأرض بفيزياء الجسيمات الأولية. فكلما تعمقت في صميم طبيعة بنية الكون، وجدته يزداد تعقيداً. أي أن ما “يفهمه الفيزيائيون من أشياء بسيطة” ليس بسيطاً مهما كان.
خذ مثلاً النسبية، أو ميكانيكا الكم، والأفضل من هذه وتلك الكهروديناميكا الكمية. كلها أبعد ما تكون عن البساطة لدرجة أنه لا يفهمها سوى أذكى العقول البشرية، ورغم ذلك ما زالت هناك الكثير من الأسرار التي لم تكشف بعد. أولها أنه ما من أحد يعلم على وجه التحديد السبب وراء عمل ميكانيكا الكم، كما اعتاد “ريتشارد فاينمن” أن يشير إلى أنه ما من أحد يعرف حتى ماهية الطاقة. والآن إن كان “ريتشارد دوكينز” يعترض على تعقيد الله باعتباره تفسيراً نهائياً، عليه أن يعترض كذلك على تعقيد بنية الكون المكونة من فيزياء الجسيمات وعليه ألا يقنع إطلاقاً بالتفسيرات النهائية التي تعتمد على مفاهيم مثل “الطاقة”، لأننا لا نفهمها فهماً كاملاً.
إن “دوكينز” باختصار مخطئ في نظرته الضيقة لفكرة التفسير. فأولاً، الأشياء التي يعتبرها بسيطة ليست بسيطة. ثانياً، لا يرجع قبول هذه النظريات الفيزيائية المعقدة بين العلماء إلى بساطتها، بل إلى قدرتها التفسيرية. والقدرة التفسيرية تتساوى في أهميتها مع البساطة، إن لم تكن تفوقها أهمية، بصفتها معياراً للتحقق من صلاحية النظرية العلمية. وأحياناً ما رفضت النظريات البسيطة لأنها لم تتمتع بقدر كاف من القدرة التفسيرية. وعلى أي حال، فإن أينشتاين هو من قال: «التفسيرات يجب أن تكون بسيطة قدر الإمكان، ولكنها يجب ألا تزداد بساطة عن ذلك.» والقدرة التفسيرية غالباً ما تعلو على البساطة، وهو ما يعجز “دوكينز” عن إدراكه على ما يبدو.
وهي قضية في منتهى الأهمية تستحق منا مزيداً من الدراسة. فافتراض وجود كائن أعقد مما تريد تفسيره، هو شيء يفعله العلماء باستمرار. لقد قرأت كتاباً من 400 صفحة بعنوان “وهم الإله”، فإن افترضت أن التفسير هو كائن يدعى “ريتشارد دوكينز” وهو أعقد بما لا يقاس من الكتاب نفسه، لا يعتبر افتراضي تفسيراً؟
والحقيقة أننا لا نحتاج حتى إلى 400 صفحة لتقنعنا بتفسيرات مقبولة أعقد من الأشياء المراد تفسيرها. تخيل مثلاً عالم آثار يشير إلى خدشين على جدار كهف لم تبدأ فيه عمليات استكشافية بعد، فيقول متعجباً: «ذكاء بشري!» وبناء على منطق “دوكينز” نجيب: «لا تكن أحمق. هذه الخدوش بسيطة جداً. وعموماً هما خدشان فقط. فافتراض وجود شيء معقد كالمخ البشري لا يعد تفسيراً لهذه العلامات البسيطة على جدار كهف.» فماذا نقول إن أجاب العالم بهدوء قائلاً إن الخدشين “البسيطين” يشكلان الكلمة الصينية (ren) التي تعني إنساناً، أي أنهما يتضمنان بعداً دلالياً، إنهما يحملان معنى؟
فهي سنستمر في إصرارنا على أن تفسير الخدوش باعتبارها نشاطاً إنسانياً «لا يفسر أي شيء»؟ بالطبع لا. بل سنعترف أن استدلال العالم على نشاط ذكي استدلال مشروع. علاوة على ذلك، مؤكد أننا سندرك أن تفسير الخدوش بشيء أعقد من الخدوش نفسها لا يقض على العلم. ولكن تلك الخدوش يمكن أن تزودنا بمفاتيح مهمة للتوصل إلى هوية من صنعوها وثقافتهم وذكائهم، حتى وإن لم تخبرنا بكل شيء عنهم.
وبالمناسبة، أليس غريباً أن عالم الآثار هذا يستدل فوراً على أصل ذكي عندما يكتشف خدشين، في حين أن بعض العلماء عندما يواجهون تسلسل الجينوم البشرين البالغ طوله 3,5 مليار حرف، يخبروننا أن تفسيره الوحيد هو الصدفة والضرورة؟ إن كلاً من الخدوش وتسلسل الـ DNA ينطوي على بعد دلالي. ولذلك ليس عبثاً أن نطلق على الأخير شفرة الـ DNA.
ونحن دائماً ما نستدل على مصادر معقدة للذكاء عندما نجد تراكيب أو أنماطاً معينة بسمات يتفرد بها النشاط الذكي حتى وإن كانت “بسيطة” في حد ذاتها. وقد يعترض أحدهم قائلاً إننا نتوصل لهذه الاستدلالات نظراً لمعرفتنا بالبشر وبميلهم الطبيعي لتصميم أشياء. ولكن هل هذا سبب قوي لإرجاع شيء يتسم ببنية تتوافق مع النشاط الذكي لمصدر غير ذكي، ولا سيما إن لم يكن لذلك دلائل تؤيده؟
تذكر ما نتوصل إليه من استنتاج مؤكد عند زيارة كوكب ناء لو وجدنا سلسلة من أكوام مكعبات التيتانيوم المنتظمة التي يتكون كل منها من عدد أولي من المكعبات والسلسلة مرتبة ترتيباً تصاعدياً 2، 3، 5، 7، 11…. الخ. سندرك فوراً أننا أمام عمل أنتجه فاعل ذكي، حتى وإن لم تكن لدينا أي فكرة عن نوعية هذا الفاعل الذكي. ورغم أن أكوام المكعبات في حد ذاتها “أبسط” كثيراً من الذكاء الذي أنتجها، فهذه الحقيقة لا تمنعنا من استنتاج أصل ذكي باعتباره استدلالاً منطقياً يقوم على أفضل التفسيرات. فنحن بالفطرة نميل أن نستدل “من أسف لأعلى” حتى نصل إلى مسبب ذكي نهائي. أكثر من ميلنا للاستدلال “من أعلى لأسف” حتى نصل إلى الصدفة والضرورة.
وكما رأينا يكتسب مشروع SETI مشروعيته من هذه الحجة على وجه التحديد. فلو تلقينا (كما يصور “كارل ساجان” في روايته “اتصال” Contact) إشارة تتكون من سلسلة أعداد أولية، سنفترض أنها مرسلة من مصدر ذلك. بل إن هذا الحدث لو وقع فعلياً سينتشر في الصحف العالمية ليلة حدوثه، ولن يحلم عالم واحد بالاعتراض بدعوى أن افتراض أصل ذكي للسلسلة ليس تفسيراً لأنه يعنى تفسير السلسلة بشيء أعقد من السلسلة نفسها. والمؤكد أن الحدث سيثير مزيداً من الأسئلة، عن طبيعة الذكاء مثلاً، ولكننا على الأقل سنكون قد تأكدنا من وجود ذكاء خارج الأرض. وكما أشرنا، حتى “دوكينز” يظهر (في فيلم “المطرود” Expelled) أنه غيّر موقفه وأصبح يميل للاعتقاد بأن التصميم شيء يمكن الاعتراف به علمياً من حيث المبدأ.
وعلينا أن نلاحظ أيضاً في هذا الصدد أنه يبدو أن “دوكينز” مبهور بفرضية الأكوان المتعددة ولكنه يدرك وجود مشكلة: «إن الاعتقاد بأن افتراض وجود أكوان عديدة هو نوع من الرفاهية والبذخ اللذين لا يجب السماح بهما، هو اعتقاد مغر (وقد استسلم الكثيرون لإغرائه). فإن كنا سنسمح بما ينطوي عليه تعدد الأكوان من تبذير، وما دامت كل أنواع التبذير ستتساوى، ما المانع إذن أن نسمح بالله أيضاً؟» والحل الذي يقترحه لهذا السؤال أن الإسراف صفة أصيلة في فرضية الله، في حين أن فرضية الأكوان المتعددة تبدو ظاهرياً مسرفة ولكنها في حقيقتها ليس كذلك. إلا أن منطقه بناء على الاحتمالية الإحصائية غير مقنع.
فإن كان هناك عدد ضخم من الأكوان، سيعتقد المرء أن معظمها شديد التعقيد، وإن كنا في النهاية نتاج هذه الأكوان المتعددة، عندئذ، الحجة التي يزعمها “دوكينز” بأن الأشياء دائماً ما تسير من البسيط إلى المعقد تذهب أدراج الرياح.
والنقطة التي لا بد أن نشير إليها هنا أننا لا نحاول تقديم تفسير للتعقيد النهائي، أياً كان معناه، ولا حتى للتعقيد بوجه عام. ولكننا نحاول أن نفسر مثالاً واحداً بعينة على التعقيد المنظم (الحياة). ومن ثم، فالحكمة الحقة تستلزم أن نعبر عن ذلك بشيء أعقد، إن كان ذلك هو ما تقتضيه الدلائل. والدلائل كما رأينا، هي:
1 – الحياة تشتمل على قاعدة بيانات DNA معقدة من المعلومات الرقمية.
2 – الذكاء هو المصدر الوحيد الذي نعرفه لهذا التعقيد الذي يشبه اللغة.
3 – علم الحاسبات النظري يبين أن الصدفة غير الموجهة والضرورة لا تستطيعان إنتاج تعقيد دلالي (يشبه اللغة).
لذلك، بناء على الاستدلال العلمي وفقاً لأفضل التفسيرات، يعتقد المرء أن العلماء يفضلون تفسيراً يشرح ظاهرة ما على تفسير لا يفعل ذلك. وإن كان هذا المبدأ لا ينطبق على تفكيرنا في أصل الحياة، فهذا يبين وجود نزعة مادية مفترضة بديهياً افتراضاً مسبقاً من شأنها أن تنتج توجهاُ شديد المعاداة للعلم، يتمثل في الإعراض عن اتباع الدلائل حيثما تقود لمجرد أن المرء لا يحب ما سيؤول إليه ذلك من تداعيات.
وفي ضوء الأهمية التي يعلقها “دوكينز” على “تعقيد حجة الله”، اندهشت (كما اندهش آخرون) من اعترافه العلني في مناظرة معي في “متحف أكسفورد للتاريخ الطبيعي” Oxford Natural History Museum في تشرين الأول/أكتوبر 2008 بأنه يمكن بناء قضية تؤيد وجود إله ربوبي. ورغم أنه أشار أنه لا يقبل هذه القضية، فقد كان مجرد ذكره لها أمراً يدعو للدهشة، لأنه ما من شيء يقضي على حجته نهائياً بقدر وجود إله ربوبي. وذلك لأن الإله الربوبي كائن معقد باعتباره تفسيراً نهائياً لكون أبسط.
وهكذا يتضح أن حجة “تعقيد الله” أضعف بكثير من بيت مبني بورق اللعب. والاستمرار في ترديدها لا يفيد من يستخدمونها إلا في زيادة الشكوك أن إمبراطور الإلحاد لا يملك ثياباً. فهذه الحجة ليس لها أي تأثير في زحزحة ما نراه من حكمة وعقل في التصريح القاطع الذي يبدأ به سفر التكوين: «في البدء خلق الله السموات والأرض»، بل إنها تنجح نجاحاً مبهراً في تأكيده.
من صنع الله؟
هناك اعتراض آخر على وجود الله يرتبط بالاعتراض السابق. وقد حظي بكثير من الاهتمام لأن “ريتشارد دوكينز” اتخذ منه قضية محورية في كتابه الأكثر مبيعاً “وهم الإله”. وهو عبارة عن السؤال الطفولي القديم: إن قلنا أن الله خلق الكون، فلا بد أن نسأل عمن خلق الله، وهلم جرّ، وهكذا يرى “دوكينز” أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الحركة الارتدادية اللانهائية أن ننكر وجود الله.
هل هذا أفضل ما يمكن أن يحرزه “الأذكياء” Bright’s؟ إني أسمع صديقاً أيرلندياً يقول: «إن هذا يثبت شيئاً واحداً أنهم لو كانوا يملكون حجة أفضل، لاستخدموها.» وإن كان هذا رد فعل قوياً، فما بالك بسؤال: من صنع الله؟ إن مجرد السؤال يبين أن السائل يتصور إلهاً مخلوقاً. ومن ثم، ليس غريباً أن من يطرح السؤال يؤلف كتاباً بعنوان “وهم الإله”. لأن هذه هي تحديداً ماهية الإله المخلوق، وهم بطبيعة الحال، كما بين زينوفانيس قبل “دوكينز” بقرون. ومن ثم، كان يمكن استخدام عنوان أدق مثل: “وهم الإله المخلوق”. وكان يمكن عندئذ اختصار الكتاب إلى نشرة صغيرة، ولكن المبيعات كانت ستتأثر.
والآن “دوكنيز” يخبرنا صراحة أنه لا يحب أن يخبره الناس بأنهم بدورهم لا يؤمنون بالله الذي لا يؤمن هو به. ولكننا لا نستطيع أن نؤسس حججنا على ما لا يجب. لأنه سواء أحب أم لم يحب، فهو الذي يستجلب هذه التهمة علناً. فمهما يكن من أمر، هو الذي يقول إن الله وهم. وحتى نقيّم حجته علينا أولاً أن نعرف مفهوم الله عنده، مع ملاحظة أن حجته الرئيسية منصبة على إله مخلوق. والحقيقة أن بضعة مليارات منا يشاركونه عدم إيمانه بهذا الإله. فما كان عليه أن يقلق بهذا الشأن. فمعظمنا مقتنع منذ زمن بعيد بما يحاول أن يخبرنا به. فمن المؤكد أنه ما من مسيحي يعتقد أن الله مخلوق، ولا حتى في أحلامه. وهو ما ينطبق طبعاً على اليهود والمسلمين. فحجته، باعترافه هو شخصياً لا تقول أي شيء عن الإله الأزلي، ولا تمت لهذه الفكرة بصلة. لذلك، ينبغي على “دوكينز” أن يضعها على الرف المكتوب عليه “الأباريق السماوية”[1] Celestial Teapots حيث مكانها الصحيح.
وذلك لأن الله الذي خلق الكون ويحفظه لم يُخلق، فهو أزلي. لم “يُصنع”، وبالتالي لا يخضع لما اكتشفه العلم من قوانين، لأنه هو من صنع الكون بقوانينه. وهذه الحقيقة تشكل الفارق الأساسي بين الله والكون. فالكون لم يكن موجوداً، ثم أتى للوجود، أما الله فليس كذلك. قد كان الإغريق واعين بهذا الفرق، ويوحنا الرسول المسيحي يشير إليه في افتتاحية إنجيله: «في البدء كان الكلمة كائناً (أي أن “الكلمة كان كائناً من الأصل”)، وكان الكلمة مع الله… به خلق كل شيء (أي أن “كل شيء أتى للوجود”)»[2] (يوحنا 1: 1، 3) فالله ينتمي لفئة غير المخلوق. وهو ما لا ينطبق على الكون الذي لم يكن موجوداً ثم وجد، أي أنه خُلق به.
وقد رأينا في الفصل الثالث أن ما نقصده بمصطلح “الخلق” يمثل قضية جوهرية ما زالت النظم الفلسفية والدينية في العالم منقسمة عليها.
وقد علم اليونانيون بأن:
1 – المادة كانت موجودة دائماً وستظل موجودة. أي أنها أزلية أبدية. وقد كانت في حالتها البدائية بلا شكل، وبلا نظام وبلا حدود، أي فوضى[3] chaos. ولكن بعد ذلك برز إله من الآلهة وفرض نظاماً على هذه المادة الموجودة سلفاً، محولاً إياها إلى عالم جيد التنظيم، أي كون[4] cosmos. وهذه العملية تعبر عما قصده الإغريق بالخلق.
2 – الخالق جزء من نظام أزلي حيث كل شيء في الكون ينبثق من الله، كما تنبثق أشعة الشمس من الشمس. ومن ثم، يكون كل شيء هو الله. فالله في مادة الكون على نحو ما، وهو فاعل بنشاط في تحريك المادة وتطويرها حتى تصل إلى أفضل وضع.
إلا أن التقليد العبري القديم الذي ورثته المسيحية والإسلام مختلف كلية مع ملاحظة أنه أسبق من الفلاسفة الأيونيين بمئات السنين. وقد علم بأن:
1 – المادة ليست أزلية: الكون له بداية، وليس هناك إلا إله أزلي واحد هو خالق الكل.
2 – الله كائن قبل الكون، ومستقل عنه. والكون ليس انبثاقاً من الله. فالله خلقه من عدم، ولم يخلقه من ذاته، وإن كان يحفظه ويوجهه إلى غايته التي حددها له.
إذن “دوكينز” متأخر جداً من حيث إنه لم يزل مع الإغريق ومع فكرتهم عن الآلهة التي «انحدرت من السماء والأرض»، ومن ثم فهي مخلوقة. وربما يحسن صنعاً لو أنضم للجمهور الذي استمع للرسول بولس المسيح في مدرسة أريوس باغوس الفلسفية في أثنيا إبان القرن الأول. ويسجل المؤرخ لوقا أن بولس لاحظ أثناء تجواله في المدين مدى قصور نظرة مواطنيها لله، فقد كان المكان ممتلئاً بالأصنام، حتى إن أحدها كتب عليه “لإله مجهول”. وبولس لم يكن شخصاً متشدداً معادياً للفكر ومتمسكاً بالأوهام مثل الصورة النمطية الشائعة في الإلحاد، ولكنه في الواقع درس الفلسفة اليونانية دراسة متعمقة ولم يكن اندهاشه من سذاجة الأثنينيين أقل من اندهاش “دوكينز” لو كان في ذلك الموقف. وقد أوضح لهم أن أحد شعرائهم أدرك أن البشر، من جانب ما، ذرية الله. وطرح عليهم هذا الاستدلال المنطقي حتى يفكروا فيه: «فإذ نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان.» فالآلهة الناتجة من اختراع الخيال البشري الخصب، الآلهة المخلوقة، ليست أمراً جديداً.
هل من شيء أزلي؟
إن سؤال “دوكينز” عن صنع “الصانع” يبين أنه ربما يعاني صعوبة فكرية في أن يتخيل وجود غير المخلوق والأزلي. ولكن إن كان الأمر كذلك، فهو متهم بوجه آخر من وجوه عدم الاتساق الخطيرة. فمن المفترض طبقاً لمنظوره الفلسفي أن يؤمن (مثل الإغريق أيضاً) بأزلية المادة والطاقة (وقوانين الطبيعة). فإن كان الأمر كذلك، إذن هو يؤمن بشيء أزلي، بل الكثير منه، ألا هو مادة الكون كله المحيط بنا.
وكم تحيرت في زياراتي الكثيرة للدول الشيوعية السابقة من كثرة ما سألني أساتذة الجامعات الشيوعيون القدامى هذا السؤال: «من صنع الله؟» وكم كان مثيراً أن أرى المأزق الذي يتورطون فيه عندما اكشف لهم عن اعتقادهم بأزلية المادة. وفي النهاية كنا غالباً ما نتمكن من وضع أيدينا على القضية الجوهرية. فبالنسبة لهم، كان أزلية المادة عديمة العقل شيئاً مقبولاً بالكامل، ولكنهم لم يقبلوا أزلية إله شخصاني. وهكذا لم يكونوا منطقيين في اعتقادهم. وهو ما ينطبق على “دوكينز”. طاقة أزلية: نعم، ولكن شخص أزلي: لا. أين المنطق في هذا كله؟
وسواء أكان “دوكينز” يعتنق الفلسفة المادية عتيقة الطراز بكونها الأزلي أو لا، فلا شك أنه مضطر أن يؤمن بأن الكون خلقه هو شخصياً. ومن ثم من حقنا أن نرد إليه سؤاله: «من خلق الخالق؟» ونسأله: من خلق خالقه، أي الكون؟ وهكذا تكون المعاملة بالمثل.
نظرية كل شيء!
يعبر “دوكينز” عن أمله في أن الفيزيائيين سوف «يكملون تحقيق حلم أينشتاين ويكتشفون النظرية النهائية لكل شيء. وإني متفائل أنه بالرغم من أن نظرية كل شيء ستضع نهاية مقنعة للفيزياء، فالمشروع الفيزيائي سيستمر في الازدهار، تماماً كما استمر علم الأحياء في النمو بعد أن حل داروين المشكلة العويصة فيه. وإني متفائل أن النظريتين معاً ستقدمان تفسيراً طبيعياً محضاً لوجود الكون وكل ما فيه، بما فيه نحن.»
وهنا أيضاً نرى تناقضاً فكاهياً لطيفاً، وإن كان غير مقصود. نظرية كل شيء Theory of everything (TOE)، كما يرى “دوكينز”، تضع نهاية للفيزياء. أي أن نظرية كل شيء هي بالطبيعة النقطة التي ينتهي عندها المسار التفسيري. وبناء على اعتراض “دوكينز” على أن يكون الله هو نهاية هذا المسار التفسيري، يجب أن يوبخ الفيزيائيين على اقتراحهم كل شيء باعتبارها التفسير النهائي لأصل الكون. ولكن يبدو أن البحث عن “نظرية كل شيء” مقبول طالما أنه لا يتصل بقدم إلهية.
ولكن تفاؤل “دوكينز” أثبت عدم واقعيته. فبعض الحقائق الرياضية النكدة تقف في طريقة متمثلة في الخلاصة الشهيرة التي توصل إليها “كرت جودل” من أن علم الحساب المألوق لنا وغيرها من النظم الرياضية الأكبر لا يمكنها إثبات اتساقها الداخلي، ولا بد أن تشتمل على افتراضات لا يمكن إثبات صحتها من خطئها، أي لا يمكن إثباتها ولا نفيها بوسائل علم الحساب. وللتعبير عن المعنى بأسلوب آخر أقول إن أي نظام بديهي منته finite axiomatic system ويتمتع بالقوة التي تؤهله ليحوي أساسيات في علم الحساب، دائماً ما يتضمن جملاً تقريرية صحيحة لا يمكن إثباتها. ويشير عالم الرياضيات “نايجل كتلاند” Nigel Cutland إلى أن هذه الحقيقة تجر تداعيات سلبية فيما يختص بإمكانية صياغة نظرية علمية موحدة تشتمل طبعاً على الحساب.
أما “ستيفن هوكينج” الذي حلم أيضاً لسنوات بهذه النظرية النهائية اعترف سنة 2004 أن “جودل” قضى عليهم: «سيشعر البعض بخيبة أمل شديدة إن لم يمكن وضع نظرية نهائية في شكل عدد منته من القوانين. لقد كنت ضمن هذا المعسكر، ولكني غيرت رأيي. وأنا الآن سعيد أن سعينا للفهم لن ينتهي أبداً. ودائماً ما ستتوفر لنا تحديات الاكتشافات الجديدة، وإلا نصاب بالركود. وكما ضمنت نظرية “جودل” وظيفة دائمة للرياضيين، أظن أن نظرية – إم M theory ستضمن وظيفة دائمة للفيزيائيين.»
ولنعد الآن لمسألة التفسير النهائي. الملحدون الجدد يعترضون على أن يكون الله هو التفسير النهائي. ومع ذلك، هم أنفسهم لا يملكون تفسيراً لوجود المادة أو الطاقة التي يتكون منها الكون. ففلسفتهم المادية تتوقف عند هذه النقطة، أي وجود المادة أو الطاقة الذي يجب عليهم أن يأخذوه بصفته حقيقة جامدة أساساً. ومن ثم، يمثل تفسيرهم النهائي. ومنطقياً، سلاسل المسبب والأثر إما تسير للخلف إلى ما لا نهاية، أو تتوقف عند نقطة حقيقة نهائية. والتفسير في العلم (أو في أي مجال آخر)، إن أراد أن يتجنب الرجوع إلى ما لا نهاية، دائماً ما يقود إلى أشياء معينة تعتبر نهائية.
وقد كتب “أوستن فارر” قائلاً: «أي سعي لا نهائي نحو تفسير يمدح من حيث إنه حالة من الكمال المثالي الذي لا يقنع أبداً. وهو في الحقيقة ميل يميز العقول الطفولية. “لماذا يرتدي ذلك الرجل القبعة؟” “لأنه شرطي”. “لماذا هو شرطي؟” “لأنه أراد أن يكون شرطياً عندما يكبر”. “لماذا أراد أن يكون شرطياً؟” “لأنه أراد أن يكسب رزقه”. “لماذا أراد أن يكسب رزقه؟” “ليستطيع أن يعيش. كل الناس يريدون أن يعيشوا”. “لماذا يريد كل الناس أن يعيشوا؟” “كف عن قول [لماذا؟] يا حبيبي، واذهب للنوم”. نعم. عند نقطة ما لا بد أن نتوقف عن قول “لماذا؟” لأننا وصلنا إلى الحقيقة التي يعتبر السؤال عنها بلا طائل، فمثلاً لا فائدة من أن نسأل: لماذا تريد الكائنات الحية أن تعيش؟» فحتى الطفل يمكنه أن يشرح صعوبة الرجوع إلى ما لا نهاية.
وقد أوجز “فارر” المسألة وأصاب الهدف ببراعة قائلاً: «إن القضية بين الملحد والمؤمن ليس فيما إذا كان من الحكمة أن نسأل عن الحقيقة النهائية أم لا، ولكنها تتمثل في السؤال: ما هي الحقيقة النهائية؟ الحقيقة النهائية عن الملحد هي الكون، أما الحقيقة النهائية عند المؤمن بالله الخالق هي الله.»
السؤال المُلح:
السؤال الملح إذن: في أي اتجاه يشير العلم، المادة قبل العقل، أم العقل الأسمى قبل المادة؟ لا بد من تحديد إجابة هذا السؤال، كما هو الحال دائماً، باتباع نصيحة سقراط، ألا هوي فحص الدلائل والسير في الاتجاه الذي تقود إليه، حتى وإن كان في ذلك تهديد لأفكارنا المسبقة.
ويطرح عالم الأحياء “جيمز شابيرو” هذا السؤال: «ما أهمية ظهور نقطة التقاء بين علم الأحياء وعلم المعلومات في دراستنا للتطور؟ إنها تتيح إمكانية التعامل العلمي وليس الأيديولوجي مع القضية المحورية التي تمثل أرض المعركة للأصوليين من الجانبين، الخلقي والدارويني. هل من أي ذكاء موجه يعمل في أصل الأنواع التي تظهر قدرات عجيبة على التكيف بدءًا من دورة كربز ومروراً بأداة الانقسام المتساوي mitotic apparatus والعين وانتهاءً بجهاز المناعة، ونظام التمويه والتنظيم الاجتماعي عند الحيوانات؟»
عالم الفيزياء الحيوية “دين كنيون” Dean Kenyon أحد مؤلفي كتاب دراسي قوى في أصل الحياة، يقول إنه كلما ازدادت معرفتنا في السنوات الأخيرة بالتفاصيل الكيميائية للحياة من علم الأحياء الجزيئي ودراسات أصل الحياة، تضاءلت مقبولية التفسير الطبيعي المحض لأصل الحياة. فما أجراه “كنيون” من دراسات قاده لخلاصة مفادها أن المعلومات البيولوجية مصممة: «إن كان العلم يقوم على الخبرة، إذن فهو يخبرنا أن الرسالة المشفرة في الـ DNA لا بد أن تكون قد نشأت من مسبب ذكي. ولكن ما نوع هذا الفاعل الذكي؟ العلم وحده لا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال. لذا، عليه أن يتركه للدين وللفلسفة. إلا أن هذا يجب ألا يمنع العلم من الاعتراف بالدلائل على مسبب ذكي للأصل أينما وجدت.»
لذلك، من الغريب أن يسطر عالم بارز في مكانة “إي. أو. ويلسون” ما يعبر عن إنكاره لوجود هذه الدلائل: «أي باحث يمكنه أن يثبت وجود تصميم ذكي في الإطار المقبول للعلم سيدخل التاريخ وسيخلد اسمه. لأن هذا يعني أنه نجح أخيراً في إثبات أن العلم والعقيدة الدينية متوافقان! إن جائزة مجمعة من جائزة نوبل وجائزة تمبلتون Templeton Prize (الأخيرة تهدف لتشجيع البحث عن هذا النوع من الانسجام) لا ترقى إلى مستوى هذا الإنجاز. وكل عالم يتمنى أن يحرز هذا السبق الذي يشكل بداية عصر جديد. إلا أنه ما من عالم تمكن ولو حتى من إحراز قدر ضئيل من هذا الإنجاز، لأنه للأسف ليس لدينا دليل، ولا نظرية، ولا مقاس للإثبات يمكن أن يبدو ولو ظاهرياً أنه علم. فكل ما لدينا بقايا ذلك الموقف المأمول، الذي يتضاءل باطراد كلما تقدم علم الأحياء.» وقد وصفت هذا الكلام بأنه غريب لأنه حتى لو أراد المرء التقليل من شأن ما ناقشناه في الفصول السابقة بخصوص علم الأحياء لأنه يتحدى بعض الأفكار السائدة عن أصل الحياة، فكيف له أن يتجاهل دلائل الفيزياء وعلم الكون التي لا تشكك في العلم المقبول، بل تنبثق منه؟ ولكن قارن موقف “ويلسون” بموقف “آلن سانديج” الذي يعتبره الجميع أعظم علماء الكون المعاصرين: «إن العالم شديد التعقيد في كل أجزائه وتشابكاته حتى إنه يستحيل أن يكون وليد الصدفة وحدها. إني مقتنع أن وجود الحياة بكل ما فيها من تنظيم في كل كائن من كائناتها الحية مركب معاً بمنتهى البراعة.»
ولعلنا نذكر أيضاً أن دلائل البحث العلمي المختصة بمسائل أصل الحياة هي التي قادت الفيلسوف البارز “أنتوني فلو” الذي عاش ملحداً طيلة حياته، للإيمان بأن طبيعة تعقيد الـ DNA لا يمكن تفسيرها إلا بخالق ذكي. “ويلسون” يقول إنه لا يوجد دليل، “سانديج” وكذلك “فلو” يقولان بوجود دليل. لا يمكن أن يكون كلا الموقفين صحيحاً.
إله الفجوات مرة أخرى!
يجب عند هذه النقطة أن نؤكد أن ما توصلنا إليه في هذا الفصل من استدلالات على مسبب ذكي لا تنتمي لفئة “إله الفجوات” وذلك لأنها لا تقوم على الجهل بالعلم بل على المعرفة به. فمثلاً، مؤيدو برنامج SETI يرون أن القول بذكاء كائن فضائي من خارج الأرض باعتباره مصدر الرسالة الغنية بالمعلومات التي وصلت إلينا، لا يعادل القول بفكرة “كائن الفجوات الفضائي”. وإن كان التحليل الرياضي والمعلوماتي متشابهاً في الحالتين، أليس من قبيل الاتساق أن نفترض مصدراً ذكياً للرسائل الغنية بالمعلومات المتضمنة في الـ DNA ولا نعتبره “إله الفجوات”؟
ويساعدنا هذا المثال على استخلاص ولو جزء من السبب وراء صعوبة التخلص من انطباع محاجة إله الفجوات. وهذا هو السبب: إن سلمنا بفرضية SETI (إشارة ينقلها مصدر ذكي ويعترف بها العلم)، لاكتشفنا فجوة واضحة في معرفتنا على مستوى التعرف على هوية الذكاء مصدر الرسالة، لا على مستوى تحديد لما إذا كان هناك ذكاء أم لا. أي أننا نخرج من ذلك بحالة التشويش نفسها بشأن معنى “التصميم الذكي” الذي طرحناه في تمهيد الكتاب.
وكما رأينا آنفاً، نحن لا نجد صعوبة في الاستدلال على كاتب ذكي بصفته مصدر الكتابة، لأننا نعلم أنه لا جدوى من محاولة تقديم تفسير اختزالي يقوم على فيزياء وكيمياء الحبر والورق. ويمكن التعبير عن ذلك بأسلوب مختلف: فيما يتعلق بتقديم تفسير كامل للكتابة على الورق، مؤكد أن هناك فجوة في القدرة التفسيرية للفيزياء والكيمياء. وهي ليست فجوة جهل، ولكنها فجوة من الناحية النظرية، أي فجوة تكشفها معرفتنا بالعلم، لا جهلنا به. أي أننا يمكن أن نطلق عليها فجوة “جديدة” لتميزها عن الفجوات “السيئة” التي لا تمثل فجوات من الناحية النظرية، ويتضح في النهاية أنه يمكن تفسيرها بالفيزياء والكيمياء.
فالكتابة على ورقة (أو الرسم على لوحة) يعكس ما يسميه الفيلسوف “دل راتش” Del Ratzsch التيار المضاد counter flow، وهي ظواهر لا تستطيع الطبيعة إنتاجها دون مساعدة فعل ذكي. وذلك لأننا نعلم، حتى من الناحية النظرية، أن علوم الفيزياء والكيمياء لا تستطيع أن تفسر التيار المضاد الذي يظهر في الكتابة، لدرجة أننا نرفض التفسير الطبيعي المحض، ونفرض وجود كاتب.
ولكن لا بد أن نشير إلى أن افتراض فاعل ذكي لتفسير الكتابة لا يندرج تحت فئة “كاتب الفجوات”، بل إن معرفتنا بطبيعة “الفجوة” هي التي تتطلب افتراض وجود كاتب.
وهكذا، معرفتنا بطبيعة المعلومات البيولوجية من ناحية، ومعرفتنا بأن المصادر الذكية هي المصادر الوحيدة المعروفة للمعلومات، من ناحية أخرى، بالإضافة إلى معرفتنا بأن الصدفة والضرورة لا تقدران أن تولدا نوعية المعلومات المحددة المعقدة التي نراها في الكائنات الحية، تشير كلها إلى التصميم باعتباره أفضل تفسير لوجود الـ DNA الغني بالمعلومات.
ولا أشك أن إحجام بعض العلماء عن الاستدلال على التصميم بناءً على وجود جزيئات حيوية غنية بالمعلومات لا يتعلق كثيراً بالعلم بقدر ما يتعلق بما يجره هذا الاستدلال من تداعيات بخصوص هوية المصمم. ومن ثم، فهي مسألة منظور فلسفي، وليست مجرد مسألة علمية. لأن العلماء لا يمانعون مطلقاً في التوصل لاستدلالات تصميم (علمية) تدلل على فعل بشري أو حتى فعل كائن فضائي. إذن الصعوبة لا تكمن في كوننا عاجزين عن التوصل لاستدلالات على التصميم.
وعند هذه النقطة يبدأ البعض في الشعور بعدم الارتياح، ومفهوم طبعاً أنهم الملحدون، حيث إنه يرفضون وجود الله، فكم وكم يكون شعورهم تجاه فعله. ولكن هذا الشعور يعكس خوفاً من تهمة إله الفجوات حتى إن بعض اللاهوتيين يرون أن الطبيعة تتمتع بنوع من “الاكتمال الوظيفي” Junctional integrity، وهو ما يعنى أن العالم مخلوق ولكن “لا تشوبه أي عيوب وظيفية، ولا تتخلل نظامه أي فجوات تتطلب فعلاً فورياً من الله.» ومن ثم، يبدو أن أصحاب هذا الموقف مضطرون أن يؤمنوا على الأقل بأن كل المعلومات اللازمة لإنتاج كل التعقيد الذي نراه حولنا كانت متضمنة في الكون منذ البداية عند الخلق الأصلي ولم تضف أي معلومات بعدئذ.
إلا أن “جون بولكينجهورن” الذي يرفض لاهوت إله الفجوات (السيئة) رفضاً قطعياً، يصر على أننا لا بد ألا «نقنع بالكلام اللطيف الخفيف غير الحاسم الذي لا ينجح حتى في ربط أفكارنا الحدسية عن فعل الله بمعرفتنا بالعملية الفيزيائية.» ويتلخص موقفه فيما يلي: «إن كان العالم المادي مفتوحاً حقاً، وإن كانت علّيّة رأسية تتجه من أعلى لأسفل تعمل في هذا العالم، فلا بد من وجود “فجوات” أصيلة (“مظروف يحمل فرصة لإمكانية حدوث شيء”) في تفسير الطبيعة التي تتجه من أسف لأعلى لتفسح مجالاً للعلية المقصودة…. فنحن، بلا خجل، “أناس الفجوات” بهذا المعنى الأصيل ولا عيب في فكرة “إله الفجوات” بهذا المعنى أيضاً.» أما عن طبيعة تفاعل الله فهو «لا يتم في صورة طاقة energetic بل في صورة معلومات informational.»
تثير هذه العبارة الأخيرة قضية في غاية الأهمية. فإن كان الله قد فعل بعض الأشياء بشكل مباشر (مثل خلق الكون)، فلا بد أن يكون مسؤولاً عن بعض الأفعال أو التفاعلات المختصة بالطاقة. فمهما كان، قانون حفظ الطاقة يخبرنا أن الطاقة تحفظ. ولكنه لا يخبرنا بمصدر هذه الطاقة، وهو شيء غالباً ما يسهل تجاهله. والآن، أنا أتفق أنه علينا أن نحذر من السقوط في فخ إله الفجوات (السيئة)، ولكن كما أشار “آلفن بلانتيجا” أنه منطقياً إن كان هناك إله يفعل أي شيء في العالم بشكل غير مباشر، فلا بد في نهاية الأمر أن يفعل شيئاً مباشراً أو يخلق شيئاً على نحو مباشر. وما أن نعترف أن الله فعل فعلاً مباشراً ولو مرة واحدة في الماضي في الخلق الأصلي للعالم، فما الذي يمنعه من أن يفعل أكثر من مرة، سواء في الماضي أو المستقبل؟ فمهما كان، قوانين الكون ليست مستقلة عن الله، فهي مجموعة المبادئ التي نعبر بها عن الضوابط التي وضعها هو في الكون. فمن العبث أن نظن أنها قيدت الله ومنعته من أن يفعل أي فعل خاص. ويوجز “بلانتيجا” موقفه قائلاً: «ألا يمكن أن نتوصل لهذا الاستنتاج الحكيم من أن الله خلق الحياة مثلاً، أو الحياة البشرية، أو خلق أي شيء آخر خلقاً خاصاً؟ (ولست أقول إنه يجب علينا أن نستنتج ذلك: ولكني أقترح فقط وأقول «ألا يمكن»، وإن كان هذا هو أكثر ما ترجحه الأدلة بقوة، عندئذ يجب علينا أن نصل لهذه الخلاصة).»
إن لب القضية هو: هل نحن مستعدون أن نتبع الدلائل أينما تقودنا، حتى وإن كانت تشير إلى تفسير بعيد عن التفسير الطبيعة المحض؟ إن كان هناك خالق، إذن يجب أن نجد شيئين. أولهما، يجب ألا نتعجب إن كانت محاولاتنا لفهم الكون بناءً على افتراضات طبيعية ناجحة جداً في أغلبها، لسبب بسيط جداً، ألا وهو أن الطبيعة موجودة سواء آمنا بخالق أم لا (نحن لم نأت بالطبيعة). وثانيهما، من المحتمل أن نجد عدداً قليلاً نسبياً من الفجوات “الجيدة” التي لا تخضع لأي منهجية طبيعية خالصة، بل الحقيقة أنها تزداد صعوبة أمام هذه المنهجية. ولكنها على قدر كبير من الأهمية كما سيتضح لك عندما أسردها عليك: أصل الوعي، أصل القدرة على التفكير ومفهوم الحق، أصل الأخلاق والروحانية. وهذا الكتاب لا يمكنه إلا أن يمثل بداية متواضعة في بضع النقاط الأول في هذه القائمة.
والآن لا بد أن أشدد بكل وضوح على أنه إن كانت هناك بعض الفجوات “الجيدة” التي تشير إلى خالق، فهذا لا يعني على الإطلاق أن هذه الفجوات هي الدليل الوحيد الذي يقدمه العلم على وجود الله. ولكنها دلائل إضافية على مجموعة الدلائل الرئيسية التي تزودنا بها عجائب الخليقة ككل. وعلى أي حال، فاللاهوت المسيحي المعتبر يؤكد أن الله لم يخلق الكون في البداية وحسب، ولكنه فاعل باستمرار في حفظه وفي كل ما يجري فيه من عمليات وإلا يختفي الكون من الوجود. وما نفهمه من ذلك على ضوء الفيزياء والكيمياء يبين لنا مجده بغض النظر عن قولنا فيما لا نفهمه بمساعدة هذه العلوم.
والمادي بطبيعة الحال لابد أن يرفض مسبقاً احتمالية وجود فجوات “جيدة” تشير إلى نشاط الخالق. أما المؤمنون بالله، فلهم موقف مختلف. فهم على أقل تقدير يؤمنون أن الله يتسبب في وجود الكون. ومن ثم، فهو مسؤول عما يجري فيه من عمليات طبيعية. وعندئذ ينشأ السؤال عما إذا كان يجب أن نعتبر أن الله هو المسبب الأعلى لهذه العمليات جميعاً أي أنه يسببها على نحو غير مباشر من حيث أنها تتم في كون هو المسؤول الأعلى عنه، أم أن بعض ما يجري في الكون من عمليات أو أحداث قد ينطوي على نوع من الفعل الإلهي المباشر.
ولقد بينت فيما سبق أن تفاصيل علم الأحياء تشير إلى “لوجوس” يكمن وراء الحياة. وقد أوضحت أن جزءًا من هذا الدليل يتعلق بمحدودية قدرة الانتخاب والطفرة، أي حدود التطور، إلا أني ركزت في حجتي على أصل الحياة وشفرتها الرقمية. وأود أن أسجل ملاحظة أخيرة في هذا الجزء عبارة عن مشابهة مثيرة للفيلسوف الألماني البارز “روبرت سبيمن” Robert Spaemann لإلقاء الضوء على خلل التفكير الإلحادي بشأن علم الأحياء. فهو يشير إلى ما اكتشفته عالمة الموسيقى “هلجا ثون” Helga Thoene في مقطوعة “بارتيتا الكمان في سلم ري الصغير” Violin Partita in D-minor للموسيقي “ج. س. باخ” J. S. Bach من تشفير مزدوج عجيب. فقد وجدت أنك إن طبقت على المقطوعة نمطاً صورياً من الأرقام يقابل الحروف الأبجدية تنتج عندك هذه الحكمة القديمة: Ex Deo nascimur, in Christo morimur, per Spiritum Sanctum reviviscimus. وبالطبع لسنا بحاجة لمعرفة هذا النص الخفي حتى نستمتع بالمقطوعة، فقد استمتع بها الناس على مدى مئات السنين دون أن تكون لديهم أدنى فكرة عن هذه الرسالة الخفية. ولكن الفضل يرجع لعبقرية “باخ” في تشفير رسالة مختلفة تماماً في مقطوعة موسيقية، عندما تقيم بمعايير علم الموسيقى وحدها، تعد مقطوعة في غاية الروعة.
ويرى “سبيمن” أن هذه هي مشكلة الملحدين الجدد وموقفهم من علم الأحياء التطوري: «يمكنك إن أردت أن تصف العملية التطورية بلغة طبيعية بحتة. إلا أن النص الذي يظهر بعدئذ عندما ترى شخصاً، وعندما ترى فعلاً جميلاً أو صورة جميلة لا يمكنك أن تقرأه إلا إذا استخدمت شفرة مختلفة تماما.» ويستأنف “سبيمن” مشابهته فيتخيل عالم موسيقى يقول إن المقطوعة تشرح نفسها بالكامل، وإن الصدفة وحدها هي التي أنشأت هذه الرسالة. ومن ثم، يكفي تفسير المقطوعة تفسيراً موسيقياً صرفاً دون اعتبار للنص. ألا يتطلب منا ذلك قدراً كبيراً من السذاجة حتى نقتنع به؟ بالطبع. فيستحيل أن نقبل ولو للحظة واحدة أن النص وجد بالصدفة دون أن يضع أحد شفرته. وهو ما ينطبق على العلم. فيمكنك، إن شئت، أن تحد نفسك في علم طبيعي بحت. ولكنك لا تستطيع بعدئذ أن تأمل في تفسير النص الذي سيظهر أمامك. ووفقاً لهذه النظرة فعالم الموسيقى، بصفته عالم موسيقى، يمكنه أن يشرح كيفية تأليف المقطوعة في حالة واحد فقط، إن تجاهل النص. ويبدو أن هذا هو بالضبط موقف الملحدين الجدد. فهم يتجاهلون “النص” الذي هو عبارة عن إنسان بكل ما في لوحة حياته وقدرته اللغوية والفكرية من ثراء.
إلا أنهم عند هذه النقطة سينفذ صبرهم ويطلقون اعتراضاً من حيث المبدأ على فكرة إله فائق للطبيعة يمكنه أن “يتدخل” في مجرى الطبيعة. وقد اشتهر فيلسوف التنوير الإسكتلندي “دافيد هيوم” بصياغته لهذا الاعتراض، إذ رأى أن “المعجزات تنتهك قوانين العلم”. وقد حذت أجيال من العلماء حذو “هيوم”، وأشهرهم “ريتشارد دوكينز”. ولذا، علينا أن نفحص ما قاله “هيوم”.
[1] مشابهة وضعها “برتراند رسل” ليبين أن مسؤولية البينة الفلسفية تقع على من يقول بمزاعم لا يمكن إثبات صحتها أو خطئها علمياً، ولا تقع المسؤولية على من يشكك فيها، ولا سيما في مجال الذين (المترجم).
[2] الترجمة العربية المبسطة. (المترجم)
[3] الأصل اليوناني للكلمة khoos ويعني “فجوة شاسعة”، “فراغ”. (المترجم)
[4] الأصل اليوناني للكلمة kosmos ويعني “نظام” أو “عالم”. (المترجم)