خالق الشر – القديس يوحنا ذهبي الفم
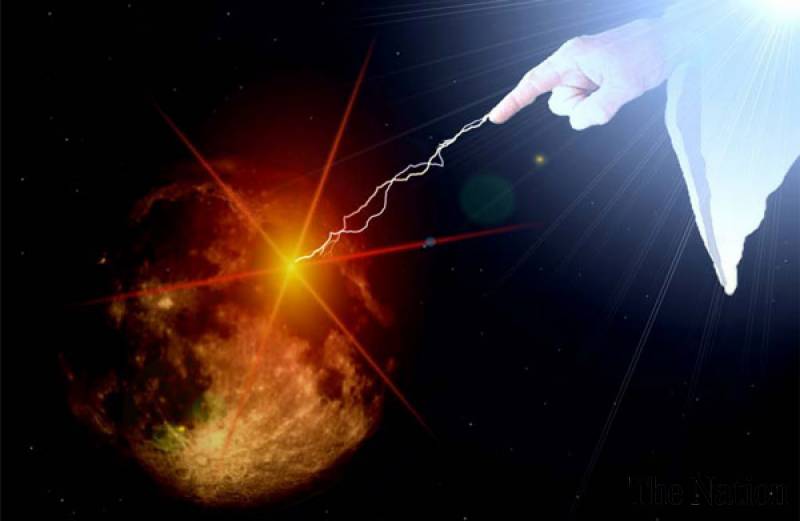
خالق الشر – القديس يوحنا ذهبي الفم
” أنا الرب وليس آخر، مُصوِّر النور وخالق الظلمة،
صانع السلام وخالق الشر” (إش 45: 6،7).
في الواقع، هذه الآية تبعث على القلق العميق في الشخص الغير منتبه إنتباهاً شديداً. لذلك، انصتوا بإهتمام، اشحذوا السمع، واصغوا لما يقال بإنصرافكم عن كل إهتمام دنيوي … ” أنا الرب وليس آخر، مُصوِّر النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر”. اني استمر في ترديدها حتى تصبح محفورة في ذهنكم، وبعد ذلك نبحث عن الحل. انه ليس الشخص الوحيد الذي قال هذا، كاتب آخر أيضاً كان على إتفاق معه عندما قال: “هل تحدث بليَّة في المدينة والرب لم يصنعها؟” (عا 3: 6). ما معنى هذا النص؟ يجب أن يكون هناك حل واحد للاثنين. فما هو الحل؟ لنستمع جيداً وبإنتباه شديد. ليس بشكل عشوائي أو بلا غرض نوصيكم بهذا باستمرار، بل لأننا الآن ماضون إلى عمق المعنى. هناك بعض الأمور جيدة، البعض الآخر سيئ، والبعض الآخر ما بين هذا وذاك ـــ بينما يعتقد الكثير من الناس بشأنه أنه سيئ، إلا أنه في واقع الأمر هو ليس كذلك، بل فقط يتم وصفه واعتباره كذلك.
ولكن لكي أوضح ما أقوله، دعونا نُحلِّل وجهة نظرنا بإستخدام الأمثلة أيضاً. بينما يعتقد كثير من الناس أن الفقر شراً، هو في الواقع ليس كذلك، بل بالأحرى قد يكون له مفعول إزالة الشرور، إذا نظرتم إليه بتجرد وبقيَّم سليمة. وبالمثل، بينما يعتقد الكثير من الناس أن الثروة حسنة، في واقع الأمر هي ليست كذلك من جميع النواحي، إذا لم يتم استعمالها بشكل صحيح. لو كانت الثروة حسنة من جميع النواحي، لكان الذين يمتلكوها أيضاً صالحين، لكن بما أنه ليس جميع الأغنياء صالحين بل فقط أولئك الذين يستخدمون الثروة بشكل جيد، فمن الواضح أن الثروة ليست حسنة في ذاتها بل هي في وضع متوسط. لنفكر ملياً في هذا: هناك صفات في الجسد تعطي نعتها للناس الذين يمتلكونها. على سبيل المثال، جمال الطلعة ليس جوهر بل خاصية، شيء ينتمي للجوهر بشكل عرضي، وإذا أصاب شخص ما فإننا ندعو هذا الشخص جميلاً. وبالمثل، المرض هو أيضاً خاصية تحدث عرضاً، وإذا أصاب شخص ما فإننا ندعو هذا الشخص مريضاً. هكذا أيضاً إذا كانت الثروة فضيلة لكان يتبع ذلك أن يكون الشخص الغني كذلك ويُدعى فاضلاً. لكن لو كان الغني ليس بفاضل على الاطلاق، تكون الثروة ليست فضيلة من كل الأوجه ولا حسنة من كل الأوجه، بل تصير كذلك فقط بحسب عقلية من يستخدمها. وبالمثل، لو كان الفقر شراً، لكان يتبع ذلك أن يكون جميع الفقراء أشراراً، لكن إذا كان الكثير من الفقراء قد بلغوا السماء، فالفقر بالتأكيد ليس شراً.
قد تسأل، لماذا إذن يدفع الفقر الكثير من الناس للتجديف؟ إن الفقر ليس هو السبب، بل هم يفعلون ذلك من قلة وعيهم ووضاعة مستواهم الروحي. وأيوب الطوباوي دليل على ذلك: بالرغم من كونه قد صار في فقر مدقع، بعيداً عن أي تجديف استمر في مباركة الله قائلاً: “الرب أعطى والرب أخذ، ما بدا حسناً للرب ذلك حَدَث، فليكن اسم الرب مباركاً” (أي 21: 1 س). وربما تقول أيضاً فيما يخص الأغنياء أن الكثير منهم جشعين وطماعين. هذا ليس بسبب الثروة بل بسبب إفتقارهم للإحساس. ونفس الرجل (أيوب) يشهد أيضاً لذلك: بالرغم من أنه كان يتمتع بمثل هذه الثروة الكبيرة، لم يأخذ ما يُخصَّ الآخرين، بل أعطى مما له وأعدَّ مأوى وملاذاً للغرباء، قائلاً: “غريب لم يبت في الخارج. فتحت للمسافر أبوابي” (أي 31: 32). إبراهيم أيضاً الذي كان عنده مثل هذه الثروة الكبيرة صرفها كلها على عابري السبيل. الثروة لم تجعل الأول أو الثاني جشعَين، كما أن الفقر لم يجعل أيوب أو لعازر يُجدفان، بل على العكس، على الرغم من عدم توفر الغذاء الضروري لهما، بَرزَّت فضيلة كل منهما، فواحد تلقى شهادة حسنة من الله ــ الذي له معرفة واضحة بالأفكار الخفيَّة ـــ والآخر حُمِلَّ من ههنا بواسطة موكب ملائكة، جاعلين مسكنه في رفقة البطريرك ليتنعم بنفس الخيرات مثله.
إذاً تلك الأمور هي في الوسط ـــ الفقر والغنى، الصحة والمرض، الحياة والموت، المجد والشرف، العبودية والحرية، وما إلى ذلك. ليست هناك حاجة للعبور عليها كلها، لئلا تصير الخطبة طويلة جداً، بل يكفي هذه الأمثلة لكي تكون لنا الفرصة أن نبلغ إلى قضايا أكثر إلحاحاً. يقول الكتاب المقدس: ” أعطِ حكيماً فيكون أوفر حكمَةً” (أم 9:9). إذاً كل تلك الأمور هي بَينَ بَينَ، وبالتالي يمكن للناس إستخدامها للخير أو الشر. والدليل على ذلك قدمه لنا إبراهيم الذي استخدم غناه بشكل صحيح. أيضاً في حالة الغني ولعازر، نرى أن الغني قد برهن على ذلك أيضاً، منفقاً ممتلكاته على خراب ذاته. لذلك، الغِنىَ ليس شيئاً جيداً أو سيئاً في جميع الحالات. لو كان حسناً في جميع الحالات وليس بَينَ بَينَ، ما كان الرجل الغني قد عانى تلك العقوبات الفظيعة، ولو كان سيئاً ما كان إبراهيم بغناه قد تمتَّع بمثل هذه السمعة الطيبة.
المرض هو شيء مماثل. لو كان المرض أمر سيء لكان يتبع ذلك أن يكون كل مريض أيضاً سيء. ولكان مُقدَراً لشخص مثل تيموثاوس أن يكون سيئاً بلا شك، إذ كان يقاوم مرضاً شديداً. “استعمل خمراً قليلاً من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة”، كما يقول الكتاب (1 تي 5: 23). لكن بما أن تيموثاوس حقاً لم يكن سيئاً، بل في الواقع نال مكافأة إضافية بوفرة من خلال تحمله للمرض بنبل، فمن الواضح أن المرض ليس أمراً سيئاً. كاتب مُلهَّم آخر عانى من ضعف البصر، لكن بدلاً من أن يكون سيئاً لهذا السبب، كان في الواقع شخصاً مُلهماً، وتنبأ بالمستقبل، وبرهن أن المرض ليس عائقاً أمام الفضيلة. من الناحية الأخرى، الصحة ليست جيدة من كل الأوجه، ما لم يستعملها الشخص بشكل صحيح وليس للأغراض الشريرة أو للخمول الطائش الذي لا يخلو من الأخطاء، لذا قال بولس أيضاً: “إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاً” (2 تس 10:3).
هذه الأمور هي بَينَ بَينَ، فتبرهن أنها على هذا الجانب في هذا الظرف، وعلى الجانب الآخر في ظرف آخر، وهذا يتوقف على الاستخدام الذي نتخذه بشأنها. لماذا نذكر فقط الصحة والمرض، الغنى والفقر؟ بل حتى الأمور التي بحسب تقدير عامة الناس تقع على قمة الأمور الجيدة أو في قاع الأمور السيئة، أعني الموت والحياة، ليست هكذا في جميع الحالات، بل هي في الوسط، مبرهنة أنها جيدة أو سيئة إعتماداً على توجه الذين يستخدمونها. وكمثال على ذلك: الحياة جيدة عندما يستخدمها الشخص بشكل صحيح، لكن عندما تُستخدم للخطية والفوضى، لا تُعَد جيدة، بل على العكس يكون من الأفضل لمثل هذا الشخص أن يفارق الحياة. مرة أخرى، ما هو في تقدير عامة الناس أنه ينبغي تجنبه (الموت) قد يكون مصدر خيرات لا تعد ولا تحصى، عندما يكون الدافع مناسب. تأملوا الشهداء المباركين أكثر من أي شخص آخر بسبب موتهم. هذا هو سبب عدم إشتياق بولس أن يكون على قيد الحياة في المسيح لأي غاية، بل فقط لأن ذلك كان له ثمر عمله. إذ يقول: “فماذا أختار؟ لست أدري. فإني محصور من الاثنين: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جداً. ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم” (في 1: 22 – 24). لذلك قال أيضاً الكاتب المُلهم: “عزيز في عيني الرب موت اتقيائه” (مز 116: 15) ـــ ليس أي موت بل هذا النوع من الموت ـــ وأيضاً في موضع آخر: “موت الأشرار رديء” (مز 34: 21 س).
ألا ترون أن هذا الأمر (الموت) أيضاً هو في الوسط، لا خيراً من كل النواحي ولا شراً من كل النواحي، بل يعتمد على سلوك من يجتازه؟ لهذا السبب سليمان الحكيم أيضاً عند سرده للأمور الحيادية يُبيِّن أنها ليست جيدة أو سيئة من كل الأوجه، بل تُصبح كذلك في الوقت المناسب، بل تصير حتى عبئاً عندما يكون الوقت لم يحن بعد: “للبكاء وقت وللضحك وقت، للحياة وقت والموت وقت”. بكلمات أخرى، الابتهاج ليس دائماً حسناً، بل هناك أوقات يكون فيها ضاراً، ولا الحزن دائماً حسناً بل هناك أوقات يكون فيها فادح ومدمر. ق. بولس أيضاً وضَّح هذه النقطة قائلاً: “لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله يُنشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فيُنشئ موتاً” (2 كو 7: 10). ألا ترون أن هذا الأمر أيضاً يقع ضمن الأمور الـوسط؟ لذلك لم يوصينا بالفرح دون قيد أو شرط، بل بالفرح في الرب (في 4:4).
إن معالجتنا قد قدمت لكم توضيحاً كافياً عن الأمور التي في الوسط. حان الوقت لكي نمضي قدماً للحديث لا عن الأمور الوسط بل عن الأمور الحسنة التي لا يمكن أن تكون رديئة، والأمور الرديئة التي لا يمكن أن تكون حسنة. ما ذكرته قبلاً، يكون بهذا النوع في وقت ما، وبنوع آخر في وقت آخر، مثل الغنى الذي يكون سيئاً في بعض الأحيان عندما يتم إنفاقه على الجشع، ويكون حسناً في أحيان أخرى عندما يتم استهلاكه في عمل الصدقة. وهكذا، بالنسبة للأمور الأخرى المشابهة وفقاً لهذه القاعدة. هناك أمور أخرى لا يمكن أن تكون سيئة في أي وقت من الأوقات، وأمور عكسها لا يمكن أن تكون حسنة في أي وقت من الأوقات، مثل المعصية، والتجديف، والفجور، والوحشية، واللاإنسانية، والشراهة، وما شابه. أنا لا أقول أن الشخص الرديء لا يمكن أن يصير صالحاً في أي وقت من الأوقات، أو أن الصالح لا يمكن أن يصير رديئاً في أي وقت من الأوقات. فبينما تلك الأمور لها فئة خاصة بها، البعض حسن، والبعض رديء، إلا أن البشر خلافاً لذلك يكونون صالحين عندما يختارون الأمور الحسنة، وأردياء عندما يختارون عكس ذلك.
هناك إذن، ثلاثة أنواع: بعض الأمور حسنة ولا يمكن أبداً أن تكون رديئة، مثل ضبط النفس، عمل الصدقة، وما شابه. وبعض الأمور رديئة ولا يمكن أبداً أن تكون حسنة، مثل الفسق والقسوة. وهناك أمور أخرى تصير حسنة أو رديئة بحسب توجه الشخص الذي يستخدمها. على سبيل المثال، الغنى أحياناً يُساهم في الطمع وأحياناً في العطاء، إعتماداً على سلوك المستخدم. الفقر أحياناً يُساهم في التجديف وأحياناً في البركة والاعتزال. غير أن معظم الناس غير الحكماء يصنفون كرديء ليس فقط الأمور الرديئة التي لا يمكن أن تكون حسنة بل أيضاً الأمور التي في الوسط، مثل الفقر، الأسر، العبودية، والتي قد أظهرنا أنها لا تنتمي للأمور الرديئة بل لتلك الفئة المتوسطة، في حين أن كثير من الناس ــ كما قلت قبلاً ــ يصنفون كرديء ما هو ليس رديئاً بالفعل، والتي بشأنها يقول الكاتب الملهم (إشعيا) أنها ليست رديئة في واقع الأمر، بالرغم من تصنيفها كذلك بحسب تقدير عامة الناس، مثل الأسر، والعبودية، والجوع، وما شابه.
والدليل على أن هذه الأمور ليست رديئة، بل ربما تساعد على طرد الأمور الرديئة، دعونا نركز أولاً على الجوع، والذي يعتقد الجميع أنه فظيع ومخيف. لنرى إذاً، كيف أنه ليس رديئاً، ولنتعلم التمسك بالقيم الصحيحة. عندما انحدر العبرانيون بسلوكهم إلى الافراط في الشر، نجد إيليا العظيم ــ الجدير بالسماء ــ في رغبته أن يتغلَّب على مرض اللامبالاة ويُقوِّمه، يقول: “حَيُّ هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، إنه لا يكون طلٌّ ولا مطرٌ في هذه السنين إلاعند قولي” (1 مل 1:17). على الرغم من إمتلاكه فقط عباءة واحدة، أغلق السماء، وكان لديه مثل هذه الثقة في الله. ألا ترون أن الفقر ليس رديئاً؟ لو كان الأمر كذلك، ما كان سيتمتع أكثر الناس إحتياجاً بمثل هذه الثقة، بحيث يبرهن بكلمة واحدة على مثل هذا السلطان الرائع، بينما لا يزال يخطو على الأرض. بقوله هذا، أَدخَلَ الجوع كمربي ممتاز ومُصلِح للشرور العارضة. وكما تضرب الجسم حمى مُستعرَّة، جفَّت السيول سوياً مع النباتات، وصارت الأرض منذ ذلك الحين عقيمة. ومن ثم، ربح الناس فائدة ليست بقليلة بالتخلص من فيضان الشرور، وتيقظوا، وصاروا أكثر قبولاً للإنقياد، وأصبحوا أكثر إستجابة للنبي. وأولئك الذين ذهبوا وراء الأصنام وضحوا بأطفالهم للشياطين صاروا ليس لديهم اعتراضاً على ذبح كهنة البعل، وبدلاً من الإنزعاج تحمَّلوا الحَدَث في صمت وخوف، وأصبحوا على نحو أفضل من خلال الجوع.
ألا ترون أن الجوع ليس فقط غير رديء بل يعمل حتى على إلغاء الشرور، مُصححاً الأمراض على غرار الدواء؟ إذا كنتم تعتبرون العبودية أيضاً كأمر رديء، تأملوا ما كان عليه اليهود قبل السبي، وما كانوا عليه أثناء الأسر، حتى تتعلم أنه لا الحرية حسنة من كافة النواحي ولا الأسر سيئ. تذكروا أنهم عندما كانوا يتمتعون بالحرية، وكانت لهم بلدهم الخاصة، ارتكبوا مثل هذه الأمور الفظيعة، حتى كان الأنبياء يحتَّجون عليهم يوماً بعد يوماً لكون الناموس يُداس تحت الأقدام، والأصنام تُعبَّد، ووصايا الله تُنتَهَك. لكن عندما اقتيدوا إلى أرض غريبة وعاشوا في بلاد أناس قساة، تأدبوا وتغيروا للأفضل وخضعوا للناموس. ومن الممكن إدراك حقيقة ذلك من المزمور الذي يتعيَّن علينا أن نُركِّز عليه اليوم، حتى نتعلم ثمار السبي. أي مزمور هذا؟ “على أنهار بابل هناك جلسنا. بكيناً أيضا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا. لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة. ومعذبونا سألونا فرحاً قائلين: رنموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟” (مز 137).
ألا ترون كيف أدبهم السبي؟ أما قبل الأسر، ما كانوا يتحملون دوي مناشدة الأنبياء بعدم خرق الناموس. بينما بعد الأسر، بالرغم من ضغوط الشعب القاسي، وإصرار أسيادهم، لم يستجيبوا لهم، بل قالوا: “لن نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة، نظراً لأن الناموس لا يسمح بذلك”. تأملوا أيضاً الثلاثة فتية الذين ليس فقط لم يتضرروا من الأسر بل صاروا أكثر تميُّزاً بواسطته، ودانيال كذلك. وماذا عن يوسف؟ أي شر قد عاناه، بالرغم من أنه صار منفياً وعبداً وأسيراً؟ ألم يكتسب بسبب ذلك سمعة طيبة وصار مشهوراً؟ وتلك المرأة الأجنبية (إمرأة فوطيفار)، التي كانت تعيش في ثراء وبهاء وحرية، أي خير حصلت عليه من كل ذلك؟ ألم تكن إمرأة بائسة أحقَّر من جميع النساء، لعدم رغبتها في إستعمال كل ذلك إستعمالاً سليماً؟
وهكذا، ظهر لكم بوضوح أن هناك بعض أمور رديئة والبعض حسنة والبعض في الوسط، وحقيقة أن الكاتب المُلهم (إشعيا) يقول أن الأمور الوسط ليست حقاً سيئة بل يُظَّن أنها كذلك بواسطة عامة الناس، كالأسر والعبودية والنفي. الآن، من الضروري أن نوضَّح السبب وراء هذه العبارة. فالله كليّ المحبة والسريع في إظهار الرحمة، بينما بطيء في ممارسة العقوبة، أرسل الأنبياء وذلك لكي يتجنب تسليم اليهود للعقاب، معتزماً أن يخيفهم بالكلمات حتى لا يعاقبهم بالفعل. وقد فعل ذلك أيضاً في حالة أهل نينوى، عندما هددَّ بقلب المدينة، ليس بقصد الإطاحة بها بل لتجنب الإطاحة بها، كما تم بالفعل في واقع الأمر. هذا ما فعله في هذه الحالة أيضاً، إذ أرسل الأنبياء مهدداً بقدوم البرابرة، واندلاع الحروب، والسبي، والعبودية، والنفي، والعيش في أرض غريبة. تماماً كما يفعل الأب المحب مع طفل متمرد كسول، راغباً في إعادته إلى رشده، إذ يبحث عن السوط ويهدد بالكلمات عن الجلدات: سوف أربطك، أجلدك، أتخلص منك، فيصير خائفاً فزعاً، وبهذه الطريقة يُخضع الصبي ويبعده عن طريقه الشريرة، هكذا أيضاً الله يهدِّد بشكل مستمر، راغباً في تغييرهم إلى نحو أفضل من خلال الخوف. أما الشيطان في رغبته لتقويض التغيير الناتج عن هذا التهديد، فقد أرسل أنبياء كذبة، ومما يتعارض مع تهديدات الأنبياء بالأسر والعبودية والمجاعة، بشروا خلافاً لذلك أي بالسلام والازدهار والتمتع بالخيرات الكثيرة. ومن ثم، سَخَرَ منهم الأنبياء أيضاً، بقولهم: “سلام، سلام، ولا سلام” (إر 14:6). وكل شيء تمَّ كما تنبأ الأنبياء ضد الأنبياء الكذبة (كما يعرف كل باحث)، الذين كانوا يزعزعون حماسة الشعب.
لذا، عندما زعزعزوا الناس بهذه الطريقة وأفسدوهم، قال الله بواسطة الأنبياء: ” أنا الرب وليس آخر … صانع السلام وخالق الشر” (إش 45: 6،7). أي نوع من الشر؟ تلك المذكورة: العبودية، الأسر، وما شابه. لا الزنا أو الفسق أو الطمع أو أي شيء آخر من هذا القبيل. لهذا قال نبي آخر: “هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟” (عا 6:3)، فهو يُشير إلى هذه المحَّن: المجاعة، الأمراض، الأوبئة، المرسلة من الله. هكذا أيضاً السيد المسيح بقوله: “يكفي اليوم شرُّه” كان يشير إلى العمل والجهد والصعوبات. هذا إذاً هو ما يقصده النبي: لا تدع الأنبياء الكذبة يضعفوك، فالله قادر أن يعطيك السلام ويدفعك للأسر. هذا هو معنى “صانع السلام وخالق الشر”. ولكي تعلم أن هذا الأمر صحيح، لنفحص نص الآية بتدقيق، إذ بعد أن قال ” أنا الرب وليس آخر، مُصوِّر النور وخالق الظلمة”، استطرد قائلاً: “صانع السلام وخالق الشر”. لقد استشهد بنقيضين أولاً، ثم بنقيضين بعد ذلك، لكي تعلم أنه لا يشير إلى الزنى بل للكوارث. أعني، ما هو الشيء المعاكس للسلام؟ بكل وضوح، هو الأسر والسبي لا الفسق أو الزنى أو الطمع. وكما استشهد بنقيضين أولاً، هكذا أيضاً في الحالة الثانية، ونقيض السلام ليس الزنا أو الفجور أو غيرها من الرذائل بل السبي والعبودية.
وكما خلق الله النور والظلمة، ومعظم الناس يعتقدون أن النور لطيف والظلام غاشم، ويسيئون فهم الليل كشيء شرير، هكذا في هذه الحالة أيضاً. غير أنه لا ينبغي أن يساء فهم الليل أو الظلام، ولا أيضاً الأسر أو العبودية في جميع الحالات. أخبرني، أين الرداءة في الظلام؟ أليس فيه إستراحة من العمل؟ أليس فيه إغاثة من الهموم؟ أليس فيه إزالة الشدَّة؟ أليس فيه زيادة في القوة؟ من ناحية أخرى، لو لم يكن هناك ظلام وليل فهل كان من الممكن أن نتمتع بالنور؟ ألا كان هذا الإنسان الحي قد دُمِّر وفُقِدَ؟ هكذا، كما يعتقد الناس الحمقى أن الظلام شراً، وهو ليس كذلك، بل يفيدنا ويجعل الذين يستريحون أثناءه أكثر نشاطاً للعمل، هكذا أيضاً الأسر ليس عديم القيمة ـــ وقد كان النبي يتكلم عنه عندما قال “صانع السلام وخالق الشر” ــ بل هو على العكس، له فائدة ومنفعة لأولئك الذين يستعملونه بشكل صحيح، جاعلاً إياهم أكثر إعتدالاً وعقلانية، بإزالة حماقتهم.
هكذا نرى، أن الفضيلة لا تُقيَّد، ولا شيء يستطيع أن يسود عليها، لا أسر، لا فقر، لا مرض، ولا حتى ما هو أكثر جبروتاً من أي شيء، الموت ذاته. هذا واضح من جميع الذين تحمَّلوا كل هذه الأشياء، وصاروا بواسطتها أكثر سطوعاً: فأي ضرر أصاب يوسف (ليس هناك ما يمنعنا أن نركز على نفس الشخص مرة أخرى)؟ من قيوده؟ من سلاسله؟ من الإفتراء عليه؟ من المكائد؟ من العيش في بلد غريبة؟ أي ضرر أصاب أيوب من فقدانه لقطعان الماشية، موت أبنائه القاسي والمفاجئ، البلاء الجسدي، حشود الديدان، الألم الذي لا يطاق، الجلوس في المزبلة، تآمر زوجته عليه، سخرية الأصدقاء، سوء معاملة الخدم؟ أي ضرر أصاب لعازر من اضطجاعه عند البوابة، لحس جسده بواسطة ألسنة الكلاب، الجوع المستمر، إزدراء الرجل الغني، الجروح، المرض الغير المحتمل، الحرمان من الأصدقاء، الاحتقار من جانب المساعدين؟ أي ضرر أصاب بولس من تعاقب تلك السجون، والاعتقالات، والميتات، والغرق، وجميع التجارب الأخرى التي يستحيل تعدادها؟
بمراعاة كل هذه الأمور، دعونا نتجنب الشر ونسعى وراء الفضيلة. وبينما نحن نصلي أن لا ندخل في تجربة، دعونا لا نتعثر أو نضطرب إذا سقطنا في وقت ما. هذه الأمور (التجارب) هي أسلحة الفضيلة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمونها بشكل صحيح، وسوف ننجح في الحصول على الاستحسان من خلالها، ونتمتع بالخيرات الأبدية، لو كنا ساهرين. ليكن هذا نصيبنا جميعاً أن نُحقِّق هذا، في المسيح يسوع ربنا، الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين.
المرجع: دورية المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بالقاهرة، العدد الواحد والثلاثون، يناير 2013، ترجمة المدونة الآبائية
Reference: John Chrysostom, Old Testament Homilies, translated by Robert Charles Hill, Holy Cross Orthodox Press.



