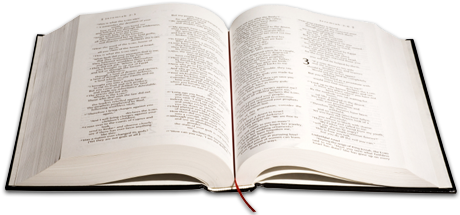ولادة ثانية في وضع خاطئ – فيليب يانسي

ولادة ثانية في وضع خاطئ – فيليب يانسي
“يا الله، أنا لا أحبك، ولا حتى أريد أن أحبك، ولكنني أرغب في أريد أن أحبك”
تيريز الأفيلية
في إحدى السنوات قمت أنا وزوجتي بزيارة بيرو، وهو البلد الذي أمضت فيه جانيت طفولتها. سافرنا إلى كوزكو Cuzco وماشو Machu لكي نشاهد آثار حضارة شعب الأنكا Inca العظيمة والتي حققت الكثير بدون أن تتعرف على الأبجدية، ولا حتى العجلة. وعلى مشارف كوزكو حيث سهل أخضر فسيح وقفنا أمام حائط مكون من أحجار رمادية اللون يزن كل منها حوال سبعة عشر طناً.
“لقد كانت الأحجار مقطعة بطريقة يدوية، ومرتبع مكونة الحائط بدون ملاط، وبدقة بالغة لا تسمح بوضع ورقة بين حجر وآخر”. هكذا قال مرشدنا السياحي، الذي هو من بيرو، بفخر. “ولا حتى أشعة الليزر الحديثة تقدر أن تقطعها بهذه الدقة. وحتى الأن لا أحد يعلم كيف فعل شعب الأنكا ذلك. ولهذا السبب قال إريك فون دانكن Erich von Daniken في كتابه “مركبات الآلهة” لا أن حضارة متقدمة من الفضاء الخارجي قد قامت بزيارة شعب الأنكا”.
سأل أحد أفراد مجموعتنا السياحية عن علم الهندسة الذي ساهم في نقل تلك الكتل الحجرية إلى أعلى التلة الجبلية، وبدون استخدام العجلات. غير أن شعب الأنكا لم يترك لنا أية سجلات مكتوبة يمكنها أن تجيب عن مثل تلك الأسئلة. ثم فكر بعمق مرشدنا السياحي كما لو كان سيذيع سراً عظيماً: “حسناً، إن الأمر هو هكذا…” وصمتت كل المجموعة علها تنال جواباً شافياً. وقال وهو ينطق كل كلمة بحذر شديد: “نحن نعرف الأدوات… ولكننا لا نعرف الآلات”. وبدت على وجهه الذي لفحته الشمس، علامات الرضى والارتياح لما قاله.
انتظرنا أن يضيف لما قاله أكثر، وملء عيوننا عطش لأية إضافات، غير أن مرشدنا تحول بناظريه عنا ليتابع الرحلة. إذ اعتبر أن ما قاله هو الإجابة الكافية لحل هذا اللغز. وعلى مدى الأيام القليلة التالية كان يجيب بنفس العبارة على أسئلتنا، وهذا أشعره بنوع من الأهمية وهو ما كان يضايقنا. وبعد أن ارتحلنا من كوزكو صارت إجابة المرشد السياحي نكتة تتندر بها المجموعة. فعندما يسأل أحدنا: هل يمكن أن يسقط المطر بعد الظهر، يجيب عليه شخص آخر بالاسبانية “حسناً نحن نعرف الأدوات… ولكننا لا نعرف الآلات”.
وردت على ذهني تلك العبارة الغامضة عندما حضرت تجمعاً للاتحاد مع العديد من زملاء الدراسة في كلية مسيحية. وبالرغم من أننا لم نر بعضنا منذ عشرين عاماً، إلا أننا بدأنا الحديث والدردشة بمودة شديدة. كل منا ناضل في حياة الإيمان ورغم هذا تمسكنا بإيماننا. كلنا اختبرنا الألم، وجددنا معرفتنا ببعضنا البعض، وتحدثنا أولاً عن الأطفال والعمل وتحركنا من مكان لآخر، وعن درجاتنا العلمية. ثم تحولت المناقشات إلى ما هو أصعب: عن الوالدين الذين أصيبا بمرض الزهايمر، وزملائنا الذين طلقوا، والأمراض المزمنة، والفشل الأخلاقي، والأطفال الذين تحرش بهن بعض أعضاء الكنيسة.
وفي النهاية توصلنا إلى أن وجود الله في حياتنا الآن أكثر ضرورة ولزوماً منه أيام الدراسة بالكلية. ولكن عندما استرجعنا بعض العبارات التي استخدمناها في التعبير عن اختباراتنا الروحية عندئذ أدركنا كل كانت تبدو غامضة وغير مفهومة. فمنذ 25 عاماً حين كنا ندرس في كلية اللاهوت، كنا ندرس عن حياة مملوءة بالروح، والخطية والطبيعة الجسدية، والتقديس، والحياة الوافرة. ورغم كل هذا لم نستطع تحقيق أي مبدأ منها وبالطريقة التي كنا نتوقعها. فلكي تشرح حياة الفرح بالروح لشخص يمضي كل يومه في العناية بأحد والديه المريض بالزهايمر، فإن هذا يبدو مشابهاً لإجابة ذلك المرشد السياحي الذي كان يشرح آثار حضارة شعب الأنكا قائلاً: “نحن نعرف الأدوات… ولكننا لا نعرف الآلات”. فاللغة لا تحتوي المعنى، ولا تعبر عنه.
إن الكلمات المستخدمة في الكنائس تسبب ارتباكاً للناس. فحين يقول الراعي: “إن المسيح يحيا فيك، ونحن أعظم من منتصرين”، فمع أن هذا الكلمات قد تثير في الكثيرين شعوراً بالاشتياق لهذه النصرة، غير أنه يصعب تطبيقها في أحداث الحياة اليومية. لقد سمع هذه الكلمات مُدمن للجنس، وصلى من أجل التحرير، غير أنه استسلم، و في ذات الليلة، لرغبته الجنسية المحرمة، حين استلم رسالة على بريده الاليكتروني من فتاة تدعى كاندي، أو هيذر تعده فيها بأنها سوف تُشبع كل نزواته. وعلى نفس المقعد تجلس امرأة تفكر في ابنها المراهق المحجوز بإحدى المؤسسات بسبب إدمانه للمخدرات. لقد بذلت كل ما في وسعها كأم، ولكن الله لم يستجب لصلواتها. هل يحب الله ابنها بدرجة اقل منها؟
كثيرون آخرون لا يذهبون للكنيسة بمن فيهم ثلاثة ملايين أمريكي يدّعون أنهم مؤمنون إنجيليون، وبرغم ذلك فهم لا يحضرون للكنيسة. ربما كانوا مشتعلين روحياً عندما كانوا في الجامعة او في مجموعات التبشير في الكلية ثم فتروا وانزووا وانطفأوا. وكما قالت إحدى شخصيات جون أبديك في روايته “شهر من الأحداث A Month of Sundays”: “ليس لدي إيمان، ولكن يبدو وأنه صالح للتطبيق”.
إنني أصغي لمثل هؤلاء الناس، وأتلقى الكثير من خطاباتهم. إنهم يقولون أن الحياة الروحية ليس لها تأثير مستمر، ومختلف بالنسبة لهم. فما يختبرونه شخصياً يبدو أنه مختلف عما يسمعونه موصوفاً بكل أمانة وثقة من على المنبر. ومما يُدهشني، فإن الكثيرين لا يلومون الكنيسة او المؤمنين الآخرين. إنهم يلومون أنفسهم. تأمل في هذا الرسالة التي وصلتني من رجل من أيوا Iowa يقول فيها:
“أنا أعلم أنه يوجد إله: أومن أنه موجود، ولكنني فقط لا أعرف بماذا أؤمن؟ …. ماذا أتوقع من هذا الإله؟… هل هو يتدخل في حياتنا (غالباً/ نادراً) عندما نطلبه، أم أنه يجب عليّ أن أقبل ذبيحة ابنه من أجل خطاياي؟ إنني أحسب نفسي محظوظاً، وهل أجعل العلاقة تصل إلى هذا الحد؟
إنني أشعر أنني مؤمن غير ناضج: وأن توقعاتي من الله غير واقعية. وأعتقد أنني أصبت بخيبة الأمل مرات كافية حتى أنني أصلي من اجل أن لا يتكرر هذا الأمر مرات ومرات.
ما هي الصورة التي يجب أن تكون عليها العلاقة مع الله؟ وما الذي يجب أن نتوقع من الله الذي يقول أننا صرنا أصدقاؤه وأصفياءه؟
إن هذا السؤال المحير عن العلاقة يبرز بصورة غير متوقعة في الخطابات. كيف يمكنك أن تحتفظ بعلاقة مع كائن مختلف تماماً عن أي شخص آخر نعرفه، ولا نستطيع إدراكه بحواسنا الخمس؟ إنني أستمع إلى أعداد كبيرة من الناس تتصارع داخلهم هذه الأسئلة وتظهر في خطاباتهم وفي كتبي التي كتبتها بعنوان: “أين الله عندما أتألم؟”، و”خاب أملي في الله”.
كتب أحدهم رسالة أخرى يقول فيها:
“اجتزت في تجربة صعبة لمدة سنتين، وكدت أتحطم تحت ضغطها. وقد اهتز إيماني بالرب يسوع وما زلت أحاول أن ألملم شتات الإيمان الذي كان قوياً ثابتاً يوماً ما. بدأت أتساءل: هل إيماني او ما يُسمى بـ “العلاقة الشخصية” أمر حقيقي وموثوق به. ونظرت إلى ما كل ما قلته وفعلته لله وتساءلت: “هل حقيقة كنت أعني ما كنت أقوله؟” وبمعنى آخر: كيف يمكنني أن أقول أن لي إيماناً بالله في حين أنني أتساءل ما إذا كان هو موجوداً؟ إنني أسـمع عن أناس يُصلّون من أجل أمور معينة وأن الله أخبرهم بهذا وذاك، ولكنني أجد نفسي عندما أقول مثل هذه الأمـور الروحية بأنني أحاول فقط أن أقوم بالتأثير على أحدهم، أو ربما أشـعر بأنني غير أمين! أشعر بعدم ارتياح عندما أفكـر في هذا الأمر، وأظل أتساءل: “متى أسـتطيع فهم الأشياء فهماً صحيحاً؟ ومتى تسير الأمور سيراً حسناً بالنسـبة لي؟ ما هـو الخطأ فيّ؟”
وكتب قارئ آخر بنفس الروح الضعيفة متسائلاً: “ما إذا كانت العلاقة مع الله تحمل أي معنى؟ وقد وصف جده على أنه رجل إيمان يمضي كل يومه في الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس، والكتب الدينية، ويستمع إلى العظات الروحية على شرائط كاسيت. وهو يمشي بصعوبة ويسمع بصعوبة، ويتناول الأدوية للتخفيف من آلام قدميه. ومنذ وفاة زوجته وهو يعيش بمفرده في حالة من الشك والارتياب، وينزعج من الفواتير أو الأنوار التي تُترك بدون استعمال. وعندما أنظر إليه لا أرى قديساً فرحاً بعلاقته مع الله، ولكنني أرى رجلاً عجوزاً متعباً يجلس فقط في انتظار موعد رحيله للسماء”. وقد اقتبس القارئ فقرة من كتاب للكاتب جارسون كايلور عن العمة العجوز ماري: “كانت تعلم أن الموت هو مجرد باب للملكوت حيث سيستقبلها يسوع ويرحب بها، وهناك لا يوجد بكاء ولا معاناة، ولكنها في ذات الوقت كانت تعاني من السمنة واعتلال بالقلب، وتعاني الوحدة مع كلابها الصغيرة، تسير في ترنح في منزلها الصغير المظلم، والممتلئ بالتماثيل الصينية الصغيرة”.
وآخر كتب موجزاً: “إنني أتساءل ما إذا كان التعبير المجازي “مولود ثانية” تعني مولود ناقص النمو”.
منذ فترة غير طويلة اجرينا تدريباً مع أعضاء مجموعة المناقشة التي أنتمي إليها، ووافقوا على أن يكتب كل واحد منا خطاباً مفتوحاً إلى الله، ويأتي به في اجتماعنا التالي. وعدت لأقلب في أوراقي لأجد خاطباً قد كتبته إلى الله منذ فترة غير بعيدة:
“عزيزي الله:
بالتأكيد انت لا تتصرف كما لو أن الله حي” – وهو نفس الاتهام الذي وجهه أصدقاء باتي إليها، وقد استحوذ على هذا السؤال منذ ذلك الوقت. هل أنا أتصرف كنا لو كنت أنت حياً؟
أحياناً أتعامل معك كمادة مخدرة، كالكحول أو الفاليوم، أحتاج إليه لتهدئة قسوة موقف معين، أو للتخلص منه. وأحياناً ساعياً لنسيان هذا العالم وأرغب في الذهاب إلى عالم غير مرئي، ومعظم الوقت أعتقد حقيقة أنه موجود، مثل هذا العالم الذي به الأكسجين، والخضرة، والماء. ولكن ماذا أفعل لكي يحدث العكس، ولكي أدع حقيقة عالمك أنت لأن تدخل إليّ وتحول حياتي اليومية المخدرة؟
وأعترف أنني أرى تقدماً في حياتي، إذ أراك الآن كشخص أحترمه أكثر مما أخافه. والآن أشعر أن رحمتك ونعمتك تؤثر فيّ أكثر من قداستك وخشيتك. وأعتقد أن هذا هو ما فعله يسوع من أجلي. لقد روضك لدرجة كافية لكي نتمكن من أن نعيش معاً في نفس القفص، بدون أن أظل في الركن طوال الوقت. لقد جعلك جذاباً وتستحق الحب. كما جعلني أنا جذاباً ومحبوباً لديك أيضاً. وهذا ما كنت أستطيع فعله من ذاتي، بل كان عليّ أن أصدق كلمتك. فمعظم الوقت أصدق هذا الأمر بصعوبة.
كيف أتصرف كما لو كنت أنت حياً؟ خلايا جسمي التي تعرق، وتتبول، وتكتئب، وتذهب للسرير ليلاً، كيف تحمل هذه الخلايا عظمة إله هذا الكون، بطريقة يمكن أن يراها الآخرون؟ كيف يمكنني أن أحب شخصاً بنفس الحب الذي أتيت به أنت إلينا؟
لقد أحببتك، وأحببت عالمك، وتعلمت كيف أتجاوب معه، ولكن كيف أوفق بين الاثنين؟ أعتقد ان هذه هي صلاتي: أن أؤمن بإمكانية التغيير. فلو أغلقت نفسي على ذاتي لن يحدث فيّ أي تغيير. لهذا؛ فغالباً ما يبدو الأمر وكأنه تعلم السلوك والتكيف مع البيئة كما يقول العلماء. كيف أمنحك الفرصة لتغيير طبيعتي من الداخل، وتجعلني أشبهك؟ هل هذا ممكن؟
من السهل عليّ أن أؤمن بالمستحيل، وبعبور البحر الأحمر، وبالقيامة، ذلك عن أن اؤمن، فيما يبدون أنه ممكن، بإشراق حياتك البطيء والثابت على أناس مثلي، ومثل جانيت، وديف، وماري، وبول. يا الله ساعدني لكي أؤمن بما هو ممكن”.
أذكر كيف اندهش جداً صديقي بول عند مطالعته لرسالتي تلك مع باقي المجموعة. وقال: يبدو أنه خطاب غير شخصي، بعيد ومؤقت. فما وصفته لا يتماشى مطلقاً مع شعوره بقرب الله منه. وعندما أحاول أن أتذكر رد فعله تثور شكوكي، وأتساءل: ما الذي يؤهلني لكي أكتب كتاباً باحثاً فيه علاقة شخصية مع الله. طلب مني أحد الناشرين كتاباً رعوياً، ولكنني لم أتمكن من كتابته، فأنا لست راعياً، بل سائح ورحالة يملأه الشك. ويمكنني فقط أن أقدم رحلة شخصية وفردية تعكس ما وصفه فردريك بوشنر على أنه “الشخص الذي يسير في طريقه وليس بالضرورة أن يكون قد سار لمسافة طويلة وفي ذهنه فكرة غامضة عمن يقدم له الشكر”.
لقد عشت معظم حياتي طبقاً للتقليد البروتستانتي الذي يؤكد على العلاقة الشخصية مع الله، وأخيراً قررت أن أكتب هذا الكتاب لأنني أريد أن أعرف بنفسي كيف تسير علاقتنا مع الله بطريقة صحيحة. وموقف التقليد الإنجيلي – شخص يبحث عن الله بمفرده، بدون وساطة رعاة، أو أيقونات، أو أي وسطاء آخرين – يناسب بصورة خاصة مزاج الكاتب. ورغم ذلك؛ فقد أستعين ببعض المراجع وأجلس مع بعض الحكماء، ولكن في النهاية أكتب أفكاري أنا، التي أؤمن بها. وهذا يشعرني بنوع من المخاطرة، لأن الحياة المسيحية لا تعني بأن يحياها شخص جالس بمفرده طوال اليوم متفكراً في الحياة المسيحية.
عندما أبدأ في كتابة أي كتاب آخذ المنجل وأبدأ في شق طريقي عبر الغابة، ليس لكي أعبد طريقاً للآخرين، ولكن لكي أجد طريقاً لي. هي سيتبعني أي شخص آخر؟ هل ضللت الطريق؟ فعندما أشرع في الكتابة فهذا يعني إنني لا أعرف إجابة محددة لتلك الأسئلة ولكنني أواصل استخدام المنجل.
فالصورة غير واضحة تماماً، لذا فعندما أشق طريقي أتبع خريطة وضعها آخرون من قبلي وهم “سحابة الشهود”. ونضالي في حياة الإيمان يعترف لهم بهذ الخدمة: لقد اجتازوا طريقاً طويلاً ومتميزاً من قبلي. وأجد نفس تعبيرات الشك والحيرة في الكتاب المقدس ذاته. فقد اتهم سجموند فرويد الكنيسة بأنها تُعلم أسئلة يمكن الإجابة عليها. وبعض الكنائس قد تفعل هذا، ولكن الله بالتأكيد لا يفعل ذلك. ففي سفر أيوب، وأخبار الأيام، وحبقوق، يطرح الكتاب المقدس أسئلة صعبة، ليس لها إجابة.
أثناء بحثي وجدت أن عظماء القديسين واجهوا الكثير من العقبات في الطريق، والمنعطفات، وطرق مغلقة، وهي تلك التي اختبرتها انا والتي عبّرت عنها بالخطابات التي وصلتني. وتتجه الكنائس الحديثة إلى إظهار بعض الشهادات لنجاحات روحية، ولا تتطرق إلى الفشل الذي قد يقود المجربين إلى حالة أسوء. وكذلك نجد أن الكتب والشرائط المسجلة (الكاسيت/ الفيديو) تركز على الانتصارات. ورغم ذلك؛ فإنها تحفر بعمق في تاريخ الكنيسة وسوف تجد قصة أخرى مختلفة عن أولئك الذين حاولوا أن يسبحوا ضد التيار، مثل سمك السلمون الأبيض.
يصف لنا القديس أوغسطينوس في اعترافاته، وفي تفاصيل دقيقة، يقظته البطيئة قائلاً: “كنت أود أن أتأكد من الأشياء التي لا أرها بنفس درجة تأكدي من أن 7 + 3 = 10”. ولكنه لم يصل إلى هذه الدرجة من التأكد. هذا العَالِم الذي عاش حياته في شمال أفريقيا في القرن الرابع الميلادي، رضيّ واقتنع بنفس القضايا التي تزعج المسيحيين اليوم: الإيمان لا يمكن رؤيته، وهزيمة الشك المستمر والمزعج للكنيسة.
في كتاب “السر المسيحي للحياة السعيدة” شجعت الكاتبة “حنة هويتال سميث” ملايين القراء، فترة حكم الملكة فيكتوريا، على أن يحيوا حياة روحية مرتفعة، ولكنها هي نفسها لم تجد السعادة مع أسرتها. فزوجها الذي كان إنجيلياً مشهوراً، قد اخترع معادلة جديدة للاستمتاع والنشوة التي تُشبع الاشتياقات الروحية عن طريق الاستثارة الجنسية. وفيما بعد انحرف إلى طريق الزنا وأنكر الإيمان. وظلت زوجته “حنة” معه، بينما هجر كل أبنائها الإيمان. فإحدى بناتها تزوجت الفيلسوف “برتراند راسل” وأصبحت ملحدة كزوجها. وقد وصف راسل حماته بأوصاف كثيرة، ولكنه لم يذكر أنها كانت مؤمنة منتصرة.
حضر المؤلف المعاصر “إيوجين بترسون” وهو في فترة المراهقة مؤتمراً دينياً، حيث كان الناس يلتقون كل صيف على ضفاف بحيرة. وكانت لهم قوة روحية ملتهبة، واستخدموا عبارات مثل: “الحياة العميقة”، و”البركة الثانية”. وعندما راقب بترسون حياة هؤلاء الناس لاحظ نوعاً من الاستمرارية بين روحانيتهم الشديدة في المؤتمر، وحياتهم اليومية في المدينة. “فأمهات أصدقاؤنا اللاتي كن زناة قبل الإيمان، واستمروا كذلك. ومدرس التاريخ بلنجتون الذي كان يتمتع بالاحترام في المؤتمر لم يتخل عما كان يفعله من تصرفات وضيعة في المدرسة الثانوية، بل أنه كان أسوء من باقي المدرسين.
لا أذكر هذا النوع من الفشل ليك أثبط من إيمان أي شخص، ولكن لكي أضيف جرعة من الواقعية للدعاية الروحية التي تعد بأكثر مما يمكنها أن تعطي. إن فشل الكنيسة يثبت العقيدة التي نؤمن بها. فالنعمة كالمياه، تجري إلى الأعماق، ونحن في الكنيسة لدينا الاتضاع والندم، لنقدمه للعالم، وليس وصفة نجاح. غالباً ما نصرّح في مجتمعاتنا الناجحة شكلياً، أننا فشلنا ونفشل، وسنفشل. والكنيسة في عام 3000 سوف يكون لديها نفس مشكلات عام 2000، أو تلك التي كانت عام 1000، ولهذا فنحن نعود إلى الله بيأس مفرط.
يقول س. إس. لويس: “إن للمسيحي امتياز عظيماً يميزه عن باقي الناس، ليس لأن لديه سقطات أقل، بل لأنه يعلم أنه إنسان ساقط في عالم ساقط”.
عندما بدأت كتابي هذه، ذهبت إلى بعض الأصدقاء الذين أحترمهم كمسيحيين. بعضهم قادة في كنائسهم، وقلة منهم لهم شهرة قومية. وآخرون مواطنون عاديون في هذا العالم وهم متمسكون بإيمانهم. وسألت هذا السؤال: “إذا جاءك باحث وسألك كيف أن حياتك كمؤمن/ كمؤمنة تختلف عن حياة الآخرين غير المؤمنين… ماذا تكون إجابتك؟ وأردت أن أسمع ما إذا كان إيمانهم قد لهم شيئاً ما غير الفشل في تحقيق الأحلام، وربما بعض الأمل في التغيير إن لم يحدث ذلك، فلماذا إذاً أهتم بهذا؟
بعض الناس ذكروا تغييرات محددة. قال أحدهم: “بسبب معرفتي بالرب لم ينهار زواجي، بالرغم من المشاكل الكثيرة التي لم تُحل”. وقال آخر: “لقد تأثر استخدامي للمال أيضاً.. فبحثت عن طرق لمساعدة الفقراء بدلاً من التفكير في رغباتي الذاتية فقط”.
وتحدثت امرأة كانت قد اجتازت عملية جراحية في الصدر، تحدثت قائلة عن قلقها: “لم أتمكن من التوقف لاستئصال الورم السرطاني، وانزعج الآن على أولادي الذي ضلوا الطريق. إنني أعلم أنه لا فائدة من هذا القلق ولكنه يحدث لي. أنا أعلم أنه يوجد لديّ نوع من الثقة في الله، ورغم ذلك فقد تبدو خادعة وأؤمن أيماناً عميقاً أن الله مسيطر على الموقف. البعض يُسمي هذا النوع دعامة أو عكازاً، وأنا أسميه الإيمان. فبالنسبة للشخص الأعرج هناك شيء واحد أسوء من العكاز وهو أن يسير بدون عكاز”.
درجة أخرى من درجات الإحساس بحضور الله هي الإحساس بأنك لست وحدك: “عليّ أن أميل أذني لأسمع الله يتحدث، أحياناً يتحدث أفضل في السكون، ولكنه يتحدث”. قال أحدهم أنه يستطيع أن يكتشف التقدم الروحي بالنظر إلى الوراء”. أعرف ما إذا كانت النار قد شبّت في منزلي، فسوف أندفع لإنقاذ مذكراتي اليومية. إنها من أعظم ممتلكاتي، وهي سجل لعلاقتي مع الله. لقد كانت هناك بعض اللحظات الدرامية ولكن كان هناك أيضاً الكثير من اللحظات الحميمية معه. وعندما أقرأ الآن هذه المذكرات لاستعادة الأحداث الماضية، يمكنني أن أرى يد الله في حياتي”.
وصفت ممرضة كانت تعمل في نزل للمسافرين، وصفت نتائج الإيمان التي تكون واضحة بالقرب من سرير المريض الذي يكون قد مات: “إنني أرى فرقاً في كيفية تعامل الأسر المؤمنة مع الموت. بالطبع هم يحزنون، ويبكون، ولكنهم يعانقون بعضهم بعضاً، ويصلون ويرنمون، إنهم غير مرتعبين. أما بالنسبة لغير المؤمنين، فالموت هو نهاية كل شيء، إنهم يقفون معاً، ويتحدثون عن الماضي. أما المؤمنون فإنهم يذكرون بعضهم بعضاً بأنه يوجد مستقبل ينتظرهم”.
لربما كانت أكثر الاستجابات تأثيراً من صديق اسمه معروف في الأوساط المسيحية. إنه مسؤول عن برنامج إذاعي، ويُعطي النصائح الكتابية كل أسبوع، ومع ذلك فقد اهتز إيمانه في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد مرض كاد أن يقضي عليه. وفي البرنامج الإذاعي بدأ يجيب على الأسئلة بصوت مرتفع متقطع، كما لو أنه يجيب على المستمع على الهواء مباشرة. ورغم ذلك، ففي هذه المرة فكر لبعض الوقت قبل أن يجيب، ثم قال لي:
ليست لديّ مشكلة في أنني أؤمن بصلاح الله. وسؤالي هو: أي صلاح هو؟ لقد سمعت منذ فترة أن ابنة “بيللي جراهام” كانت تجتاز في بعض المشكلات الزوجية، ولهذا سافرت عائلة بيللي جراهام إلى أوروبا لكي تلتقي معهم وتصلي من أجل الزوجين. وانتهى الأمر بالطلاق. فإذا كانت صلاة بيللي جراهام لم تُستجب فما فائدة صلاتي أنا؟ وأنظر لحياتي… مشكلاتي الصحية، وخلافات بناتي، وزواجي. إنني أصرخ إلى الله طلباً للمعونة، ويصعب عليّ معرفة الطريقة التي يجيبني بها، وفي الحقيقة، كيف إذاً نعتمد على الله؟
صدمني السؤال الأخير، وكأنه رصاصة قد استقرت بداخلي. أعرف لاهوتيين سوف يندهشون من هذه العبارة، ويعتبرونها علامة عن الإيمان المرتكز على الذات. ومع ذلك؛ فإنني أثق أنها تقع في قلب التحرر من الوهم مع الله. ففي كل علاقاتنا الشخصية – مع والدينا وأطفالنا، وأمناء المخازن، وعمال الغاز، والرعاة، والجيران – لدينا فكرة عما نتوقعه. ماذا عن الله؟ ماذا يمكننا أن نجني من علاقتنا الشخصية معه؟
كان شريك غرفتي لمدة عامين في الكلية المسيحية ألمانياً يُدعى رينر Reiner، وبعد التخرج عاد إلى ألمانيا وقام بمهمة التعليم في معسكر للمعاقين، مستعيناً بما تعلمه في الكلية، وألقى عليهم محاضرة حماسية عن الحياة المسيحية المنتصرة قائلاً: “وبالرغم من الكرسي المتحرك الذي تجلس عليه، فيمكنك أن تتمتع بحياة الانتصار. فالله يعيش بداخلك”. قال هذا لمستمعيه من المشلولين، والمعاقين ذهنياً. ووجد أن هذا أمر محبط بالنسبة لهم. فرؤوسهم كانت ترتعش والبعض سقط عن كرسيه، وكان لعابهم يزبد.
ووجد هؤلاء الشباب أن الاستماع لـ راينر أحبطهم، فذهب البعض منهم إلى “جراند” مدير المعسكر، واشتكوا من عدم قدرتهم على فهم ما يقوله لهم راينر، فطلب منهم المدير أن يبلغوا راينر بذلك.
إحدى السيدات استجمعت شجاعتها وواجهت راينر، وقالت له: “إنك تشبه من يتكلم عن الشمس، ونحن في غرفة مظلمة، ليست بها نوافذ. لا نستطيع أن نفهم أي شيء مما تقوله. لقد تحدثت عن الحلول وعن الأزهار بالخارج، وعن النصرة، وهذه أمور لا تتناسب مع حياتنا”.
انسحق صديقي راينر إذ كانت الرسالة واضحة للغاية بالنسبة له، لقد كان يقتبس مباشرة من رسائل بولس… أليس كذلك؟ وجُرحت كبرياؤه، لقد فكر أن يأتي إليهم بعصا روحية: هناك خطأ في حياتكم وتحتاجون لأن تنمو في الرب وتنتصروا على محنتكم.
|
المفاهيم تَخْلُق الأصنام، فقط الذي يتمنى أن يعرف يفهم أي شيء. غريغوريوس النيصي |
وبعد ليلة قضاها راينر في الصلاة عاد إليهم برسالة مختلفة وقال لهم في الصباح التالي: “أن لا أعرف ماذا أقول. إنني مرتبك، وبدون رسالة الانتصار لا أعرف ماذا أقول” وظل صامتاً.
فإذا بالمرأة التي واجهته تتحدث من الغرفة المملوءة بالمعاقين قائلة: “الآن قد فهمناك، وعلى استعداد لأن نسمعك”.