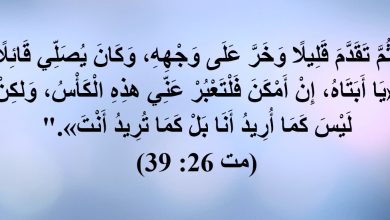كيف وصل لنا العهد الجديد من القرن الأول إلى الآن؟ | فادى اليكساندر
فادى اليكساندر

مقدمة: تاريخ التاريخ
لكى نستطيع تحديد أهم و أفضل المخطوطات، لدينا وسيلتين. الوسيلة الأولى هى البرهان الداخلى، و الثانية هى تاريخ الإنتقال النصى. وسيلة البرهان الداخلى تعتمد على تفعيل البرهان الداخلى فقط على القراءات المتوفرة، و من ثم تحديد القراءة الأصلية عن طريق هذا البرهان فقط دون اللجوء إلى البرهان الخارجى. بعد ذلك، يتم فحص كافة المخطوطات المتوفرة لتحديد أى مخطوطات هى التى أثبتت القراءة التى توصلنا إلى أصوليتها. المخطوطات التى توافقت مع نتائج البرهان الداخلى، هى المخطوطات الأدق و الأفضل. أما الوسيلة الثانية، و هى محاولة تكوين “تاريخ الإنتقال النصى”، فهى وسيلة معقدة بعض الشىء، و لهذا ستكون هى محل هذا البحث.
و أنا دائماً أردد أن المفتاح لفهم علم النقد النصى، هو فهم ما يُسمى بـ “تاريخ الإنتقال النصى”. و ليس من السهل أن نجد تعريفاً واضحاً محدداً لهذا المصطلح فى كتب النقد النصى، فهو مصطلح شائك يتشائك مع تعريفه منهج العالم فى تحرى القراءة الأصلية. و لكن بشكل ما، فإن هذا المُصطلح يُقصد به: محاولة التعرف على الأشكال المختلفة للنص الموجودة فى شواهد النص المتوفرة، و شرح حيثيات ظهورها، بهدف تحديد الشواهد الأكثر موثوقية، و التى على أساسها يتم إعادة تكوين النص الأصلى للعهد الجديد اليونانى. هذا التعريف قد يبدو للوهلة الأولى مُعقداً بعض الشىء، و لكنه التعريف المنهجى[1]. و لكى نعرف المصطلح ببساطة، فهو محاولة تكوين تاريخ دقيق لكيفية انتقال نص العهد الجديد، أى كيفية سير عملية النسخ فى العصور السابقة على عصر الطباعة. الهدف من هذه العملية هو تتبع ظهور القراءات، أسباب ظهورها، كيفية ظهورها، و كيفية انتقالها فى التقليد النصى المتوفر. بهذا الشكل، نستطيع تحديد الشواهد الأكثر عرضةً للخطأ النسخى، و تحديد أقل الشواهد عرضةً للخطأ النسخى، مما يعنى معرفتنا بالشواهد الأكثر موثوقية، و بالتالى يسهل علينا عملية إعادة تكوين النص الأصلى للعهد الجديد اليونانى.
و يمكننا ملاحظة الوجود النظرى لمفهوم “تاريخ الإنتقال النصى” عند إيرازموس، ففى الحقيقة ايرازموس كان ناقداً نصياً. و لكن الآليات و الإمكانيات حالت بينه و بين التطبيق العملى، ذلك لأن العصر الذى عاش فيه إيرازموس لم يساعده كثيراً، و هو العصر الذى شهد اختراع الطباعة على يد جوتنبرج.
لكن البداية الحقيقية لترسيخ مفهوم تاريخ الإنتقال النصى، يبدأ فى حقيقته عملياً مع ظهور بينجل. ففى الحقيقة، بينجل هو المؤسس الحقيقى للنقد النصى، و لأنه أرسى مفهوم الإنتقال النصى، استحق بجدارة لقب الأب الروحى لهذا العلم. فما قام به بينجل بالفعل، هو تقسيم المخطوطات إلى مجموعات بحسب إتفاقها أو إختلافها. و لعل ما يلفت الإنتباه فى هذا هو كيف أن اللقب التصق به، فقط لأنه أرسى فكرة الإنتقال النصى و البحث فى تاريخه، و كأن النقد النصى هو تاريخ الإنتقال النصى، مما يؤكد ما قلته فى البداية؛ فأهم ما فى النقد النصى هو تاريخ الإنتقال النصى. هذا يذكرنا بمقولة هورت الشهيرة:”معرفة الوثائق يجب أن تسبق الحكم الأخير”[2]. فلكى تحكم على أية قراءة هى الأصلية، لابد أن يكون لديك معرفة كافية و وافية بالوثائق، أى بالمخطوطات. و بهذا الشكل يستطيع الناقد النصى تطوير الآلية أو المنهجية التى سيتبعها فى بناء نص العهد الجديد اليونانى.
ما قام به بينجل كان بمثابة فتح الباب أمام الكثير من العلماء فى القرون التالية، فقد وضع بينجل الأساس الذى يجب أن نبنى عليه، و هو ضرورة وجود تاريخ لكيفية إنتقال نص العهد الجديد أثناء عملية النسخ حتى وصل إلينا فى الشواهد المتوفرة. و كان من بين أهم العلماء الذين قدموا الكثير من الأعمال و المساهمات الحقيقية و الفعالة فى هذا المضمار، العالم سيملر و تلميذه جريسباغ. بينجل و جريسباغ خاصةً، قاموا بتطويرات هامة فى نقطة تقسيم المخطوطات إلى مجموعات بحسب نقاط الإتفاق و الإختلاف. و من بعدهما، و مع مطلع القرن التاسع عشر، جاء العالم لاشمان الذى إنشغل بناحية أخرى فى بناء تاريخ الإنتقال النصى. كان عمل لاشمان يرتكز بشكل رئيسى على محاولة بناء شجرة عائلة للمخطوطات المتوفرة، و هو المنهج الذى تسمى فيما بعد بإسم “المنهج النَسبى”، أى الذى يبحث فى محاولة بناء علاقة تناسبية بين المخطوطات. و لاشمان كان يعرف و يدرك جيداً، أن ما يقوم به هو مجرد عمل نظرى فقط، يستحيل أن ينتقل إلى واقع. و لندرك أهمية تكوين شجرة العائلة فى نظر لاشمان، نحتاج أن نفهم الهدف من وراءها. تكوين شجرة العائلة يعنى أننا سنضع كل مخطوطة فى مكانها، و بالتالى كل قراءة فى مكانها، مما سيمكننا من معرفة أى قراءة سبقت الأخرى. هذا يعنى أننا سنصل فى مرحلة معينة إلى القراءة الأصلية!
و بالرغم من أن إمكانية تكوين شجرة عائلة للتقليد النصى بالكامل هى شبه مستحيلة بالفعل، إلا أن ذلك لم يمنع العلماء من تبنيها و محاولة بناءها. غير أن التفكير فيها بشكل تفصيلى، تأجل بعض الشىء مع نهاية القرن التاسع عشر، حينما جاء عمودى النقد النصى الحديث، ويستكوت و هورت. نجح هذين الإثنين فى دمج فرعى تاريخ الإنتقال النصى معاً: المجموعات و شجرة العائلة. أستطاع ويستكوت و هورت ببراعة، أن يقدما قاعدة منطقية فى كيفية عمل النقد النصى. فعملهما فى تقسيم المجموعات، ساعدهما جداً فى بناء شجرة عائلة للمجموعات، و ليس للمخطوطات!
لكى نفهم كيفية عمل كل هؤلاء العلماء بشكل صحيح، يجب أن نعرف أن النص السائد فى ذلك الزمان كان شىء ما يُسمى “النص المُستلم”. النص المُستلم هو إسم عدة إصدارات من العهد الجديد، و رغم أن هذا الإسم أُطلِق على إصدار تلى عصر إيرازموس، إلا أن الإسم أصبح ملتصقاً بإيرازموس جداً. فما فعله إيرازموس، هو أنه أستطاع الوصول إلى ستة مخطوطات، أقدمهم يرجع للقرن الحادى عشر، لكى يقوم بتحرير طبعته الأولى للعهد الجديد اليونانى. هذه المخطوطات نُسِخت فى عصر كان فيه نص قياسى بشكل ما. و بالتالى، جاءت هذه المخطوطات ممثلة لنوعية من النصوص تُسمى “النص البيزنطى” حالياً. لم يكن الإختلاف بينهم و بين بقية مخطوطات هذا النص كبيرة جداً، لذلك أُعتُبِر نص إيرازموس هو النص المُستلم. و قد إستمر النص المُستلم فى الوجود حتى عام 1831 حينما قام لاشمان بتجاهله تماماً، و أصدر طبعة نقدية بعيدة كل البعد عن النص المُستلم.
لقد قلنا أن العلماء نجحوا فى تقسيم المخطوطات إلى مجموعات بحسب نقاط الإتفاق و الإختلاف، و هذه المجموعات هى أربعة مجموعات فى عصرنا الحالى:
· النص السكندرى: و أهم شواهده السينائية، الفاتيكانية، البردية 66، البردية 75، بجانب الترجمة القبطية و ترجمات أخرى، مع الآباء السكندريين.
· النص البيزنطى: و يمثله غالبية مخطوطات العهد الجديد، و أول ظهور له فى المخطوطة السكندرية فى الأناجيل الأربعة فقط، بجانب الترجمات المتأخرة، و الآباء الكبادوكيين.
· النص الغربى: و أهم شواهده المخطوطة بيزا و اللاتينية القديمة و الفلجاتا و بعض الترجمات السيريانية، بجانب الآباء الغربيين.
· النص القيصرى: و تمثله عائلتين من المخطوطات هما العائلة الأولى و العائلة الثالثة عشر و بعض المخطوطات الأخرى. أهم شواهده من الآباء هما أوريجانيوس و كيرلس الأورشاليمى.
غير أن هذا التقسيم لم يبدأ فى الظهور كما هو هكذا، بل إحتاج إلى دراسات و أبحاث متعمقة جداً حتى يبدأ فى الظهور. و هذا هو ما عمل عليه العلماء بدايةً من بنجل، مروراً بجريسباغ، حتى نصل إلى ذروة الدراسات فيه عند ويستكوت و هورت. كانت مسألة النص البيزنطى هى المشكلة الرئيسية عند ويستكوت و هورت. فالفكر السائد فى هذا العصر كان أن النص المُستلم هو النص الأصلى. لم يقتنع ويستكوت و هورت بذلك، و أدركا أهمية تكوين تاريخ إنتقال نص العهد الجديد، حتى يستطيعا تكوين النص الأصلى. لعل العامل الأكثر إستفزازاً لهما، هو وجود الإصرار على أصولية قراءات معينة موجودة فى مخطوطات متأخرة، و لكنها لم تكن موجودة فى المخطوطات الأقدم.
لحسن حظهما، فقد شهد عصرهما إكتشافات كبيرة جداً، خاصةً فى وجود عمل تشيندورف الدؤوب. إكتشاف المخطوطة السينائية كان مساعداً لهما جداً فى تكوين نظريتهما. كما أن إستطاعة تشيندورف نشر المخطوطة الفاتيكانية لأول مرة بعد إكتشافها بخمسة قرون كاملة، وفر لهما الكثير من البيانات المطلوبة. و بعد ويستكوت و هورت، لم يكن هناك ما يشغل علماء النقد النصى فى النصف الأول من القرن العشرين سوى تكوين تاريخ الإنتقال النصى. و لكن مع حلول منتصف القرن العشرين، أُهمِل العمل قليلاً فى تاريخ الإنتقال النصى، لأجل العمل المضنى فى المنهجيات. إهتم العلماء فى هذه الفترة بمنهج النقد النصى، حتى يستطيعوا تكوين النص الأصلى. ثم فى العقود الأخيرة من القرن العشرين، بدأ الإهتمام بتكوين تاريخ الإنتقال النصى مرة أخرى. العالمين بويسمارد و لامويلى وضعا نظرية تاريخ الإنتقال النصى لأعمال الرسل، و معهد البحث النصى للعهد الجديد أسس نظرية الفساد المتماسك، و عمل إيب و كويستر على برديات القرن الثانى للوصول إلى طبيعة النص فى هذا القرن، و عمل أمفوكس و فاجانى فى تطوير نظرية أولية النص الغربى، و عمل كارول أوسبورن فى المشروع العالمى لنص أعمال الرسل، و عمل هودجز و فارستاد فى نظرية نص الأغلبية. كل هذه النظريات تتعلق بشكل أو بآخر بشكل رئيسى بعمل ويستكوت و هورت فى تقسيم المخطوطات إلى مجموعات، أو النصوص المحلية. هذه النظريات الكثيرة المتوفرة على الساحة الآن، و التى تتعرض لكل نوع نص بشكل أو بآخر، هى هدف هذه الدراسة.
هناك بعض الأسئلة التى تحتم علينا أن نبحث عن إجابتها: ما الذى تم تحقيقه فى بناء تاريخ لإنتقال نص العهد الجديد؟ ما هى المساهمات التى قدمها تاريخ الإنتقال النصى للنقد النصى للعهد الجديد؟ كيف يجب أن نفهم أدوار كل نص محلى فى عملية تكوين النص الأصلى؟ ما هى المشكلات و العقبات الموجودة أمام نُقاد النص الآن؟ و بالأكثر، هل يسمح لنا تاريخ الإنتقال النصى بتكوين النص الأصلى؟ هذه الاسئلة هى محل إهتمام هذه الدراسة.
ما قبل النصوص المحلية
نعلم أن النص الأصلى لبعض أجزاء العهد الجديد، وهى رسائل لبولس، إستمر فى الوجود حتى أواخر القرن الثانى. لم ترد إلينا أخبار أخرى عن بقية نصوص العهد الجديد، و لكن المُرجح بالأكثر أن المسيحيين قد إحتفظوا بها لفترة معينة، و ذلك واضح من وجود قرينة السعى للحفاظ على الأصول كما يرد الخبر عند ترتيليان و غيره. فإذا كانت الأصول قد حُفِظت حتى أواخر القرن الثانى، فالمرجح بالأكثر هو عمل نسخ عنها الكثير من المرات. هذه النقطة فى غاية الخطورة لسبب واحد: لو أن الأصول نُسِخ عنها نسخة واحدة فقط، فإن هذا يعنى أن هناك مكان ما فى العهد الجديد، لم تتوفر القراءة الأصلية له فى التقليد النصى المتوفر. لكن المرجح أكثر هو النسخ المتكرر عن الأصول، مما يعنى إنتهاء دور العناية الإلهية بالحفاظ على القراءة الأصلية فى التقليد النصى المتوفر، و يأتى دور الناقد النصى فى تحديدها.
النُسخ التى تمت عن النص الأصلى، بالتأكيد إحتوت على أخطاء عديدة، و لكن فى هذه المرحلة لا يمكننا تخيل وجود قراءات تتعدى مرحلة العفوية. ففى هذه المرحلة كانت عملية النسخ بدائية جداً، كان الشغل الشاغل هو التعرف على النص فقط، الإطلاع عليه، قراءته، فهمه، و محاولة تطبيقه. هذه المرحلة البدائية لا يمكن أن نرى فيها أثراً لوجود قراءات تتعدى الخطأ العفوى أثناء عملية النسخ. يبرز هذا الإحتجاج بأكثر قوة، حينما ندرك الروح التى سيطرت على مسيحية القرن الأول. لا نرى أثراً لأى فكر هرطوقى فى القرن الأول، ولا نرى حوارات لاهوتية، ولا نرى خلافات حول طبيعة و هدف المسيحية. على جانب آخر، من الوارد جداً وقوع الأخطاء النسخية العفوية حتى فى النسخ الأصلية نفسها. نحن نعرف أن بولس كان يقوم بإملاء بعض الكتبة ليكتبوا بعض رسائله. هل يمكن أن يكون الكاتب الذى يمليه بولس يكون قد وقع فى خطأ نسخى؟ نعم، هذا الإحتمال وارد. فى هذه الحالة، أى نص هو المُراد تكوينه بالضبط؟ النص الذى نطقه بولس أم النص الذى كتبه الكاتب؟ لا يقدم لنا العلماء إجابة، و لكن هذا الإحتمال يمكن تخيله فقط إذا كنا قادرين على تحديد ما يُشير إلى وقوع خطأ نسخى جعل القراءة الأصلية تحتوى على خطأ نسخى. هذا الخيار و إن كان إحتمال نظرى وارد، لكنه غير وارد فى الواقع العملى على الإطلاق، مما يجعلنا لا نحتاج للإهتمام به بإفراط.
السؤال عن طبيعة النص الأصلى فى تاريخ الإنتقال النصى، جعل ميتزجر و ايرمان يقولا:”الموقف أكثر تعقيداً فى الأناجيل خاصةً، لأنهم متأسسين على تقاليد شفهية و مصادر مكتوبة لا نستطيع الوصول لها الآن بشكل إستقلالى. مثلاً، ما معنى إعادة تكوين النسخة الأصلية لإنجيل يوحنا؟ هل على الناقد النصى أن يُعيد تكوين أقدم نسخة و التى لا تحتوى على الإصحاح الواحد و العشرين؟ من غير المحتمل ذلك، لأن كل مخطوطاتنا اليونانية الكاملة تحتوى على هذا الإصحاح. إذن، هل نقصد إعادة تكوين الإصدار الأخير من الإنجيل و الذى يحتوى على هذا الإصحاح؟ إذا كان كذلك، هل علينا أن نعتبر قصة المرأة التى أُمسِكت فى زنا (يو 7 : 53 – 8 : 11) جزء من الإصدار الأخير أم أن هذه القصة قد أُضِيفت متأخراً جداً حتى تُعتبر أصلية؟”[3]. إن المشكلة الرئيسية فى هذه التساؤلات هى: فى أى وقت نستطيع أن نقول أن الوقت أصبح متأخراً جداً؟ أو كما وضعها أحدهم: متى يكون متأخراً جداً؟[4]
أحد أهم النظريات التى خرجت حول تاريخ انتقال النص فى مرحلة ما قبل النصوص المحلية، هى نظرية “النص الأولى”، و التى تقول بأن ما نستطيع تكوينه هو النص الذى منه ينحدر التقليد النصى المتوفر. السؤال هو هل النص الذى ينحدر منه التقليد النصى المتوفر هو النص الأصلى أم نص يختلف عنه؟ معهد البحث النصى للعهد الجديد يخبرنا حول هذه النظرية التالى:
“النص الأصلى للعهد الجديد لم يتوفر فى أى مخطوطة. كل المخطوطات تحتوى على قراءات تطورت خلاص التاريخ النصى فى عملية النسخ المستمرة. النص الأولي للتقليد (النصى) هو النص الذى يسبق عملية النسخ. و لأن هذا النص لم يتوفر فى أى مخطوطة، فيجب، على الجانب الأول، أن يتم إعادة تكوينه على أساس شواهد النص المتوفرة و الصورة الكاملة للتاريخ النصى التى نتجت عنه، و على الجانب الآخر على أساس ميزة كل ما يمكن معرفته حول هدف المؤلف. و هذا يؤدى إلى فرضية النص الأولي. بين نص المؤلف (أى النص الأصلى) و النص الأولي، قد يكون هناك تطورات لم تترك أثراً واحداً فى المخطوطات المتوفرة. و لهذا فالنص الأولي للتقليد (النصى) ليس بالضرورة متطابقاً مع نص المؤلف. و لكن، طالما أنه لا يوجد أى أسباب جوهرية تحتج عكس ذلك، فإن الفرضية العاملة الأبسط هى أن النص الأولى يتوافق بضخامة مع نص المؤلف، بجانب قراءات صغيرة كان يجب أن يتم التعامل معها أثناء عملية النسخ”[5].
و بالتالى، فإننا لا نستطيع أن نفترض وجود أكثر من القراءات العفوية فى مرحلة ما قبل النص الاولى، لأنه لا يوجد سبب واحد يجعلنا نفكر فى ذلك. الإحتمالات النظرية كلها واردة، و لكن الدراسة العملية الواقعية، لا تقول بأنه هناك ما يجعلنا وجود أكثر من الأخطاء النسخية العفوية فى المرحلة المباشرة بعد نشر النص الأصلى مباشرةً.
النصوص المحلية
بما أن نسخ المخطوطات باليد يعنى إستحداث أخطاء و قراءات فى المخطوطات، فإن هذه المخطوطات بدأت فى الإختلاف و الإتفاق حول مواضع معينة مع زيادة النسخ مرة تلو الأخرى. هذا الإختلاف و الإتفاق تم عن طريق تأثر المخطوطات ببعضها البعض فى المجتمعات المسيحية. و هذا الإختلاف و الإتفاق لم يكن شىء عشوائى، فأنتج مجموعات أو عائلات من المخطوطات، كل عائلة تتسم مخطوطاتها بالقرب الشديد فى مواضع الإتفاق و الإختلاف. هذه المجموعات تُسمى “أنواع النصوص” أو “النصوص المحلية”. و نشأة هذه النصوص المحلية يمكننا تشبيهها بالمثال التالى:
دعونا نفترض أن هناك أربعة نسخ تم عملهم عن النسخة الأصلية. هذه النُسخ تحتوى بداخلها على أخطاء. لكن الخطأ الموجود فى النسخة الأولى، لن يكون هو الخطأ الموجود فى بقية النسخ. كلما يتم عمل نسخ عن كل نسخة من الأربعة، ستحتفظ النسخ بخصائص النسخة التى تمت عنها النساخة من بين الأربعة. فلو أننا لدينا عشرة نُسخ نُسِخت عن النُسخة الأولى، و عشرة نُسخ نُسِخت عن الثانية، فإن العشرة نُسخ الأولى سيكونوا أقرب لبعضهم من العشرة نُسخ الأخرى. بهذا الشكل أصبح كل عشرة نُسخ هم عائلة. كل النسخ تحتوى على النص الأساسى، نفس النص بشكل عام، و لكن هناك أخطاء معينة خاصة بكل عائلة منهم. بالإضافة إلى ذلك، بداخل كل عشرة مخطوطات، قد نجد ثلاثة مخطوطات قريبين لبعض لدرجة أكبر من بقية المجموعة. هذا المثال هو نموذج مُصغر و مُبسط جداً للنصوص المحلية[6].
و رغم أننا غير واثقين من بعض التفاصيل، و لكن من الواضح جداً أنه فى تاريخ قديم جداً، تم إنتشار نسخ كثيرة من نص العهد الجديد فى فلسطين، الإسكندرية، و روما. و فى كل مكان من هذه المجتمعات، تم عمل نسخ كثيرة عن النسخ التى توفرت فى كل مكان منهم. النسخ السكندرية كانت تحتوى على نفس النص الأساسى مثل النسخ الرومانية، و لكن كل منهما يحتوى على خصائصه المتمايزة عن الآخر (طبق الآن المثال المعروض بالأعلى على النصوص المحلية).
نتيجة لهذا، تكون لدينا أربعة نصوص محلية، أو أربعة أنواع من النص، أو أربعة أشكال من النص، و هى: النص السكندرى، النص الغربى، النص البيزنطى، و النص القيصرى. النص السكندرى نسبة للإسكندرية، النص الغربى نسبة لروما و شمال أفريقيا، النص البيزنطى نسبة إلى بيزنطة و هى القسطنطينية فيما بعد، و النص القيصرى نسبة إلى قيصرية فى فلسطين. و لكن هناك خلاف بين العلماء حول حقيقة وجود النص القيصرى كنص محلى قائم بذاته.
النص البيزنطى
النص البيزنطى هو النص الذى نشأ فى القسطنطينية، و تحديداً فى القرن الرابع، و هو متوفر فى الغالبية العظمى للمخطوطات اليونانية. له العديد من الأسماء مثل: النص السيريانى (بحسب ويستكوت و هورت)، النص الكوينى (بحسب فون سودين)، النص الكنسى (بحسب كيرسوب ليك)، و النص الأنطاكى (بحسب روبز)[7]. و يقول غالبية العلماء أن هذا النص هو نص متدنى فى جودته و موثوقيته، نظراً لأنه نشأ فى القرن الرابع. قال ويستكوت و هورت أن هذا النص هو نتيجة تنقيح نقدى تم على يد لوسيان فى القرن الرابع، و لكن هذا الإحتجاج لم يعد مقبولاً بين العلماء الآن، فيقول ميتزجر و ايرمان:”تكشف الدراسات الحديثة للنص البيزنطى أنه موجود بشكل بدائى فى القرن الرابع فى كتابات آباء الكنيسة مثل باسيليوس الكبير و ذهبى الفم، و لكن شكله نهائى يمثل تقليد متطور بطىء، ليس النص الذى ظهر مرة واحدة فى وقت ما و مكان ما. بكلمات أخرى، لم يكن تنقيح نقدى نصى أُختُلِق عن طريق شخص واحد أو مجتمع واحد”[8].
و بشكل عام، لم يتغير الموقف العام الذى أسسه ويستكوت و هورت بأن موقف النص البيزنطى ضعيف جداً، ماعدا من مجموعة صغيرة من العلماء، مثل: زان هودجز، آرثر فارستاد، ويلبر بيكرينج، و فان بروجين. كل هؤلاء يقودهم إيمانهم حول نص الكتاب المقدس ككلمة الله، و ليس البرهان. و لكن هناك حالة شاذة واحدة، و هى حالة هارى ستورز. فى عام 1984، ظهر كتاب ستورز “نوع النص البيزنطى و النقد النصى للعهد الجديد”. إحتجاج ستورز الرئيسى فى هذا الكتاب هو: وجود قراءات بيزنطية معينة أتفق العلماء على أنها قراءات متأخرة، ثم ظهرت للوجود فجأة فى البرديات القديمة جداً التى أكتشفها العلماء فى القرن العشرين، بما يعنى وجود النص البيزنطى فى القرن الثانى. غير أن ردود العلماء الكثيرة عليه إجتمعت على خط واحد فى الإجابة: النص المحلى ليس قراءة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، بل هو نطاق واسع يجب توفره فى القرن الثانى حتى نستطيع التأكد من وجوده فى القرن الثانى. و كان الإحتجاج الرئيسى للعلماء، أن هذه القراءات تم تغطيتها بيزنطياً، و ليس أنها دليل وجود النص البيزنطى. بمعنى، أن هذه القراءات كانت موجود فى القرن الثانى، و حينما نشأ النص البيزنطى أُختيِرت كقراءة بيزنطية.
هذا لا يعنى أن عمل ستورز لم يكن له أهمية، بل كان له عظيم الفائدة فى تخفيف قسوة نظرية ويستكوت و هورت؛ فقد إعتقدا أن النص البيزنطى لا يحتوى على أى قراءة أصلية على الإطلاق. و قد كان تأثيرهما ممتد على نقاد النص فى زمانهما، و لكن الآن هو:”أمر مقبول عامةً أن القراءة الأصلية قد تكون متوفرة فقط فى النص البيزنطى”[9]. و بشكل عام، لم يتغير موقف العلماء النقديين كثيراً من النص البيزنطى.
النص الغربى
إذا كان النص البيزنطى لا يوجد حوله الكثير من النقاشات، فإن النص الغربى أثار عدة مشكلات. نشأ النص الغربى، بحسب إعتقاد غالبية العلماء، فى القرن الثانى نتيجة ممارسات النسخ. و قد إعتبر ويستكوت و هورت هذا النص أنه نص فاسد، و لكنه يحتوى على القراءة الأصلية. و فى الحقيقة، كان هناك من العلماء من شكك فى وجود حقيقى للنص الغربى، و يذكر ميتزجر و إيرمان فى ذلك:”بعض العلماء شككوا فى وجوده كنوع من النص بسبب أن الشواهد التى توثقه لا تفعل ذلك بتماسك تام، و تفتقد التجانس الذى نجده فى أنواع النصوص الاخرى”[10]. و على العكس من النص البيزنطى، فلا أحد يعتبر النص الغربى تم بترتيب منظم. يقول كرت و بربارا آلاند:”لو نظرنا فى أى مكان فى الغرب، لن نجد عقل لاهوتى واحد لديه القدرة على تطوير على تطوير و تحرير نص غربى مستقل، حتى لو أن الرسالة إلى العبرانيين كُتِبت فى إيطاليا، كما يُقترح، فهى لا توفر متطلبات هذا الشخص. فى الفترة المبكرة لم يكن هناك تقليد نصى فى الغرب غير موجود فى الشرق، لقد كان هناك نص واحد له خصائص فردية تنوعت من مخطوطة لأخرى؛ ففى القرن الثانى لم يكن نص العهد الجديد ثابت بحزم”[11]. و هذا نفس ما يقوله ميتزجر و ايرمان من أن:”غالبية العلماء لا يعتبرونه عملية خلق للنص بواسطة فرد واحد أو عدة أفراد بمراجعة نص أقدم، إنما هو نتيجة نمو غير مُنظم و جامح للتقليد المخطوطى فى القرن الثانى”[12].
و فى كل الأحوال، فإن الرأى الغالب هو أن النص الغربى نشأ فى القرن الثانى، و إستخدمه آباء الكنيسة و الهراطقة أيضاً. غير أن هناك مناظرة قوية حول مدى تأصيل النص الغربى!
يعتمد الإحتجاج الرئيسى لأصالة النص الغربى على محورين هامين:
· محور خارجى: و هو أن النص الغربى نص قديم جداً، نشأ فى القرن الثانى، و به دلائل عدم التحكم بالنص فى هذه الفترة.
· محور داخلى: و هو ينطبق على أعمال الرسل فى النص الغربى، حيث يغلب عليه الطابع اللوقانى أكثر من نص السفر فى بقية النصوص.
و نلاحظ أن كافة المشكلات المتعلقة بالنص الغربى، تتأجج فى قمتها حول نص أعمال الرسل فى هذا النص. فكما ذكرنا فى عدة بحوث سابقة، نص أعمال الرسل فى النص الغربى أكبر من النص التقليدى له بنحو 8.5 % بحسب الإحصائية الدقيقة التى قدمها ميتزجر[13]. و يعتمد المحور الأول على توثيق النص فى غالبية كتابات الآباء المبكرين، بجانب أقدم الترجمات التى كانت بعيدة عن مصر مثل الترجمة السيريانية القديمة و الترجمة اللاتينية القديمة. هذا بالإضافة إلى وجود عدة برديات تنتمى للنص الغربى و كلهم لأعمال الرسل، مثل البردية 29، البردية 38، و البردية 48. و قد قام إيلدون إيب فى الستينات بدراسة أحد المخطوطات القبطية و تأكد أنها تشهد للنص الغربى أيضاً[14].
غير أن المشكلة الرئيسية فى الإدعاء بتأصيل النص الغربى، هى نفس المشكلة التى عرضها ميتزجر، و هى عدم التماسك التجانسى بين شواهد هذا النص. يقول بيتزر عن هذه المشكلة:”أنها حقيقة مُعترف بها بشكل عريض أن النص الغربى يختلف فى شواهده من واحد لآخر، ولا يستطيع الفرد أن يجد نفس الكفاءات و المعالم فى كل شواهده. فالقراءات الواردة فى بعض شواهده، محذوفة من البقية”[15].
و ما لاحظه العلماء أن هذا التشوش الكبير موجود بقوة ليس فى الشواهد الأكثر تأخراً، و إنما فى الشواهد القديمة نفسها، لدرجة أن بربارا آلاند وصفت نمو هذا النص على أنه يبدأ من نطاق واسع يبدأ يتوحد، و ليس نطاق موحد يبدأ فى التفرع! و هذه الظاهرة لم يستطع المعتقدين فى أصالة النص الغربى تفسيرها، و من يقرأ كلام أمفوكس و فاجاناى، ناقدى النص المؤيدين للنص الغربى المشهورين، لا يجد فى إحتجاجتهما تفسيراً تاريخياً نصياً مقبولاً لهذه الظاهرة الحقيقية. أمفوكس مثلاً يرى أن النص المُقدم فى مخطوطة بيزا هو أفضل ممثل للنص الأصلى، فيقول:”فرضية أولية النص الغربى تعنى أن أنه بالرغم من كل الخلاف فى القراءات الموجودة فيه، فإنه هو الممثل للنص كما كان قبل أى تنقيحات نقدية”[16]. و التفسير الذى قدمه أمفوكس هو تفسير نظرى بحت لا دليل واقعى عليه، و هو أن النص الغربى هو نص ما قبل التنقيح النقدى بكل أشكاله، و مع إنتشاره تعرض لأنواع متعددة من التغيير فى ظروف مختلفة، و تنقيحات نقدية، أدت إلى ظهور النص السكندرى و بقية أنواع النصوص[17].
هذه النظرية لا يوجد أى دليل عليها، فيقول بيتزر:”لا يوجد أى دليل صلب تم تقديمه على أن هذه العملية أخذت أى نطاق واسع فى تأثيرها على النص المخطوطى للعهد الجديد، ولا من العلماء القدامى ولا من أمفوكس”[18]. ثم يسميها بيتزر بأنها شىء نظرى جداً، لا وجود عملى له و يحتاج إلى دليل لإثباته.
أما المحور الداخلى، فيعتمد بشكل رئيسى على أن إسلوب أعمال الرسل فى النص الغربى لوقانى أكثر من نص أعمال الرسل فى النص السكندرى، و بناء على ذلك قالوا بأن لوقا نشر إصدارين لكتاب أعمال الرسل. الإصدار الأول هو نص أعمال الرسل بحسب النص الغربى، ثم قام بعد ذلك بعمل نُسخة مصغرة من هذا الإصدار، و هى النسخة الموجودة فى النص السكندرى. أول من طرح هذه النظرية هو ليكلير، و الذى رفض نظريته لاحقاً[19]. و من طوّر هذه النظرية بشكل ملحوظ هو الألمانى فريدريك بلاس. تتلخص رؤية بلاس فى أن لوقا كان قد أعد نسخته لأعمال الرسل، ثم أراد أن يرسل نسخة منه لصديقه ثيؤفيلوس. و لكن نظراً لأن لوقا لم يكن غنياً، فلم يمتلك المال اللازم لتأجير ناسخ، قام هو بنفسه بعمل نسخة. أثناء نسخه حذف بعض المقاطع و غير فى صياغات بعض المقاطع الأخرى. بعد ذلك إنتشرت النسختين و تم تداولهما، و تم عمل نسخ عن كل منهما. النسخة الأولى التى قام بها لوقا هى نص الاعمال بحسب النص الغربى، و النسخة الثانية هى نص الأعمال بحسب النص السكندرى[20]. و قد قدّم علماء كثيرين انتقادات كثيرة لهذه النظرية، أهمهم توماس جيير و روبيرت هال، رغم أنها جذبت عدد من العلماء المعروفين مثل ثيؤودور زاهن و ايبرهارد نيستل[21]. و يلخص بويسمارد موقف العلماء فى النصف الأول من القرن العشرين كالتالى:”و بشكل عام، فإن غالبية الدراسات الحديثة تفضل النص السكندرى عن النص الغربى، معتقدين أنه حتى لو أن النص الغربى يحتوى على بعض القراءات الأصلية القليلة، فإن بقية النص هو نتيجة مراجعة تمت فى النصف الأول من القرن الثانى و تميزت بالعادات اللاهوتية الواضحة”[22]. و تُعتبر دراسة عالم إيب فى المخطوطة بيزا التى أتمها فى الستينات، هى أفضل شاهد لهذا الإعتقاد العلمى. و فيما بعد، تأكد العلماء أن النص الغربى لم يكن وليد السيطرة أو التحكم، بل أنه نمو عشوائى كما أكد كولويل و آلاند و ميتزجر.
على الجانب الآخر، طوّر معهد الدراسات النصية للعهد الجديد بمونستر نظرية أخرى، قامت بربارا آلاند ببذل المجهود الأكبر فيها. يلخص بيتزر النظرية كما يلى:
“بتركيزها على محاولة إيجاد تفسير لعدم التجانس (بين شواهد النص الغربى)، ترى بربارا آلاند نشأة النص الغربى، و لعدة أسباب تسميه نص بيزا فى نظرية مونستر، كعملية تدريجية تصل إلى قمتها فى تنقيح نقدى رئيسى، أو تنقيح رئيسى، فى بدايات القرن الثالث أو أواخر القرن الثانى فى سوريا. هذا التنقيح الرئيسى يشهده بشكل رئيسى الدليل السيريانى، النسخة اللاتينية الإفريقية (القديمة)، المخطوطة بيزا، و مخطوطة الحروف الصغيرة رقم 614، و هى كل الشواهد التى تحتوى على نص غربى متجانس قليل أو كبير. و قبل بداية القرن الثالث، لم يكن هناك نصاً غربياً، و لكن فقط قراءات نشأت فى العملية الطبيعية لإنتقال نص العهد الجديد. هذه القراءات توسعت فيما يُسمى الآن بالتقليد الغربى حتى دخلوا إلى النص الغربى عن طريق ذاك الذى كان مسئولاً عن إنتاج هذا التنقيح الرئيسى”[23].
بهذه النظرية، ترى بربارا آلاند أنه كان هناك فترة معينة تسبق وجود النص الغربى، و لكنها كانت تحتوى على القراءات الغربية بالفعل. هذه الفترة يشهد لها آباء القرن الثانى، و خاصةً ايريناؤس و يوستينوس. غير أنه هناك مشكلة فى هذه النظرية، و هى التماسك اللغوى و الإسلوبى فى نطاق هذا النص، و الذى من الصعب أن يكون نتيجة عملية عشوائية. فى نفس الوقت، من غير المقبول تماماً وجود فكرة التنقيح النقدى كأساس للنص الغربى، لأن هذا لا يحمل تفسيراً للخلاف الهائل فى شواهد النص الغربى التى تحمل مفارقات كبيرة و واسعة فى تجانسها. يبرز هذا العامل أكثر، كما يقول بيتزر، فى الشواهد الأكثر قدماً، مما يعنى أن فكرة وجود تنقيح نقدى لا تفسر الدليل المتوفر. فكيف يمكن أن يكون هناك تنقيح نقدى، أى نص قياسى واحد فى الشواهد، و مع ذلك نرى الشواهد الأقدم غير متجانسة فى إطار واحد؟ ميتزجر يعلق على ذلك قائلاً:”هذا الشكل من النص الموجود بإتساع فى الكنيسة الأولى، و أستخدمه ماركيون، تاتيان، ايريناؤس، و آخرين، لا يمكن إعتباره تنقيح نقدى، لأنه ليس مُوحد ولم يكن كذلك أبداً”[24]، و يتفق معه ديفيد باركر فى نفس النتائج، فيقول:”بمقارنة النص اليونانى و اللاتينى، توصلت إلى أن شكل نص الأعمال الموجود فى هذه المخطوطة يرجع إلى النمو التطورى و ليس بسبب مراجعة واحدة شاملة”[25]. و سواء كانت نظرية مونستر أو نظرية العادات اللاهوتية التى لإيب[26]، ففى كل الأحوال يتفق غالبية العلماء على ثانوية النص الغربى، و أنه ليس أصلياً بأى حال[27].
إنعدام التجانس بين شواهد النص الغربى هو العامل الخارجى لإعتباره ثانوياً، أما العامل الداخلى فهو إنعدام الإتساق اللغوى. أبرز العادات الداخلية للنص الغربى هى إنعدام وجود إتساق لغوى داخله، مثل التوفيقات المتكررة، تكرار أشكال النص، إعادة الصياغة، و خاصية الأشهر للنص الغربى و هى الإضافات. لهذا قال العالم الألمانى الشهير كونزيلمان:”نوع النص هذا لا يُوجد له ممثل بمثاء نقاء النص المصرى (السكندرى)”[28]. و حينما قررت دراسة هذه التصريحات بنفسى، رجعت إلى كتاب روبز الذى وضع فيه نص أعمال الرسل فى بيزا بالمقابلة مع نص أعمال الرسل فى الفاتيكانية، و تأكدت بنفسى من صحة هذه التصريحات.
دافع أمفوكس و فاجاناى عن أولية النص الغربى بإستخدام نفس الإحتجاج اللغوى، قائلاً:”القراءات الغربية تحتوى غالباً على كلمات متكررة غير موجودة فى بقية أنواع النصوص. و من النظرة الأولى قد يبدو هذا كزلات غير مقصودة دخلت إلى نص لا يوجد به تكرارات و بقيت هناك لمدة من الوقت. و لكن هناك سبيل آخر للإستكشاف و هو الذى إقترحه مارسيل جوزيه، و هو أن ينظر الفرد لهذه التكرارات كواحدة من ضمن خصائص عديدة للإسلوب الشفوى، و هو عبارة عن مجموعة من الآليات البلاغية المُستخدمة للأغراض التعليمية فى مجتمعات الثقافة الشفهية”[29].
و ما يقصده العالمان هنا، هو أن هذه التكرارات ليس زيادات على النص، بل هى نص أصيلاً؛ و السبب فى ذلك هو أن التكرار أحد العوامل البلاغية المُستخدمة فى الإلقاء فى المجتمع الذى خرجت منه هذه النصوص. و ما قاله أمفوكس هنا هو ثورة بالفعل كما وصفها بيتزر، إذ أنه يدعونا إلى النظر لكتابات العهد الجديد من منظور مختلف تماماً. يدعونا أمفوكس إلى التفريق بين “النحو” و “البلاغة”، فالإسلوب فى إستخدام المفردات و حروف الوصل و ما إلى ذلك، هو شىء يختص بالكاتب نفسه. و لكن الإسلوب البلاغى يرجع بنا إلى ما قبل عصر التدوين نفسه، لدراسة الكيفية التى وصلت بها الرسالة. أمفوكس يقول فى ذلك:”رسالة النص موجودة بالأكثر فى التكوين البلاغى لكل قصة و الترتيبات السردية أكثر من المفردات نفسها. و لكن هذا النوع المُعقد من الكتابة المُشفرة غير مناسب للنشر العام”[30]. و لهذا كان يجب التعامل مع النص لجعله أقل يسراً فى الفِهم أثناء تداوله، فظهر النص السكندرى.
المشكلة الرئيسية فى هذا الإحتجاج أنه غير قائم على دليل! بالإضافة إلى ذلك، السؤال الهام يطرح نفسه بقوة: لماذا فى أعمال الرسل فقط؟! لم يطرح العلماء المعتقدين فى أصالة النص الغربى إجابة على هذا السؤال، ولا حتى أمفوكس فعل. و يجب أن نعى أننا نتكلم على أسبقية نصوص و ليس قراءات. بمعنى، نستطيع أن نجد قراءات أصلية فى النص الغربى، كما فى التقصيرات الغربية غير المُعتادة. لكن هذا لا يعنى أن النص الغربى بشكل عام أسبق فى أفضليته عن النص السكندرى الذى سنتكلم عنه الآن. و يبقى الحال كما عبر عنه بيتزر:”رغم أن هناك أدلة جديدة و نظريات دعمت أصالة النص الغربى فى العقد أو العقدين الماضيين، فهذه الأدلة و النظريات لم تنجح فى إقناع عَالم العلماء. ما نحتاجه هو نظرية شاملة تأخذ فى الحسبان كل أو أغلب المعالم و الظواهر المثبتة حول هذا النص. و حتى تخرج هذه النظرية للنور، يبقى من الأسهل رؤية هذا النص على أنه ثانوى المنشأ”[31].
النص السكندرى
يفتتح ميتزجر و ايرمان مناقشتهما للنص السكندرى بقولهما:”سيكون من الخطأ تصور أن ممارسات عملية النسخ الغير مُتحكم بها التى أدت إلى تكوين التقليد الغربى النصى، تم إتباعها فى كل مكان يتم إنتاج نصوص به فى الإمبراطورية الرومانية”[32]. و قد صدقا بالفعل، فالإجماع العام لعلماء النقد النصى للعهد الجديد، أن النص السكندرى هو نص حازم يقدم أفضل صورة ممكنة للنص الأصلى بإخلاص و نزاهة. هذا الحزم يسميه ميتزجر و ايرمان بـ “التحكم الواعى ذو الضمير الحى”[33]. و النص السكندرى له عدة أسماء، فهو النص المحايد عند ويستكوت و هورت، النص ما قبل السكندرى عند بروس ميتزجر، و هو النص الأصلى عند كرت و بربارا آلاند (أو القاسى فى تصنيفهما للبرديات). و يمثل هذا النص بشكل رئيسى: البردية 66، البردية 75، السينائية، و الفاتيكانية[34].
العوامل التى تجعل من النص السكندرى يحمل معالم الأصولية، إثنين[35]:
· العامل الخارجى: و هو مدى جودة نص برديات القرن الثانى و الثالث.
· العامل الداخلى: و هو الإتساق المتماسك فى المعالم و الخصائص الرئيسية لهذا النص، خاصةً فى البرديات القديمة.
دافع ويستكوت و هورت عن أصولية النص السكندرى، الذى هو النص المحايد فى نظرهما، و قدم هورت أكبر أجزاء مقدمته دفاعاً عن أصولية هذا النص. كان إعتمادهما الرئيسى على السينائية و الفاتيكانية، فجاءت البرديات التى تم إكتشافها فى القرن العشرين لتقوى إحتجاجهما. معروف لكل باحث فى النقد النصى، أن ويستكوت و هورت فضلا المخطوطة الفاتيكانية عن السينائية فى تحرير إصدارهما لنص العهد الجديد. فكانت المفاجآة بإكتشاف البردية 75، و التى تسبق الفاتيكانية بقرن و نصف من الزمان، لتؤيد الفاتيكانية أكثر من السينائية. بجانب الترجمة القبطية الصعيدية، و بعض الآباء السكندريين الذين نجح العلماء فى إعادة تكوين نصهم للعهد الجديد، يصبح الدليل فى قمة تماسكه لبناء قضية صلبة لأصولية النص السكندرى. بيتزر يصف أمر النص السكندرى بقوله:”النص يجرى كخيط ذهبى فى أقدم المخطوطات كلها”[36]، و يصفه ميتزجر و ايرمان:”ليس أمراً مفاجئاً أن نجد الشواهد النصية المرتبطة بالإسكندرية تشهد جودة عالية فى الإنتقال النصى من أقدم العصور. لقد كان هناك حيث يوجد خط قديم من النص نُسِخ و حُفِظ كما هو مُبرهن عليه فى كتابات كُتّاب الكنيسة من القرن الثالث و الرابع، مثل: أوريجانيوس، أثناسيوس، و ديديموس الضرير، و كما هو موجود فى هذه المخطوطات المُعتبرة مثل: البردية 66، البردية 75، المخطوطة الفاتيكانية، و المخطوطة السينائية، و فى مخطوطات من الترجمات القبطية”[37].
و هذا يرجع بالأساس للحقيقة التاريخية الهامة، و هى أن الإسكندرية مركز تجمع الثقافات و الكلاسيكيات و الفلسفات من حول العالم. كل دارس متعمق فى العصر اليونانى فى الإسكندرية، يعرف جيداً الحضارة العظيمة التى أسسها البطالمة فيها، منذ أن أسسها الإسكندر. بارت ايرمان يقول حول هذه الثقافة:”أدرك العلماء المعاصرين أن النُساخ فى الإسكندرية، و التى كانت مركزاً فكرياً رئيسياً فى العالم القديم، كانوا مدققين بشكل خاص، و حتى فى هذه القرون المبكرة، فهناك فى الإسكندرية، حُفِظ شكل نقى جداً للنص فى الكتابات المسيحية الأولى، لعقد بعد عقد، بواسطة نُساخ مسيحيين مُكرسين و مُدربين نسبياً”[38].
رغم هذا، فقد كان ويستكوت و هورت معتقدين بشكل خطير فى أن النص السكندرى، أو نصهم المحايد، هو النص الأصلى بعينه. و لكن الموقف الآن تعدل بعض الشىء، فلا يعتقد العلماء أن هناك مخطوطة أو أن هناك نوع من النص لا يحمل خطأ نسخى على الإطلاق. و لذلك، سمح العلماء بإمكانية وجود الخطأ فى النص السكندرى. غير أن أكثر ما يجب أن ننتبه له، هو أن النص السكندرى الأقل عرضة تماماً للخطأ النسخى.
تكوين التاريخ
بناء على ذلك، تم تكوين تاريخ الإنتقال النصى فى النقاط التالية:
· كل مخطوطة، كل تيار نصى، كل نص محلى، كل عائلة، تحمل بداخلها برهان فسادها.
· عملية انتقال نص العهد الجديد، تشهد على نفسها، بأنها بدأت بشكل عشوائى غير مُدرب، و أنتقلت بعد ذلك لعدة مراحل من الحزم، الى ان وصلت لمرحلة الدقة المطلوبة.
· فى ضوء ما هو معروف و ثابت عن الثقافة الأدبية للعصور القديمة، فإن أغلب الخلافات المُتعمدة نشأت فى القرون المبكرة جداً للمسيحية.
· لا تحمل الفترة الأولى لإنتقال نص العهد الجديد، أى دليل او برهان علمى، على وجود تنقيح نقدى مُحملاً بأيديولوجيات لاهوتية، سواء أرثوذكسية او هرطوقية، بإستثناء ماركيون. إنما التغييرات نشأت نتيجة “التصحيح”.
· مساحة و تأثير هذا “التصحيح”، تختلف بشكل ملحوظ: فمن المُمكن ان تكون عملية التصحيح هى مجرد مراجعة النسخة على المثال المنقول عنه، و قد يأتى هذا التصحيح من القارىء او ناسخ ما لتصحيح اخطاء ناسخ المخطوطة دون العودة الى المثال الذى نُقلت عنه هذه المخطوطة، و قد تُراجع النسخة على مخطوطة أخرى غير التى نُقلِت عنها.
· التيارات النصية السكندرية و البيزنطية، ليست إختلاقاً للقراءات، و إنما إختياراً بين القراءات.
· النسبة العامة الحالية لتدعيم قراءة ما فى المخطوطات المتوفرة، لا تعكس بالضرورة النسبة العامة لتدعيم نفس القراءة فى المراحل الأقدم فى تاريخ إنتقال النص.
· إنتقال نص العهد الجديد، تشكل و تأثر بشكل واضح و مباشر، بالظروف الخارجية المحيطة، التى أثرت جزرياً فى تاريخ الكنيسة المسيحية، مثل عصور الإضطهاد، سياسات الإمبراطورية البيزنطية، ظهور الإسلام، و الصراع الأرثوذكسى – الهرطوقى المُمتد ما امتدت الكنيسة المسيحية. بكلمات أخرى، لم يكن هناك “وضع طبيعى” تم فيه نِساخة العهد الجديد، بل قد تمت عملية الإنتقال تحت كل ظرف يمكن تخيله، إلا الظرف الطبيعى.
· هناك قلة من مخطوطات الحروف الصغيرة، ثبت انها مأخوذة عن إحدى مخطوطات الحروف الكبيرة القديمة، و بالتالى فهذه المخطوطات لا تُعامل بتاريخ كتابتها، و إنما بحسب جودة النص الذى تحتفظ به.
· من المُمكن إعادة تكوين تاريخ تكون بعض الأقسام الفرعية داخل النص المحلى الواحد، مثل العائلة 1 و العائلة 13، بشىء من الثقة. هذه المحاولات فى الأمثلة المُصغرة، تساعدنا بشكل كبير فى فهم تاريخ تكوين النصوص المحلية، و محاولة إعادة تكوينه.
· دراسة النصوص الآبائية و الكُتَّاب القدامى، تقدم لنا مساعدات فى إعادة تكوين وضع الإنتشار الجغرافى فى إحدى حقبات التاريخ.
· تاريخ الإنتقال النصى، يختلف بشكل جوهرى بإختلاف العامل الأدبى فى كتب العهد الجديد. فتاريخ انتقال نص الأناجيل يختلف عن تاريخ إنتقال نص الرسائل بشكل عام، و يختلف تاريخ انتقال نص الرسائل البولسية عن الرسائل الجامعة، و يختلف عنهم جميعاً سفر الرؤيا.
فادى اليكساندر
28 – 10 – 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] Jacobus H. Petzer, The History of The New Testament Text: Its Reconstruction, Significance, And Use in New Testament Textual Criticism, In: New Testament Textual Criticism, Exegesis, And Church History: A Discussion of Methods, Edited By B. Aland & J. Dolbel, Pharos: Netherlands 1994, P. 11
[2] B. F. Westcott & F. A. Hort, The Greek New Testament With Dictionary, Foreword By Eldon Jay Epp, Hendrickson Publishers: USA 2007, P. xiii
[3] Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman, The Text of The New Testament: Its Transmission, Corruption & Restoration, 4th Edition: Oxford University Press 2005, P. 273-274.
[4] راجع بحثنا السابق “قراءة ثانية للخاتمة و الزانية” لأفكار حول هذا الموضوع.
[5] http://www.uni-muenster.de/INTF/Initial_text.html
[6] هذا المثال مأخوذ بتصرف عن العالم هارلود جرينلى، أنظر:
J. Harlod Greenlee. The Text of The New Testament: From Manuscript to Modern Edition, Hendrickson Publishers: USA 2008, P. 40; See also, Introduction To New Testament Textual Criticism, 2nd Revised Edition, Hendrickson Publishers: USA 1995, P. 52.
[7] Metzger & Ehrman, P. 279
[8] Ibid.
[9] Petzer, P. 17
[10] Metzger & Ehrman, P. 276
[11] K. Aland & B. Aland, The Text of The New Testament: An Introduction To The Critical Editions & To The Theory & Practice of Modern Textual Criticism, 2nd Edition, English Translation By Erroll F. Rhodes, Eerdmans: USA 1989 (Paper Back Edition: 1995), P. 54-55.
[12] Metzger & Ehrman, P. 276
[13] Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on The Greek New Testament, 2nd Edition: German Bible Society 1994, 5th Printing 2005, P. 223.
[14] Eldon J. Epp, Coptic Manuscript G67 & The Role of Codex Bezae As A Western Witness in Acts, In: Journal of Biblical Literature, Vol. 85, No. 1: 1966, P. 197-212.
[15] Petzer, P. 19
[16] Christian-Bernard Amphoux & Leon Vaganay, An Introduction To New Testament Textual Criticism, Cambridge University Press 1991, P. 94
[17] أنظر نظرية أمفوكس بالتفصيل فى المرجع السابق، ص 98 – 111، و خاصةً حديثه عن دور ماركيون فى ص 99 – 100.
[18] Petzer, P. 20
[19] Metzger, Textual Commentary, P. 223.
[20] M.-E. Boismard, The Texts of Acts: A Problem of Literary Criticism? In: New Testament Textual Criticism: Its Significance for Exegesis, Edited By Eldon J. Epp & Gordon D. Fee, Oxford University Press 1981, P. 147
[21] Metzger, Textual Commentary, P. 224.
و قد قدم ميتزجر نقداً واسعاً شمل آراء العلماء فى نظرية بلاس هذه فى ص 225 – 226.
[22] Boismard, The Texts of Acts, P. 148.
[23] Petzer, History, P. 22. See Also Metzger, Textual Commentary, P. 234.
[24] Metzger, Textual Commentary, P. 233.
[25] David C. Parker, An Introduction To The New Testament Manuscripts & Their Texts, Cambridge University Press 2008, P. 289
و يكرر ذلك قائلاً:”دراستى فى المخطوطة بيزا ولدت الدليل بأن نصها لأعمال الرسل هو نتيجة مراحل من النمو. فمقارنة بيزا مع البردية 38 تقترح بأنه لم يكن هناك شكل واحد مُراجع للأعداد، إنما أن كلاً من المخطوطتين يشهد لمراحل مختلفة فى عملية النمو”، ص 298.
[26] مع ملاحظة أن هناك علماء كثيرين إختلفوا مع إيب فى نظرية العادات اللاهوتية، مثل باريت، و لكن ما ينصف نظرية إيب هو ليس فقط وجود العادات المعادية لليهودية فى المخطوطة بيزا و التى أشار لها إيب، و إنما أيضاً وجود بعض العادات الكريستولوجية فى نفس المخطوطة و التى أشار لها ايرمان.
[27] نظرية بلاس و نظرية آلاند ليستا الوحيدتين، بل هناك نحو تسع أو عشر نظريات عرضهما ميتزجر و باريت، و لكن إخترت هاتين النظريتين فقط لأنهما الأكثر شهرةً. للمزيد حول بقية النظريات أنظر:
C. K. Barrett, A Critical & Exegetical Commentary on The Acts of The Apostles, Vol. 1, T&T Clark: USA – UK 1994, P. 20-26; Metzger, Textual Commentary, P. 223-231.
[28] Hans Conzelmann, Acts of The Apostles: A Commentary, (English Translation, Hermeneia Series), Fortress Press: USA 1987, P. xxxiv
[29] Amphoux & Vaganay, Introduction, P. 94
[30] Ibid, P. 95.
[31] Petzer, History, P. 25.
[32] Metzger & Ehrman, Text, P. 277
[33] Ibid, P. 277-278
[34] البعض يستثنى البردية 66 بسبب التصحيحات التى تحملها عند وجود خلاف بينها و بين الثلاث مخطوطات الأخرى.
[35] Petzer, History, P. 25
[36] Ibid, P. 26.
[37] Metzger & Ehrman, Text, P. 278
[38] Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible & Why, Plus Edition, HarperSanFrancisco: USA 2007, P. 72; also the 2005 Edition, P. 72.