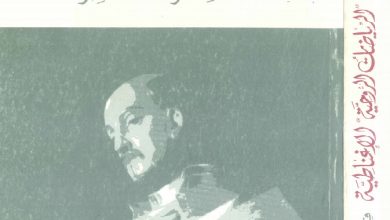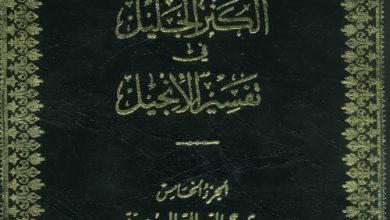كتاب عصر القلق – الراهب كاراس المحرقي
كتاب عصر القلق – الراهب كاراس المحرقي

مقدمة
كان يصلى القداس، أما اليوم فكان الأحد، فحدث بعد انتهاء الكاهن من الصلاة أن طلبه رجل ليجلس معه، فهناك مشكلة تتعبه وكادت تقضى على حياته، أما الرجل فكان على ما يبدو من مظهره ذا مركز مرموق، ويتمتع بقسط وافر من العلم، وإن كانت صحته على ما يبدو جيدة إلا أن نفسيته كانت غير مستقرة، فهو كثير القلق.. دائم التفكير في الموت، وأنه كما يتخيل سيموت في حادثة.. وقد عرضوه على أطباء كثيرين فأكدوا جميعاً أن مخاوفه وهمية.
لكن حدث بعد عدة لقاءات أن اكتشف الكاهن سر قلق الرجل، فالمشكلة لها جذور منذ الصغر، فعندما كان طفلاً مات أبوه فلما سأل أمه عن مكانه قالت له: في السماء، لكن طفلاً كان يلعب معه قال له: إن أباه مات في حادثة سيارة وهو الآن يعيش مدفون في الأرض وليس في السماء، ومنذ ذلك الوقت صار يرتعب من مجرد سماع كلمة سيارة أو رؤيتها.
لا شك أن الرجل استراح ولو قليلاً بعد أن عرف سر قلقه، لكنه لم يسترح تماماً، فقد كان لا يزال يخشى الموت.. فمشكلة الطفولة كانت سبباً في قلقه، لكنها لم تكن الوحيدة، إذ اكتشف الكاهن أيضاً أن ثوب ماضيه ملوث بأوزار النجاسة، وكان هذا أيضا سبباً في قلقه وخوفه من الموت، لكن نعمة الله تدخلت، واستطاع الكاهن أن يقود الرجل إلى التوبة والاعتراف والتناول، فضاع قلقه وانتهت مخاوفه، وأصبح إنساناً آخر، يحيا في سلام غامر، ويتمتع بهدوء صافٍ، أما الابتسامة فلم تعد تفارق وجهه.
هذه صورة من الصور الكثيرة التي نراها تملأ بيوتنا، لكنها ليست الصورة الوحيدة للقلق، فكل إنسان له حالته، فحالات القلق التي تصيب الناس كثيرة ومتنوعة وعلى درجات مختلفة من العمق والشدة. فدعني أيها القارئ الحبيب أن أحدثك عن عدة وسائل لتتغلب بها على القلق، وتنتصر بها على مشاكل العصر، أغلبها من تعاليم أطباء متخصصين وآباء مختبرين..
لكن قبل أن أعرض هذه الوسائل رأيت كتمهيد لموضوعنا أن أتحدث عن عصرنا وسماته في فصلين وهما ” عصر القلق ” و” سمات عصر القلق “، ثم جاء الفصل الثالث بعنوان ” أين الله في عصر القلق! ” وبهذا نكون قد وصلنا إلى موضوعنا الأساسى الذي اخترنا له عنوان ” كيف تحيا كمسيحى في عصر القلق؟ “.
الفصل الأول: عصر القلق
إنسان اليوم يمكن وصفه بصفات كثيرة أهمها صفه القلق، فهو قلق وهمومه كثيرة، ولهذا كثيراً ما يتساءل عن مصيره وعائلته وأمواله… في عصر سادت فيه السرقة والنهب، بل ساد فيه الظلم والإرهاب..!!
ملايين من البشر في أنحاء العام يتألمون من شدة الكبت، ومن كثرة مظالم لا تُحصى ولابد لهم أن يتساءلوا: لماذا الظلم والطغيان؟! لماذا الضغوط والصراعات؟! لماذا الذل والقيود إن كان الله خلقنا لنعيش أحراراً؟!
وثمة ألوف من البيوت المحطمة والمزعزعة، التي خلت جدرانها من الفرح، وقد صارت أشبه بمستشفى للأمراض النفسية يتساءلون: أين سطور الفرح في كتاب حياتنا؟! هل تظل أنفسنا بين جدران مظلمة تتنفس هواءً مفعماً بالحقد والكراهية؟! إلى متى نرتدي ثياب الفقر المبطنة بأنفاس الموت؟!
إننا نحيا في عصر يتألم فيه الأبرار والخطاة على السواء.. عصر يذبح الشر الخير بسيف حاد علناً وعلى مرأى من جميع الناس.. وهذا دفع البعض أن يتساءلوا: هل رسالة الإنسان في الحياة أن يحيا بوجه حزين مكتئب رغم ما في الحياة من متع وما في الطبيعة من جمال، ورغم ما في الإنسان من رغبة في التمتع بكل ما في الطبيعة من جمال؟! أين بذور السعادة التي وضعها الله في قلوبنا؟! لما طُرحت على الصخر لتلتقطها الغربان وتذريها الرياح؟!
وفي ظل المشاكل الاقتصادية المعقدة، نرى ملايين البشر يذبحهم الجوع ذبحاً والبشرية في أماكن كثيرة تئن ثراءً وشبعاً وتخمة، ملايين يموتون جوعاً، وملايين غيرهم يموتون تعذيباً واضطهاداً، لأن الزعماء في أماكن كثيرة يسجنون الحرية، ويقيدون الفكر، ويقتلون الإبداع، وكل هذا يجعلنا نتساءل: أي عالم هذا الذي نعيش فيه! إنسان يموت جوعاً وإنسان يموت شبعاً! إنسان يموت بالحرية وإنسان يموت بالعبودية!!
أسئلة كثيرة يطرحها المتألمون، وما أكثر البلدان التي تنتابها ويلات الحروب وفيها مؤمنون أتقياء يتساءلون: لماذا صارت الأرض كأنهار من الدماء؟! لماذا يستبد القوي بالضعيف ويريد أن يقضي عليه وينهب خيراته؟!
هؤلاء وغيرهم يتساءلون: لماذا… لماذا… لماذا…
قال لي شاب: أريد أن أحيا حياة مسيحية مثالية، أواظب على الكنيسة، أمارس كل الصلوات، أخدم… ولكن كيف يتحقق كل هذا؟! كيف أستقر روحياً وأنا غير مستقر لا فكرياً ولا جسدياً؟! فمنذ أن تخرجت وحصلت على شهادتي الجامعية، وأنا دائم البحث عن عمل، أي عمل حتى ولو كان لا يناسبني، وكثيراً ما أتساءل: أليس من حقي أن أعمل! أليس من حقي أن أتزوج! أليس من حقي أن أتمتع بالحياة! أليس من حقي أن أعبد ربي..!!
إن تفكيري المستمر في مشاكل العصر، قتل صلواتي وسلب كل تأملاتي، وأضعف روحياتي، وقضى على خدماتي..
هنا فقط أدركت خطورة كلمة (لا أعمل)، التي صارت مصدر قلق للكثيرين، قد لا تظنها مشكلة، ولكن علماء النفس والاجتماع بدأوا يدركون خطورتها، وما ينتج عنها من قلق وعدم استقرار، وأيضاً من شر ومن فساد.. فانتشار البطالة زاد من حِدة وقسوة الفراغ، وهنا أصبح الملل مشكلة جديدة وأيضاً كبيرة، فعندما تزداد نسبة البطالة، وعندما يوجد وقت فراغ أكثر، تكثر أبعاد مشكلة (ماذا نفعل)، ماذا نفعل لنواجه متطلبات الحياة وتحديات العصر؟! ماذا نفعل لنشغل الفراغ ونقتل الوقت؟! ماذا نفعل لنثبت وجودنا بين الناس؟!
حيث البطالة هناك الفراغ والملل والفساد، فما من خطية إلا سببها الفراغ، حيث البطالة هناك أيضاً تدهور في مستوى التعليم، وانحطاط في قيمة الدارسين! فبسبب اللهث الجنوني وراء لقمة العيش، صار أصحاب الحرف ملوكاً جالسين على عروش تحملها ثرواتهم، أما أصحاب الفكر والمعرفة فصاروا أجراء تحت قبضتهم، يتحكمون في مصيرهم كما يشاؤون، ويذلونهم كما لو كانوا من طبقة العبيد، فتحقق قول سليمان الحكيم ” الجهالة جُعلت في معالي كثيرة والأغنياء يجلسون في السافل، قد رأيت عبيداً على الخيل، ورؤساء ماشين على الأرض كالعبيد ” (جا10: 6،7).
إن كلمة متعلم تعني لا مركز ولا وظيفة، تعني اليوم إنساناً عاطلاً لا يملك حتى نفقاته الشخصية، ويبقى السؤال الحائر: من هم الذين يبنون المجتمع؟!
منذ سنوات مضت كانت نسبة الانحراف قليلة إلى حد ما لو قورنت بهذه الأيام، فالزواج في سن مبكرة كان متاحاً ومتيسراً للجميع، أما الآن فلم تعد الأمور هكذا، فحيث لا عمل لا مال، وحيث لا يوجد مال لا يكون أيضاً زواج، وهذه آفة ما أشر ضررها على الأسرة وعلى المجتمع، فالبتولية الإجبارية، أقصد العزوبية، غالباً ما تقود الإنسان إلى الانحراف الجنسي والانحلال الخلقي…
وهل ينكر أحد أننا نحيا في عصر وصل فيه الانحراف إلى قمته!! فشباب اليوم أكثر قلقاً وانحرافاً من أمس ويوماً بعد يوم يزداد قلقهم وانحرافهم، والشابات أيضاً أصبحن أشد قلقاً وانحرافاً منهم، فما أكثر القصص التي تُحكى هذه الأيام عن الشذوذ والخيانات والإدمان.. قصص لم نكن نسمعها أو نقرأ عنها من
قبل!!
هل تصدق أن طالبة في الإعدادية لم يتجاوز عمرها (15) سنة تصبح مدمنة!! لا تتعجب فقد نشأت الفتاة في أسرة ممزقة، وهذا سر ضياعها، فالفتاة كانت تقيم مع والدتها المطلقة التي عادة ما تسافر للخارج تاركة لها سيارتها الفاخرة تتحرك بها أينما تشاء، وأموالاً كثيرة لتشتري ما يحلو لها من مأكولات وملبوسات، وبيتاً أنيقاً تدعو إليه ما تحب من صديقات وأصدقاء…
لقد عاشت الفتاة في حرية كاذبة دون أن تفهم معنى الحرية ودون أن تملك مقومات الحفاظ عليها، فحدث في أحد الأيام أن تعرفت في النادي على (شلة) وأصبحت هذه (الشلة) لا تنفصل، في الصباح يلتقون في النادي، وفي المساء في إحدى صالات الديسكو، لكن يبدو أن (الشلة) قد ملّت الالتقاء في الأماكن العامة، فانتهزوا فرصة سفر والدة الفتاة للخارج وطلبوا منها أن يسهروا في شقتها، وبدأت سهرتهم الحمراء المشحونة بالفساد، وفجأة في منتصف الليل سُمع صوت طرق شديد على الباب ففتح شاب فوجد ضابطاً ومعه حملة للقبض عليهم.
لقد كانت (الشلة) تحت المراقبة منذ ظهورهم بشكل مريب في صالات الديسكو، وكم كان المشهد مذهلاً ومؤسفاً، إذ وجدوا شاباً يمسك بيد الفتاة يعطيها حقنة هيروين، وبعض أفراد (الشلة) يشاهدون فيلماً جنسياً، والبعض الآخر في أوضاع مخلة، فتم القبض عليهم وأودعت الفتاة في مؤسسة الأحداث.
والآن من الجاني ومن الضحية في هذه الكارثة؟!
++ إن الجاني هو أولاً: التمزق الأسري الذي أدى إلى انفصال الأب عن الأم، واهتمام الأم بنفسها تاركة ابنتها دون أية رعاية أو رقابة، فالمال لا يعوض الأبناء عطف وحنان والديهم، وغالباً ما يقود إلى الانحراف خاصة في مرحلة المراهقة.
++ وهو ثانياً: ضعف الرقابة في الأندية على ممارسات الشباب داخلها، فقد أعلنت الفتاة أن بعض المسئولين عن الرقابة في هذه الأندية يبيعون السم لمن يريده من الشباب داخل الأندية.
++ وهو أولاً وثانياً وثالثاً: غياب دور الدين والقيم في حياة هؤلاء المخدوعين بوهم المخدر، فلو كانت الفتاة متدينة لكان الدين كفيلاً بحمايتها وحماية أمثالها من السقوط في بئر الإدمان.
لقد أصبح القلق سمة من سمات عصر ضاعت فيه القيم والمبادئ، وكثرت فيه المتناقضات، فبينما نرى العلم اليوم وقد فجر لنا ينابيع الخير، وفتح لنا أبواب الأمل، فجعل الصحراء تفتح صدورها للخضرة والنماء، والبحار تفيض بما فيها من ثروات، إذ بمعظم سكان الأرض يقاسي الجوع والحرمان أكثر من أي عصر مضى، لقد زاد ثراء البشر، بعض البشر، وتعمق الفقر أكثر عند الأغلبية!!
وبينما نرى الإنسان يغزو بعلمه الفضاء، ويكتشف ما في الفلك من أسرار، نراه هو عاجزاً عن حل مشاكله على سطح الأرض التي يعيش عليها!! وإن كنا نقرأ عن تصريحات لعلماء الطب يعدوننا بشخصية كاملة لا يؤلمها المرض، إلا أننا نرى أمام أعيننا انهيارات عصبية وأمراضاً عقلية وجسدية أكثر من أي عصر مضى!!
كل هذا جعل إنسان العصر فريسة لضغوط نفسية عديدة، وجعل الحياة كما لو كانت حلبة مصارعة، فأصبحت الحياة الآن صراعاً يقلق البشر، ويبعث الألم في نفوسهم، نعم لقد زادت حدة الصراع ولكن صراع حول ماذا؟! إن كان حول المال والسلطة والقوة، قلنا: هل الذين يمتلكون تلك الأشياء قد شبعوا وأعلنوا رضاهم بحياتهم وكفوا عن الحيرة والخوف والقلق؟!
يجب أن نعترف بأن الفقر ليس سبباً كافياً للقلق لأن الإيمان يغطي كل هذه الثغرات، ويجعلها حلقات ذات معنى في قصة كفاح حلوة ولذيذة، فسر قلقنا أننا ابتعدنا عن المبادئ الإلهية السامية، وفترت روحياتنا، ودخلت الشكلية في صلواتنا، بل والمظهرية أيضاً! ولا بديل إلا أن نجاهد حتى يصاحب التفوق المادي والعلمي تفوق روحي مماثل.
وهل ينكر أحد أن الإنسان الذي أصبح عملاقا في الاختراعات وصار يملك القمر الصناعي والصاروخ والكمبيوتر صار قزماً في الروحيات!!
ألا ترى أن زوجات كثيرات يملكن العربات والمجوهرات… ومع هذا يصرخن من الفقر والعيشة الضيقة!! فأي فقر هذا؟ لابد أنه فقر روحي وهذا سر تعبهن وقلقهن، إن سؤالاً هاماً ينبغي أن نلقيه على أنفسنا بين الحين والآخر.
هذه الحياة ما معناها؟ هذه الرحلة أين تمضي؟ هذا الوجود ما هدفه؟ لماذا خُلقنا؟
في كل القطاعات والمجالات نشعر بأزمة الإنسان سواء في المجال الاجتماعي أو الديني، فالإنسان قلق وغير مرتاح ومضطرب وهائج وكثير الشك والانتقاد، وتشعر بهذه الأزمة كل فئات المجتمع، الغنية والفقيرة، المؤمنة والملحدة، المثقفة والجاهلة.. الجميع يعترفون بأن الإنسان قَلِق وغير مستقر.
نستطيع أن نقول: أن إنسان القرن العشرين على الرغم من علومه الواسعة واختراعاته المبهرة، التي جعلته يسبح في الفضاء ويغوص في أعماق البحار، إلا أنه إنسان قلق، وأصبح عصرنا عصر القلق.
سُمي العصر بعصر الَقلَق، وسُمي الإنسان بالإنسان القَلِق.
مما لا شك فيه أننا نحيا في مجتمع نرث منه الكثير من العادات والتقاليد، منها ما نقبله بإرادتنا ومنها ما نقبله مجبرين، فمن سمة المجتمع توريث التراث، والتراث فيه كثير من القيود، بل كثير من عوامل التخويف والتهويل التي تقلق الإنسان، يكفي أننا نخاف من لعنة الفراعنة، والفراعنة أين هم؟ ألم يموتوا! ولكننا توارثنا الخوف من هتك حرمات قبورهم خوفاً من أن تلحق بنا لعنتهم!
ومما يزيد من قلق الناس في عصرنا الحالي، أن المجتمع لا يدعهم ينسون الماضي، بل دائماً يذكّرهم به وفي نفس الوقت ينبئهم بما سيأتي عليهم في المستقبل، وهذا يجعل الإنسان قلقاً في حاضره إذا ما قاسه بالمستقبل، فالدراسات الحالية معظمها تميل إلى التشاؤم، وكلها تشير إلى خطورة الانفجار السكاني وارتفاع مستوى المعيشة، وتلوث البيئة.. فالتراب ملوث، والهواء ملوث، والطعام ملوث، أقول: والضمير أيضاً قد صار ملوثاً.
وتشير الدراسات أيضاً إلى أنه لو قامت حرب عالمية سوف تقضي على معظم سكان العالم تقريباً، والويل كل الويل لمن يستمر على قيد الحياة بعدها، لأن التشوهات الجسدية التي ستصيب الأحياء، والقحط الذي سيعم الأرض، والانقراض الذي سيهدد كثيراً من الكائنات التي يعتمد عليها الإنسان في غذائه، والمياه التي ستصاب بالتلوثات الاشعاعية، وغير ذلك من عوامل رديئة، سيكون لها أبشع الأثر في حياة الإنسان الذي لم تفتك به الحرب بالفعل.
لا ننكر أن هناك تقدماً حضارياً ملموساً، ولكن على الرغم من هذا التقدم إلا أن إنسان العصر لا زال قلقاً والسبب: إنه عاجز عن التعبير بما يحس به من مخاوف تملأ قلبه، وهو بحاجة إلى طبيب نفساني يساعده على إخراج المختزن في أعماقه حتى تستقر وترتاح نفسه، فمجرد رأي أو نقد بنّاء يعتبر اليوم مهاجمة وتمرداً وعصياناً..
ولست أدري كيف ينمو مجتمع ويتقدم حضارياً وقد ملأ الخوف قلوب شعبه، فأطفأ فيهم شعلة الانطلاق والإبداع!! فمن طبيعة البشر الخوف من القوة تلك آفة ورثها الإنسان عن مجتمع الغابة، وقلائل هم الذين استمدوا من أعماقهم قوة صمدوا بها ضد الظلم والطغيان وشقوا بها كهوف الرهبة وظلام الخوف.
إنهم أرواح أكثر منها أجساداً!
إن الأمم التي تزرع الأمن في قلوب أطفالها وشبابها وشيوخها تشعل فيهم نور العبقريات، فتتقدم حضارياً وتنجب مبدعين في كل المجالات، أما الأمم التي ترهب شعبها وتملأ بالخوف قلوبهم، تطفئ فيهم شعلة الإبداع فتتقهقر وتعود إلى الوراء، إلى عصور الجهل والظلام.
يجب أن نعرف أن الإنسان الخائف لا يمكن أن يبدع وأن يطلق ما في عقله من أفكار، والعقل المرتعب المتردد حتماً سيصيبه الشلل وينطفئ فيه نور الحكمة والمعرفة، وإذا انطفأ نور المعرفة تلاشت الفضيلة فقد قال أحد الآباء: ” كما أنه بدون طين لا يبنى برج كذلك بدون معرفة لا تبنى فضيلة “، فالخوف هو سم قاتل للحياة والتقدم، ولهذا ليست مبالغة مني أو تهكم إن قلت لكم: إن إنسان اليوم في ظني لم يكتشف بعد أنه إنسان خاصة في الدول النامية وأفضل لقب يمكن أن يطلق عليه هو الإنسان الجائع أو الإنسان المطحون.
نعم فإنسان العالم الثالث هو إنسان جائع يحيا في بلاد جائعة، جائع للبر، جائع للسلام، للعلم، للحرية.. ومطحون من الفقر، من الخوف، من أسياد الأرض.. لقد ورث الخوف فرضي به، ورث القيود فتعايش معها، ورث الجوع، الذل، الكبت، الجهل.. فقبلها أمراضاً حتى نهاية حياته.
ولهذا فقد طعم الحياة، وصار مقيداً بقيود ما أكثرها، ولكي يحيا حياة حقيقية لابد من تحطيم هذه القيود، لابد أن يقذف بحجارة المطالب المادية والشهوات العالمية، التي لا تكف عن الصراخ، وحجارة الثروات التافهة والهموم المزيفة.. لابد أن تحكمه قوانين الرحمة والمحبة لا قوانين أهل الغابة، عندئذ يدرك أن يجلس مع ذاته ويكتشف صور الجمال في أعماقه وفي الطبيعة ومن حوله.
ليس الإنسان أيها الأحباء لقيطاً في الفضاء، إنما الإنسان هو عريس الوجود، بل أجمل ما في الوجود، هو لمسة من الله الحي والويل كل الويل لمن حاول أو يحاول أن يذله أو يستعبده، فإذا التقت إرادة من بيدهم الصولجان بإرادة الشعب، انطلقت الحضارة والتقدم والرقي، وإذا لم تلتقِِ فهناك الفناء والاضمحلال.
وأنا أرى: إن كل الذين يؤمنون بالله يؤمنون بقيمة الإنسان أيضاً، ويؤمنون بقداسة الحياة، ويعرفون أن كل كنوز الدنيا لا تساوي قيمة نفس واحدة عند الله.
ولهذا لم يطلب الله من الإنسان أن يقدم له الصلوات، أن يرفع له البخور، أن يفي له النذور… إلا لكي تصبح لحياته معنى، وأن تستقيم علاقته بأخيه الإنسان، وها نحن نتساءل: هل يبارك الله صلاة من يحتقر أخاه؟! أترى الله راضٍ عن البؤس والشقاء الذي أصاب الملايين؟! إن كان الإنسان هو أيقونة الله فلماذا نشوهها؟! لماذا نضع عراقيل في طريق أبديته؟! لماذا نقيم حواجز بينه وبين خالقه؟!
من الأكيد أن القلق يقود الإنسان: إمّا إلى التعمق والبحث والاكتشاف وإيجاد الحلول وطلب المعونة وإرشاد الآخرين والرجوع إلى الله، وإمّا إلى اللامبالاة والرفض والثورة والخوف والبعد عن الله.. إننا نحصد اليوم ثمار الرفض والثورة والخوف… فما هو سبب الإلحاد والبعد عن مبادئ الدين السامية؟! ما سبب الخوف والانطوائية التي لا تصنع شراً ولا تسهم في صنع خير؟! ما سبب اليأس الذي يتلقى صدمات الحياة في استسلام خانع..؟!
إن السبب في كل هذا: هو أن القلق لم يجد حلاً مرضياً، ويوماً بعد يوم يزداد.
الفصل الثاني: سمات عصر القلق
لكل عصر سماته، ولكل عصر إيجابياته وأيضاً سلبياته، وغالباً ما تكون السلبيات أكثر من الإيجابيات، فطبيعة البشر بعد السقوط أصبحت تميل إلى الشر أكثر منه إلى الخير، ولهذا رأيت استكمالاً لموضوعنا أن أتحدث عن بعض سمات عصرنا لا الإيجابية إنما السلبية آملاً أن تكون هناك حلول، ولعل أهم هذه السمات هي الآتي:
ازدياد موجة العنف
لعل أبرز سمات عصرنا القلق، هو ازدياد موجة العنف التي تقوم بها جماعات ضلت الطريق، بل وفقدت هدفها في الحياة، فقد أصبح الإنسان أينما وجد يخشى إصابة رصاصة أو انفجار قنبلة سواء في السيارة أو الشارع أو إحدى المحلات، حتى وهو في الحدائق والملاهي يرفه عن نفسه صار يخشى الموت.
فالموت الآن أصبح أقرب شيء للإنسان!
أما الحرب التي هي قمة أعمال العنف فقد صارت المعضلة الكبرى التي تقلق الإنسان، لأن الحرب كانت ولا زالت ملازمة لكل الأجيال، لأن الناس كانوا ولا يزالون أخصاماً يفتشون عن العداوة، أنانيين يبحثون عن حق يغتصبونه، القوي يتعدى على الضعيف، والضعيف على الأضعف كما لو كنا نحيا في غابة، ففقد الإنسان سلامه وأصبحت الحياة بلا معنى، لأن الحياة تفقد قيمتها عندما تتحول إلى ميدان للقتال، أو حلبة يتصارع داخلها الوحوش.
إن السبب الرئيسي لكل هذا هو الطمع والرغبة في الاستكثار، فالإنسان غير مكتف بما عنده ولهذا يطلب دائماُ المزيد حتى وإن كان ليس في حاجة إليه.. وكذلك الدول كلما زادت ثروتها كلما طلبت المزيد وسعت إلى تحصيله بكل الوسائل ولو كانت هذه الوسائل هي الحروب.
كما أن النمو المتزايد لأوقات الفراغ ومشاكل العصر له دور فعّال في زيادة نسبة الجرائم، وعدد البيوت المحطمة، وها نحن نرى هذه الطاقة الإجرامية قد بدأت تظهر بيننا بصورة همجية فيما يقوم به الشباب المتعطل من تخريب وتدمير لآثار غالية، هم لا يدركون قيمتها ولا أهميتها ولا معناها…!
(لا للعنف) عبارة أجمع كل الحكماء على أهميتها وضرورة تطبيقها، وكل من يقرأ في تاريخ الشعوب يعرف جيداً أن أية نهضة لا يمكن أن تشتعل في وجدان شعبها إلا إذا كان هناك شبه إجماع على أهميتها وضرورتها، ولهذا فإن كل ثورات التاريخ لم
تستطع أن تُحدث تغييراً جذرياً إلا بعد أن اقتنعت الأغلبية بمبادئها ومُثُلها وهضمت أفكارها، أما التغيير بالعنف فله عواقب وخيمة ونتائج سيئة للغاية، والتاريخ أعظم شاهد لنا.
إن القضية قضية إقناع الإنسان لا قهره، وقضية إقناع الإنسان من أهم القضايا التي يجب أن يتولاها الفرد بينه
وبين نفسه، لا أن تُفرض عليه أو يُرغم عليها ضميره.
عندما حاول أخناتون توحيد ديانات مصر القديمة وقام بثورته المعروفة بثورة التوحيد الإلهي، فشل وقام ضده الكهنة، رجال الدين أنفسهم هم الذين حاولوا قتله، والسبب أن كل وسائل الإقناع بتوحيد الديانات لم تكن كافية.
والإسكندر الأكبر عندما حاول أن يوحد الجنس البشري وأقام حفلات زواج، سبعة آلاف أو أكثر حفلة زواج كل يوم بين مختلف الجنسيات، انهارت تجربته.
والصين عندما حاولت أن تفرض على شعبها تنظيم الأسرة بالقوة، فشلت هي الأخرى في هذا التعسف.
واليونانيون لما حاولوا بسط نفوذهم بالقوة على البلاد التي استعمروها فشلوا هم أيضاً فشلاً ذريعاً.
وفي عصرنا الحديث عجزت كل وسائل التعذيب والإرهاب أن توحد بين البشر وتجعلهم خاضعين لفكر واحد، ولعل تجربة النازية ماثلة حتى الآن أمام أعيننا، وتجربة الشيوعية والمادية لا تزال هذه أو تلك في تقهقر وسقوط مريع.
إذاً القضية ليست قضية نظرية فلسفية أو شريعة بشرية يحاول البعض فرضها على الناس ولو بالقوة، إنما القضية هي قضية الإنسان، والدخول إلى أعماق الإنسان لا يتم بالعنف، أو بالإرهاب، أو بالقتل.. لابد من طريق آخر للدخول إلى قلب الإنسان، لابد من إقناعه واحترام عقله وحريته.
إن الحاجة اليوم تقتضي القيام بحملة تثقيف واسعة حتى يتعلم الإنسان أن الحياة ليست ميدان حرب، وأن البشر خُلقوا ليحبوا بعضهم بعضاً، وليساعدوا بعضهم بعضاً على تحقيق الغاية التي من أجلها وجدوا على الأرض وإن كان ولابد من حرب، فلنحارب الجهل والفقر والشر والفساد، نحارب الذل والعبودية وقاتلي الفكر والإبداع، نقاتل الذين يسلبون الضعفاء، ونقف ضد الذين يريدون أن ينصبوا أنفسهم آلهة ليسجد أمامهم البشر، فهؤلاء هم الذين يجب أن نقف ضدهم ونحارب فكرهم..
أعتقد أننا لو حاربنا الشر والفساد لصرنا إنسانية جديدة غير إنسانيتنا هذه، ولو تحولت كل رصاصة إلى حبة قمح، وكل دانة مدفع إلى شجرة مثمرة، لأصبحنا بشراً غير البشر الذين هم نحن.
انتشار الإباحية والجنس
مع كثرة الضغوط النفسية ومشاكل العصر التي زادت بوضوح في هذه الأيام، يبحث الإنسان عن لذة ليعوض بها كبته، ولهذا يتجه البعض إلى التدخين والمسكرات وتعاطي المخدرات.. لإشباع عواطفهم المضطربة ونفوسهم غير المستقرة ونسيان الواقع المؤلم.. غير أن البعض وهم الأغلبية من الشباب يلتجئون إلى ممارسة الجنس ليعيشوا فترة من التلذذ الوقتي كبديل للحب الضائع والعطف المفقود.
ليست مبالغة إن قلت لكم: إننا أصبحنا الآن نحيا في عالم يؤله الجنس كما يؤله المال أيضاً، ولهذا أصبح الحب بلا معنى، لأن مفهوم الحب قد فسد عند الكثيرين وصار مرتبطاً هو الآخر بالجنس، وغاب عن الحب معنى التعاطف والبذل والتقدير، وهذا أدى إلى انحطاط قيمة المرأة عند الكثيرين لأنها أصبحت في مفهوم البعض مجرد لعبة ومتعة، مجرد جسد بلا روح، لا قيمة لها إلا إشباع عواطف الرجل، ألم يقل سارتر الفيلسوف الفرنسي عن المرأة “إنها وعاء “!! فماذا تعني كلمة وعاء؟ تعني في نظر الفيلسوف أنها ليست إلا إناء يصب فيه الرجل شهواته!
لقد صار الإثم يطفح في كل مكان، فأصبح لا جغرافيا له ولا جنسية، أمّا وصية (لا تزن) فصارت عند الكثيرين ليست صعبة، بل مستحيلة التنفيذ في عالم مزقه القلق، وأشقاه الغنى كما أشقاه الفقر تماماً، فالإنسان المطحون بهموم الدنيا صار حائراً في متاهات اللذات، باحثاً عن دواء للهموم والأثقال، ولكن أي دواء يبحث عنه الإنسان في المتع والنشوات المملؤة بالآلام والأحزان!!
للعوامل الاقتصادية دور، وللفراغ دور، ولضعف الروحيات دور.. وأيضاً للقلق والعواطف المضطربة دور أساسي في انتشار الإباحية والفوضى الأخلاقية في هذه الأيام، ومما ساعد على هذا منجزات العصر الحديث، كوفرة الأشرطة السينمائية وأجهزة الفيديو، التي تنقل لنا تطورات المجتمع الغربي العابثة بالقيم والمبادئ الأخلاقية، وانتشار الكتب والمجلات الجنسية المثيرة التي تصادف هوى في نفوس شبابنا المكبوت في كل شيء، وذيوع الموسيقى والأغاني الصاخبة الداعية للاضطراب.
فكل هذا يهيج الأعصاب ويثير القلق، ويدعو إلى الثورة والاضطراب.
القلق وعدم الاستقرار ومشاكل العصر زادت من نسبة الانحراف، والانحراف جعل الإنسان أكثر قلقاً، لأن خطية واحدة إذا تسربت إلى قلب إنسان نزعت منه سلامه، وحيث لا سلام يملأ القلب لا يكون هناك طعم للحياة، وهل يمكن لإنسان أن يحيا بلا سلام! أليست الخطية انفصالاً عن الله، فكيف إذاً يحيا في سلام من فصل نفسه عن مصدر وإله السلام؟!
ولهذا لا تتعجبوا إن قلت لكم: إنه في أحيان كثيرة تخون الزوجة زوجها لا رغبة في الخيانة، فلو تزوجت أحد عشاقها لخانته مع زوجها، ولكن لأنها قلقة فقدت طعم الحياة ومعناها، وأصبحت لا تدين بالوفاء لأحد، فقدت الهدف والوسيلة والمبدأ.. وكل هذا جعل من حياتها سلسلة مفككة، أما عطاؤها لعشيقها فمعروف أنه لا يزيد عن لحظة جنس لأنها لا تملك أكثر من هذا، وربما تبكي بعد سقطتها، وصدقوها إن قالت إنها تخطئ بدون قصد، لأنها بالفعل أصبحت لا تعرف ماذا تريد بالضبط!
فالإنسان القلق كثيراً ما يسقط في الخطية بدون قصد، ليس رغبة في الشر ولا حباً في الخطية يسقط!! ولكن سقوطه نابع من أنه صار لا يملك القدرة على أن يخطط ويعمل عملاً منظماً، لأنه فقد هدفه وأصبح لا يعرف ماذا يريد من الحياة!!
ففي أحيان كثيرة نجد إنساناً يخرج من منزله وهو لا يعلم إلى أين يذهب بالضبط، فإذا قابله زميل ذاهب للسينما ذهب معه، وربما وهو في الطريق يتركه ويذهب مع آخر إلى المقهى، حتى يأتي شخص قد لا يعرفه ويأخذه تحت ذراعيه كحمامة قليلة الحيلة، ليجد نفسه وسط مجموعة تلعب القمار فيلعب ويخسر، وإذا عاد إلى بيته ووجد قريباً له يتعاطى الخمور يشرب حتى يسكر ثم ينام بعد يوم كامل بلا معنى، يوم لا يدري ماذا يريد فيه بالضبط، يوم ارتكب فيه عدة خطايا بلا هدف وبلا رغبة في الشر!!
يكفي لإثبات كلامي هذا ما قاله أحد الشباب عندما أراد أن يعبّر عن شعوره ويصف حالته بعد كل مرة يسقط في الخطية إذ قال: ” بعد كل مرة أمارس فيها الجنس أشعر بعدم شبع جنسي، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن شهواتي تزداد وتتضاعف فيّ، وهذا أفقدني راحتي وسلامي وجعلني أسعى بعد قليل لتحقيق لذتي من جديد، وكثيراً ما كنت أستغرق في ملذاتي ليس رغبة في الجنس، ولكن لكي أهرب من الخوف والقلق الذين كانا يعذبانني ليلاً ونهاراً عندما أكون وحدي، فالخطية إذاً هي ثمرة من ثمار شجرة القلق.
تفشي الأمراض
أجمع كثيرون من علماء النفس وكبار الأطباء بعد إجراء عدة تجارب متنوعة على مرضى كثيرين، أن النفس المضطربة الهائجة، أو الإنسان القلق كثيراً ما يقع فريسة للعديد من الأمراض النفسية والجسدية، فالقلق يضعف المعدة ويؤثر على عملية الهضم، كما أنه أهم أسباب الإصابة بالأمراض الروماتزمية والتهابات المفاصل والأعصاب، وأمراض القلب والجهاز التنفسي…
فقد قام أحد الأطباء بفحص مريض استولى عليه القلق والفزع عقب وفاة أحد زملائه واستقر في ذهنه أن مصيره سيكون مثله وهو الموت بالسكتة القلبية، فكانت النتيجة إصابته بقرحة في معدته.
وكان أحد الأطباء يعالج مريضاً بالربو في إحدى المستشفيات، وبعد أن شُفي تقرر خروجه من المستشفى صباح يوم الاثنين، ولكنه فوجئ في صباح اليوم المحدد لخروجه بعودة أعراض المرض إليه وترتب على ذلك بقاؤه في المستشفى مدة أخرى لعلاجه..
ولكن حدث بعد علاجه الذي استغرق عدة أسابيع أن حالته تحسنت فتقرر خروجه، إلا أن أعراض المرض عادت إليه مرة ثانية في صباح اليوم المحدد لخروجه مما لفت نظر الأطباء لبحث هذه الظاهرة الغريبة! فتبين لهم بعد إجراء عدة تجارب أن المريض يعمل مدرساً وقد اشتبك في مشاجرة هددته بالطرد من المدرسة، وقد استبد به القلق الذي سيطر عليه للدرجة التي كانت سبباً في معاودة المرض إليه في صباح اليوم المحدد لخروجه.
كما تبين لأحد الأطباء أن مريضاً مصابا بمرض جلدي كان يشتد طفحه كل يوم اثنين، وبعد دراسة حالته تبين أنه كان قد أحب فتاة وتقدم إليها وخطبها، إلا أن الفتاة كانت تؤجل موعد الزواج عند زيارته لها أيام الآحاد، فكانت في كل مرة تؤجل تحديد الموعد يشتد عليه المرض، ويظهر عليه الطفح في اليوم التالي وهو يوم الاثنين، عندما كان يجلس مع نفسه ويفكر في مشكلته، ولهذا عندما أراد أحد الأطباء، وقد كان مريضاً بالقلب أن يوضح تأثير القلق والاضطراب على القلب قال: ” إن حياتي في يد مجرم يثير غضبي ويحرك انفعالاتي النفسية “.
السطحية والفراغ
من الظواهر المقلقة في هذا العصر هروب الناس من العمل الجدّي، سواء في مرحلة الدراسة أو في ميدان العمل، ومع هذا يرغبون في الوصول إلى أسمى المراكز، فكيف يتحقق النجاح بدون جهد يُبذل سواء في الدراسة أو في العمل؟! صدقوني لو فُتحت جامعة الآن لتهافت الجهلاء على إدارتها، لا تتعجبوا! فالهدف لم يعد العلم أو التقدم، إنما الهدف أصبح المركز والمال.. إنها عربدة بالقيم والمبادئ.. سرقة واغتصاب لحقوق المتعلمين والمثقفين وإهمال للدارسين والباحثين.. ولهذا يجب على كل إنسان غير كفء أن يظل قابعاً في مستواه لا داعي لأن يجلس على عرش أرفع منه أو فوق مستواه!!
وبينما نرى انكباب الشباب على المعرفة في البلاد المتحضرة، نجد شبابنا قانعين بالحلول المتوسطة إن لم نقل خاملين، يشكون من الفراغ الموحش في مختلف بيئاتهم، فيلجأون إلى التسلية العقيمة لملء أوقات فراغهم، فها نحن نراه في الشوارع والمقاهي والنوادي يقضي ساعات فراغه المملة دون أن يجني منها أي ثمر، ومن هنا زادت الإدانة والنميمة وانتشرت الإشاعات…
إن كل هذا ما هو إلا هروب من النفس، والهروب من النفس دليل فقرها، إذ لولا عقم الفكر وجفاف الروح لما انقاد أبناء جيلنا إلى هذه القوقعة وهذه السلبية، فإن من يخشى مواجهة نفسه، يخشى مواجهة الموت والحياة على حد سواء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إنصافاً للشباب يجب أن نسأل: كيف للجائع أن يفكر في شراء كتاب يقرؤه؟! وكيف للمعوز أن يكون له اشتياق لبحث يدرسه؟! لا أظن أن للمطحون تحت أقدام الحياة القاسية قدرة أن يحلل أمور الحياة ويغربلها أو وقتاً للقراءة والتفكير وهم الذين يسعون من طلوع الشمس إلى غروبها بحثاً عن رزقهم.
إنها حقاً مشكلة ما أسهل حلها، لكن الكلام النظري شيء والواقع شيء آخر، وما هو نظري يحتاج لوقت لتنفيذه عملياً.
ألق نظرة على المناطق البائسة، هل يحيا الإنسان حياة إنسانية تقوده إلى إبداع فني أو اكتشاف علمي؟! إننا للأسف الشديد لا نغذي العقول بل نسجنها ونقيد حركتها ونرسم لها طريقاً واحداً: أن تكون عقولاً تابعة، أسيرة لا عقولاً ناضجة مبدعة، كيف يزدهر العقل، كيف يقوى دون غذاء؟! كيف تطلب منه أن يفكر وأنت تمده بغذاء سام يقتل فيه حركة الفكر عن طريق ما تلقيه وسائل الدعاية وأجهزة الإعلام والكتب غير الرصينة التي تعتمد على الإثارة قبل كل شيء؟!
إن ما يناله الأولاد من تعليم لا يدخل إلى قلبهم، ولهذا يجب ألا نتعجب لأن الطلاب لا يذهبون إلى المدارس إلا باشمئزاز وبدون أية رغبة في التعليم، ولا غرابة أبداً في ذلك لأن مدارس كثيرة أصبحت شركة ضخمة للتسمم العقلي الجماعي، والفوضى الأخلاقية، ولشلل حركة الذهن، والجفاف العقلي، فكلمة درس أصبحت تعبيراً عن حشو معلومات في الذاكرة بلا تنسيق أو استيعاب! ولهذا أصبحت المعلومات تؤذي أكثر مما تفيد، لأنها أصبحت إرهاقاً للذهن بالأرقام والتواريخ والأسماء التي سرعان ما تنسى بعد أداء الامتحان مباشرة!!
إن المعرفة تصير جزءاً من ذات الإنسان عندما يتذوقها، هنا تبدو الثقافة شجرة تنمو، ينبوع مياه جارية لا مستنقعاً ساكناً.
إن أردنا نهضة فكرية وعلمية حقيقية فيجب أن نعلم أطفالنا منذ الصغر كيف وماذا يقرأون، نعلمهم كيف ينقدون بدون تجريح، كيف يعارضون في موضوعية، كيف يرفضون ويحترمون ما يرفضونه، كيف يقيمون حواراً بدون صخب أو قهر، ويجب أيضاً أن نوفر لهم الأمن والسلام.. وما يحتاجونه من مستلزمات الحياة.. فيا ليتنا نتعلم من الغرب قيمة الإنسان، واحترام حريته، وفتح نوافذ الفكر الحر والإبداع أمامه..
ضعف روح الانتماء
لا يستطيع أي إنسان مهما كان أن يعيش بدون انتماء، فالفرد يستمد كيانه الاجتماعي من خلال انتمائه، ولهذا يحتاج الإنسان إلى وطن وإلى أسرة وإلى ديانة، فإذا لم يحقق هذا الانتماء سيفقد الكثير من خصائص كيانه الاجتماعي، وليس الانتماء إلى جماعة هدفاً لتبادل المنافع والخدمات أو تلبية حاجات، إنما الانتماء يهدف أولاً وقبل كل شيء أن يحقق هدفاً مشتركاً يوحد بين الجماعة… وهنا نتذكر الجماعة المسيحية الأولى التي آمنت ووحّد بينها الرجاء والصبر والألم، كما وحّد بينها هدف جوهري وهو تغيير العالم إلى الأفضل، وزرع القيم الروحية السامية وتعاليم المسيح بين الناس.
إذا وجدت روح الانتماء بين الجماعة كان التقدم والازدهار.. أما إذا ضعفت روح الانتماء ساد الاستهتار واللامبالاة وعمت الفوضى.. فالإنسان الذي يفقد انتماءه هو مثل اللاجئ، سيظل يشعر بالغربة حتى نهاية حياته، والغريب لا تهمه إلا مصلحته الشخصية فقط.
لعل الشعور بالغربة وعدم توافر أساليب الخدمة والرعاية من أهم أسباب ضعف روح الانتماء، سواء في البيت أو الوطن أو الكنيسة، فماذا يحدث لو عاش إنسان ما في مكان ليس أحد يفتقده أو يحل مشاكله أو حتى يسأل عنه؟ لابد أنه سيفقد روح الانتماء لهذا المكان ويشعر بغربة ولو كان وسط أهله، وهذا هو حال الكثيرين اليوم ممن يشعرون أنهم غرباء وهم في وطنهم.
إن نكبة اللامبالاة وعدم الانتماء ترجع إلى أن الناس لا يشعرون أن قادتهم أو المسئولين عن رعايتهم وتوفير احتياجاتهم يهتمون بهم أو صادقون في خدمتهم، إنما الحق يقال (يخدمون أنفسهم)، من هنا تتولد الحيرة واليأس ويفقدون طريقهم… وما دام الناس فقدوا الطريق فلابد لهم أن يعيشوا بلا مبادئ أو أهداف يسعون لتحقيقها.. ومعظم الذين فقدوا هدفهم في الحياة انتهى بهم الأمر إلى اليأس والخمود، ولكن بعضهم يندفع إلى اتجاهات خطيرة تؤدي إلى الهلاك، وهذا هو ما نراه اليوم واضحاً!!
الفصل الثالث أين الله في عصر القلق!
أين الله..؟ سؤال كثيراً ما يتردد على ألسنة المتألمين الذين أضعفت التجارب إيمانهم.. فما أكثر القلوب الجريحة المضطربة التي تريد أن تقذف ما بداخلها من ثورة وبركان، فتأتي ثورتها ضد الله كما لو كان الله هو مصدر البلايا والشرور والأحزان!
الله موجود، هذه حقيقة لا ينكرها إلا الملحدون، وليس في الكون نقطة واحدة إلا الله موجود فيها، فهو الذي ” مجده ملء كل الأرض” (إش 6:3) هو الداخل في كل شيء والخارج عن كل شيء، وهو أقرب إليك حتى من نفسك، إنه يخاطبك لكنك لا تسمعه بسبب ضجيج أفكارك ورغباتك الهائجة، ولو كان لك عين روحية لكنت تراه في لمعان النجوم!
أما آلام هذا الدهر فليست من صنع الله، كل مشاكل الحياة أوجدها الإنسان، فالله لم يخلق الشر إنما الشر وجد عندما ابتعد الإنسان عن الخير، فمنذ أن سقط آدم انفتح باب الجحيم وانبثق شعاع الألم ليرسم صورته الحزينة على وجوه البشر، كل البشر، أما جرثومة الإثم فانتشرت في كيان الإنسان حتى إن الجميع بلا استثناء ” أخطأوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله ”
(رو 3:3).
لكن رغم تمرد آدم وعصيانه وجرمه الشنيع، إلا أن الله هو الذي بادر على حل المشكلة ووعد آدم بأنه سيرسل ابنه الحبيب
(نسل المرأة) إلى العالم ليسحق رأس الحية التي أضلتنا وأغوتنا. ويعالج مشكلة السقوط العظيم، وقد أوفى بوعده في المسيح
يسوع..
وهذا إنما يدل على عطف الله وتحننه، فقبل أن يخلق الإنسان وهو موضع حبه، فإن كان الله قد أحبك منذ الأزل فواضح أن محبته ستدوم إلى الأبد، ألم يقل إرميا النبي بفم الله ” محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة ” (إر3:3).
ممكن وبسهولة أن يمحو الله الشر ويقضي على الأشرار في العالم ليعيش الناس في سلام كما يتراءى للبعض، وقد حدث ذلك مرة أيام نوح فعندما كثر شر الإنسان وتلوثت الأرض بالفساد وأراد الله أن ينظفها أنزل عليها ماء الطوفان، فمات الأشرار وتنقت الأرض واغتسلت من قذارتها، ولكنها عادت وتلوثت من جديد، فالمشكلة إذن في أعماق الإنسان، والإنسان ” كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم ” (تك 6: 5).
ولهذا في مثل الزوان عندما طلب العبيد أن يذهبوا ويجمعوا الزوان من بين الحنطة، رفض السيد من أجل نمو الحنطة فإذا قلعوا الزوان ربما قلعوا الحنطة معه (مت13: 30) كما أن وجود الحنطة بين الزوان له فوائده، وإن لم يوجد بين الحنطة زوان فصدقوني سوف يخرج من القمح زوان، فهل كان في الفردوس زوان؟! ألم يخرج الزوان من آدم!
فلا يزعجنك وجود الخطاة في العالم وتحكمهم في المؤمنين، فليس الأشرار الذين يقلقوننا ويعبثون بحياتنا سوى كومة من التبن كما يقول القديس أغسطينوس، أما أنت فحبة حنطة، فإن كان التبن يغطيك ويخفي ملامحك ويكتم على أنفاسك، فثق أن يوم التذرية قريب، سيأتي يوم الدينونة الرهيب، حينئذ سُيرفع التبن عن القمح ويُحرق بالنار..
فتحمّل أيها الحبيب ضغط التبن عليك، ولا تبتعد عن البيدر الذي هو الكنيسة، لأنك إن كنت حنطة خارجاً عن البيدر، فسوف تأكلك الطيور.
ربما تهيج وتضطرب في كل مرة ترى فيها الأشرار يتنعمون بالخيرات والأبرار يرزحون تحت ثقل المصائب والضيقات، وتقول في نفسك: أهذا عدلك يا رب أن يسعد الأشرار ويشقى الأبرار؟ فيجيبك الله: وأنت أهذا إيمانك؟ هل وعدتك بهذه الأشياء؟ هل صرت مسيحياً لكي تتنعم في حياتك؟ ألم أقل لكم في العالم سيكون لكم ضيق؟ ألم تقرأ كلامي عن الباب الضيق؟!
فلا تنظر إلى ما يسمح به الله للأشرار، بل أنظر دائماً إلى ما يحتفظ به للأبرار.
هل سمعت عن أيوب؟ لا أظن إنساناً أصابته بلايا مثل هذا الرجل! لقد حدث انهيار كلي حوله، مقتنياته كلها أُبيدت، أبناؤه السبعة وبناته الثلاثة ماتوا جميعاً، ولم تقف التجربة عند حد المقتنيات والبنين بل امتدت إليه، فضُرب بالقروح الرديئة من باطن قدمه حتى هامته.. لقد صار الغني فقيراً، والسيد ها هو أقل من أدنى العبيد، ويبقى السؤال: ماذا فعل أيوب حتى تصيبه هذه البلايا؟ مكتوب عنه أنه ” كان رجلاً كاملاً ومستقيماً يتقي الله ويحيد عن الشر” (أى1:1)، ومع ذلك نال من العذابات ما لا تقوى الأُذن على مجرد سماعها حتى ظن البعض أن قصة أيوب أُسطورة من نسج الخيال!
لقد تألم أيوب حقاً، لكن الله لم يتركه، أثناء التجربة كان التخلي يبدو واضحاً.. لكن من يقرأ خاتمة سفر أيوب يرى أن الله بارك آخرة أيوب أكثر من أولاه، وأعطاه نفس الأولاد الذين فقدهم في التجربة، ثلاث بنين وسبعة بنات…(أى42).
والآن لنسمع ما يقوله أيوب عندما تكثر مصائبك: ” طوبى لرجل يؤدبه الرب، فلا ترفض تأديب القدير لأنه هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان، في ست شدائد ينجيك وفي سبع لا يمسك سوء، في الجوع يفديك من الموت وفي الحرب من حد السيف ” (أى5: 17- 21).
قد لا نفهم الله أثناء التجربة، بل وكثيراً ما نعترض على سياسته وأحكامه لأن ظلام الألم يحجب كل شيء عنا، لكن ما أن تمر الضيقة تتجلى أمامنا الحقيقة بكل وضوح، عندئذ لا يحق لنا إلا أن نقول ” ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء “ (رو11:33).
هنا أتذكر قصة سمعتها وإن كانت تميل للخيال إلا أنها تعبر عن طبيعة البشر المتذمرة، التي كثيراً ما تعترض على سياسة الله دون أن تعرف حكمته، أما القصة فتقول:
كان رجل دائم التذمر على الله، كثير الانتقاد لأعماله، ففي إحدى الليالي ظهر له ملاك وقال له: غداً سيأتي إليك شخص فاخرج معه وتأمل فيما يحدث ولكن لا تعلق على شيء مما ترى، ففي الصباح طرق بابه إنسان فرحب به ثم خرج معه ودخلا بيت رجل فقير لم يكن يملك سوى ملعقة ذهب، فأكرمهما الرجل على قدر طاقته، لكن الرجل بدلاً من أن يكافئه سرق من عنده الملعقة الذهب وخرج دون أن يقول له كلمة شكر!
ثم ذهبا بعد ذلك لرجل غنى لم يرحب بهما بل احتقرهما، لكن الرجل أعطاه الملعقة الذهب هدية له! ثم ودعه ودخلا كوخ رجل رحب بهما لكنه وهو خارج أشعل ناراً فاحترق الكوخ وكل ما كان بداخله! ثم دخلا بيتاً كان صاحبه لا يملك سوى ابن ومن شدة كرمه واحترامه أرسله معهما ليعّرفهما الطريق، لكن على غير المتوقع أمسك الرجل بالطفل وأغرقه في البحر، كل ذلك يحدث والرجل في صمت وذهول! ولم يهدأ إلا بعد أن أخذ الرجل الآخر يفسر له هذه المواقف الغريبة، فماذا قال له؟
الرجل الأول الذي دخلنا بيته تقياً لكن الملعقة الذهب التي كانت عنده اشتراها من رجل سرقها من عند الملك، ورجال الملك الآن يبحثون عنها في كل مكان وسيقتلون من يجدوها عنده، ولهذا السبب سرقت الملعقة من عند الرجل التقى الكريم وأعطيتها للرجل الشرير البخيل الذي أهاننا حتى إذا وجدوها عنده يقتلونه فيموت بشره، والرجل الثالث الذي حرقنا كوخه كريماً وأراد الله أن يعطيه مالاً ليحسن به على الفقراء، ولهذا حرقت الكوخ لكي عندما يحفر لوضع أساس بيت جديد يجد تحت الكوخ كنزاً مخفياً يستخدمه في أعمال الخير ومساعدة المحتاجين، أما الرجل الرابع الذي أغرقت ابنه فالله بعلمه السابق يعرف أن الطفل كان سيعيش في الفساد ولهذا أراد أن يحفظ اسم أبيه إلى الأبد طاهراً فأمات الابن حتى لا تتلوث سمعة الأب.
فصمت الرجل المتذمر ولم يقل سوى آية معلمنا بولس الرسول ” ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء “. أليس النحات لكي يصنع تمثالاً جميلاً يكسر ويثقب في المرمر بالمطارق والأزاميل؟ ألا يستخدم الرسام اللون الأسود، بل ويضيفه إلى الألوان الأخرى الهادئة الجميلة لتخرج أيقونته كما يريد؟ هكذا الله أيضاً كثيراً ما يستخدم أزاميل التجارب وسواد الأشرار حتى تظهر صورة الأبرار في أروع منظر لها.
فلا تقل أين الله عندما أتألم؟ لأن الله معنا، موجود في وسطنا، ويعرف كل احتياجاتنا، ألم يقل رب المجد ” ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر” (مت 20:28). إنه معنا في أحزاننا كما هو معنا في أفراحنا، قد لا يبعد عنا الضيقات، ولكنه يعطينا القوة حتى نجتازها، وإن كان في بعض الأحيان يبدو ساكتا، إلا أنه كما قال الكتاب ” يسكت في محبته ” (صفنيا 17:3).
لم يعطنا الله وعداً بأن تكون سماء حياتنا خالية وصافية من الغيوم، بل أعطانا وعدا بأنه سيكون معنا بصفة مستمرة ” كل الأيام ” ” فإن كان الرب معنا فمن علينا ” (رو31:8)؟!
يحدثنا الكتاب عن الأرض في بداية خلقتها فيقول ” كانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة ” لا ننكر أنها صورة كئيبة تصور لنا حال الكون في بداية تكوينه، لكن الله رفض الخراب والظلام فماذا فعل؟ خلق أولاً النور ليكون شعاعاً يسقط على الأرض فيعطيها جمالاً، ثم بدأ يخلق الأشجار والزهور والبحار.. لتتحول الأرض الموحشة إلى أيقونة جميلة تعلن لنا عن عظمة وإبداع الخالق.
ونحن بلا شك نمر بأوقات نشعر فيها بأن حياتنا خربة وخالية ومظلمة كما كانت الأرض في بداية تكوينها، لكن يجب إلا ننسى أن الأرض وهي في صورتها الكئيبة هذه كان روح الله يملأها ” وروح الله يرف على وجه الغمر” (تك 1: 2) كما أن الظلام والخراب لم يدم كثيراً إذ خلق الله النور ” وقال الله ليكن نور فكان نور” (تك 1: 3) فالله قادر أن يحول ظلام حياتك إلى نور والخراب إلى حياة جميلة مليئة بالثمار.
لابد من ظلام التجارب والضيقات، لابد من ضباب الفشل.. المرض.. الفقر.. لابد أن تصدم أمواج الشر سفينة حياتنا، فقد قال رب المجد ” في العالم سيكون لكم ضيق ” ولكن ما أجملها عبارة تلك التي قالها بعدها ” ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم ” (يو16: 33)، وهذا إنما يعطينا قوة أن نقاوم أمواج الشر في بحر هذا العالم.
وإن كنا لا نملك درعاً سحرية تحمينا من التجارب والضيقات إلا أننا نملك إيماناً قوياً: إنه لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا عري ولا خطر ولا سيف يمكن أن يفصلنا عن محبة المسيح، لأننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا ”
(رو 8: 35- 37).
ماذا رأى القديس يوحنا في جزيرة بطمس؟ باباً مفتوحاً في السماء وأيضاً عرش الله موضوعاُ فيها (رؤ4: 28) وما هذا إلا إعلان أن الله موجود وباب السماء قد فُتح وسيظل هكذا إلى الأبد مفتوحاً حتى ولو أُغلقت باقي الأبواب، فإذا أُغلقت أبواب الحياة فارفع عينيك إلى السماء فستجد باباً مفتوحاً وإلهاً جالساً على عرشه فاتحاً ذراعيه لاستقبالك، فلا تهتز ولا تفقد ثقتك في إلهك، فالله هو أمس واليوم وإلى الأبد.
هل تأملتم مرة في إله الكون وهو ينزل إلى هضاب ووديان حياتنا ليرعانا! إنه راعينا الحنون رب المجد يسوع الذي يقوينا بنعمته ويرشدنا بتعاليمه إلى طريق خلاصنا، إن سرنا في الوادي المظلم فهو معنا، وإن نمنا في العراء نام معنا ” إنه راع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ”
(إش40: 11).
هل تشك أن راعينا يحرس خرافه؟ هل تشك أنه واقف بالمرصاد لذئاب العالم حتى لا تخطفها؟ ألم يضع المسيح راعينا نفسه من أجل خرافه؟ فكيف إذاً تشك في عناية الله ورعايته!! فالله قريب منك ولكن أنت البعيد وأنت الذي لا تراه لأن ظلام الضيقات حجب صورته عنك.
إن أعداد النجوم في وقت الظهيرة، هي نفسها الموجودة في منتصف الليل، حتى وإن كنا لا نراها في بعض الأوقات.
قرأت مرة عن رجل كان يتألم في حياته، ففي إحدى الليالي رأى في نومه حلماً، تُرى ما هو هذا الحلم؟ رأى نفسه يسير في الطريق والرب يسوع كان يسير معه، وبينما هو سائر نظر للخلف، إلى حياته، التي ارتسمت أمامه كعلامات ظاهرة على رمال شاطئ البحر، وكما هو معتاد عندما يسير اثنين معاً ظهرت مجموعتان من الأقدام، قدمان تخصه وقدمان للسيد المسيح، ولكنه عندما أمعن النظر رأى مجموعة واحدة من قدمين فقط ولا سيما في الأماكن الوعرة، وهنا اضطرب فسأل الرب قائلاً.. أنظر يا سيدي هناك، لقد سرت معي طويلاً في حياتي ولكن أين ذهبت؟ لقد كنت محتاجاً إليك في مثل هذه الأوقات أكثر من غيرها، فلماذا تركتني؟ فقال له الرب.. يا ابني لم أتركك قط، وعلامة القدمين هذه إنما تؤكد لك ذلك، كانت هناك أوقات أصعب مما تحتمل أنت فكنت أحملك على ذراعي.
إن علامات القدمين التي تراها في الأماكن الوعرة هي لي، عندما كنت أحملك على ذراعي أو آخذك بين أحضاني.
لا ننكر أن هناك أوقاتاً كثيرة قد ينسحب فيها الله من حياتنا، لا لشيء إلا لتقويتنا واختبار قوة إيماننا، إنه يريد أن تثق فيه وأنت في ظلام التجربة، فإن رفعت بالإيمان قلبك لنظرت يده ممدودة لإعانتك وذراعيه مفتوحتين لاستقبالك، فنحن منقوشون على كفه نقشاً لا يمحى إلى الأبد، وإن نسيت الأم رضيعها ربى لا ينسانا، وكيف ينسانا من أحبنا وبذل ذاته من أجلنا.
هو يساعدنا وملائكته تحيط بنا وتحمينا ” فملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم ” (مز34: 7) وأعتقد أن كثيرين يتذكرون كيف نجاهم الرب من حادث مروع أو حل لهم مشكلة عسيرة بطريقة معجزية، فملائكة الله تأتى إلينا ببركات معجزية، مثل شيك البريد بنفس المبلغ الذي نحتاجه.
قرأت قصة عن رجل نجا وحده من حطام سفينة غارقة ووجد نفسه في جزيرة مهجورة، هناك تمكن من بناء كوخ وضع فيه كل ما أمكن إنقاذه من الحطام، وكان يصلي لله لكي يرسل إليه نجدة لإنقاذه، وطوال اليوم كان يتطلع إلى الأفق لعله يلمح سفينة عابرة، فلما لم يجد عاد إلى كوخه فرأى الكوخ وقد اشتعلت فيه النيران بسبب شعلة كان قد أشعلها ونسي أن يطفئها فسقطت وأشعلت النيران في الكوخ وأفنت كل مقتنياته، لا شك أنها كارثة أحزنت قلب الرجل، وجعلته ييأس من الحياة، فلا مفر من الموت إذاً، وبالفعل جلس الرجل منتظراً لحظات موته بين الحين والآخر، وفجأة بعد وقت قصير من إشعال الكوخ وعلى غير المتوقع وصلت سفينة ورست قرب الكوخ! ماذا حدث؟ عندما اشتعلت النيران لمح قبطان السفينة منظرها فأسرع إلى مكانها إذ ظن أنها علامة يريد أحد أن يستنجد بها، هذا ما رواه القبطان للرجل عندما تحدث إليه! فسجد الرجل على الأرض وقدم الشكر لله من أجل النار التي كانت سبباً في نجاته فلولا حريق الكوخ ماجاءت سفينة النجاة لتنقذ حياة الرجل.
هذا هو الله الذي كثيراُ ما ننسى إحساناته، وفي أحيان نعترض ونتذمر على أحكامه.
الفصل الرابع: كيف تحيا كمسيحي في عصر القلق؟
ما من إنسان إلا وعانى من القلق، ربما لحادث مؤلم تعرّض له، أو تعرّض له أحد أقربائه أو أصدقائه، وربما عقب فشل دراسي أو زواجي، أو فشل في مشروع ما، فإن واجهتك مشكلة، لا تقابلها بالانطواء أو الكبت أو بالانتقام من نفسك.. لأن الانطواء يزيد الإحساس بالمشكلة، والكبت ما هو إلا وسيلة هروبية لا تحل مشاكلنا وغالباً ما ينتج عنه أمراض نفسية، أما الانتقام من النفس فيفقد الإنسان احترامه.. إنه يدمر الإنسان خاصة وإن كانت وسائل الانتقام كالسكر أو المخدرات…
إن مثل هذه الوسائل ليست مجدية لمواجهة تحديات العصر، ولها كثير من النتائج السلبية، ولهذا فإن أفضل وسائل الانتصار على القلق هي الآتي:
مواجهة النفس
إذا وجدت نفسك خائفاً.. مضطرباً.. غير مستقر.. فاسأل نفسك لماذا أنت قلق؟ ربما يكون قلقك ناتجاً عن سقوطك في خطية، فواجه نفسك وحدد أسباب السقوط، هل كان بسبب ضعف الروحيات والبعد عن الله؟ أم بسبب أصدقاء السوء؟ أم أن سقوطك نتج لكثرة اختلاطك بالبنات وعدم الاحتراس في معاملتهن؟ أم أنك سقطت لتجرب وتختبر لذة الخطية؟ أم سقطت بجهل مثلما يقول البعض ضحكوا علينا؟
عندما واجه الابن الضال نفسه وفكر في حالته وما وصل إليه من انحطاط شعر بأمور عظيمة، فتمثلت أمام عينيه حالة الفقر والجوع التي وصل إليها ثم عادت إلى مخيلته صورة المجد والغنى الوافر في بيت أبيه، ولهذا قال ” كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعاً ” (لو15:17) كذلك شعر بجرم خطيته التي ارتكبها عندما ترك بيت أبيه وهذا دفعه أن يقول ” أقوم وأذهب إلى بيت أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه…” ويقيناً لو لم يجلس الابن الضال مع نفسه وواجه مشكلته ما كان قد وصل إلى حياة التوبة والانسحاق، ولا كان قد رجع إلى أبيه، ولا كان قد خرج من قبضة الشيطان إلى حيث لبس الحلة والخاتم…
إن تحديد أسباب المشكلة من أهم عوامل التغلب عليها، فحاول أن تحدد أسباب قلقك ثم حاول أن تضع حلاً لكل سبب على حدة، وفي نفس الوقت لا تكبت مشاعرك، بل اكتشف الوسائل التي تساعد على التعبير عن أحاسيسك الداخلية بممارسة هوايات كثيرة كالرسم مثلاً أو الرياضة أو الموسيقى أو القراءة والكتابة.. فمعظم أعمال الفنانين جاءت تنفيثاً عما في أعماقهم من أشياء مختزنة وكانوا غير قادرين على إعلانها…
فمثل هذه الهوايات أشبه بالقارب الصغير الذي كان يلقيه البحارة في البحر لينجوا من افتراس الحوت، فمن تقاليد البحارة قديماً أنهم إذا صادفوا حوتاً ضخماً في البحر أن يلقوا إليه بقارب ليشغلوه عن مهاجمتهم ثم يحاولون صيد الحوت وهو منشغل بمناطحة القارب..
وهذا ما ينصحك به علماء النفس أن تلقي لحوت همومك قارباً فارغاً يشغلها عنك ويشغلك عنها إلى أن تنجح في اصطيادها والقضاء على أسبابها وأقصر الطرق هو الثقة بالنفس ونسيان التجارب الأليمة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والهوايات المختلفة والخدمات الكنسية…
يقول الكاتب الشهير (برناردوشو) ” إن سر الإحساس بالتعاسة هو أن يتوفر لك الوقت لتتساءل هل أنت شقي أم سعيد؟ ” وقد وضع الأمريكي (كارنيجي) روشتة للتغلب على القلق والأحزان والهموم فيقول ” انشغل وابق منشغلاً دائماً … لا تحزن على ما فات … لا تبالغ في الخوف والاهتمام بما سيأتي ” ويؤكد منهجه هذا قائلاً ” إن من مبادئ الطبيعة.. أن الطبيعة ضد الفراغ، فلو أنك ثقبت مصباحاً كهربائياً مفرغاً من الهواء فإن الهواء يتسلل إليه فوراً ويملأ كل فراغه، وكذلك عقل الإنسان إذا خلا مما يشغله تسللت إليه الهموم وتمكنت منه “.
وفي كتاب اسمه (فن نسيان الشقاء) للمؤلف الأمريكي (جون كوبر بويز) يؤكد أنه عندما يستغرق الإنسان في العمل يتسلل إليه الإحساس بالاطمئنان والسلام النفسي وينسى موقتاً أحزانه ويخمد لهيبها بعد حين، وبجانب شغل فراغك بالعمل والهوايات النافعة، يفيدك أيضاً شئ هام وهو التعبير عن أحاسيسك ومشاعرك الداخلية مع صديق حميم تثق فيه أو أحد المرشدين والأفضل أن يكون أب اعترافك خاصة إذا كنت تحبه وترتاح إليه.
ضع في اعتبارك على الدوام أن الحياة انتصارات وهزائم.. مكاسب وخسائر.. أفراح وأحزان.. والعاقل من لا يسمح لهزائمه الصغيرة أن تزلزل حياته، وهذا ما أكده الكاتب العظيم (شكسبير) في مسرحيته الرائعة (عطيل) عندما قال: ” إن الرجل الذي يسرقه لص فيبتسم ترفعاً يسترد من السارق بعض غنيمته، أما من يحزن بلا طائل فإنه يسرق نفسه مرة أخرى بعد أن سرقها اللص، لأنه يضيف إلى خسارته المادية خسارة معنوية جديدة لا تقدر بثمن “.
والحياة أيضاً مد وجزر، أمواج متصاعدة تقتحم شاطئها تتبعها أمواج متراجعة إلى عمق البحر، والإنسان الناضج هو من يتفهم فلسفة الحياة فلا يتكبر عند المد ولا ينهار عند الجزر، بل تكون حياته واقعية، ملتزمة، إيجابية على الدوام، فإذا خسرت فابدأ من جديد ولكني أنصحك أن تبدأ بالألف وليس بالياء، أولاً
(أ) ثم (ب) ثم (ت).. وتأكد أنك في يوم ما ستصل إلى آخر حرف وهو حرف الياء.. أما إذا تزاحمت حولك المشاكل فهيء نفسك لقبول أسوء الاحتمالات إذا لزم الأمر، ولا تنسَ أننا نحيا في أرض الشقاء وسعادتنا الكاملة لن تكون إلا في السماء.
ذهب شاب ذات يوم إلى فيلسوف ليسأله عن سر السعادة فطلب منه الفيلسوف أن يأتي معه إلى مزرعة للخنازير كانت توجد بجوارهم، فلما وصلا بدأ الشيخ الوقور في الانحناء والبحث في التراب، فتعجب الشاب وسأله ماذا تفعل يا سيدي؟ فأجابه الفيلسوف قائلاً ” إنني أبحث عن الذهب ” فازدادت حيرة الشاب وتعجبه فقال له ” هل تبحث عن الذهب في مزرعة للخنازير؟ ” فرد الشيخ بهدوء ” إن كنت قد تتعجب من بحثي عن الذهب في غير مكانه أفلا يحق لي أن أتعجب منك وأنت تبحث عن السعادة في أرض الشقاء؟
يقول القديس باسيليوس
” أما الآن في أرض الشقاء فلا توجد سعادة كاملة على الأرض لأنها سرعان ما تشتبك مع الأحزان، الزواج مع الترمل، الولادة مع الموت، الشرف العظيم مع العار، الصحة مع المرض”.
لا تلعن الظلام
ماذا لو انقطع التيار فجأة ووجدت نفسك داخل حجرة مظلمة؟ لابد أنك ستضيئ شمعة حتى يتلاشى الظلام، أما الشمعة التي يمكنك أن تبدد بها ظلام القلق فهي الإيمان، فكل عادة ذميمة يمكنك التخلص منها، وكل مشكلة عسيرة يمكنك أن تحلها إذا كان لديك إيمان، أي تؤمن أنك قادر أن تحطم كل حجر ضخم يسد باب الرجاء قدامك، فكل ما تؤمن بأنك قادر على تحطيمه فإنك ستحطمه، ألم يقل الكتاب “كل شيء مستطاع للمؤمن ” (مر9: 23)!
إن الإيمان يحوّل نسيج الجسد من مادة مؤقتة تشيخ إلى معنى روحي خالد.. ويحول واقع الإنسان الأليم الذي يمتزج فيه الحزن بالفرح، والشقاء باللذة، والنور بالظلام، والجمال بالقبح، إلى معنى لا يموت وإلى سمو وارتقاء لا يفنيان.
بالإيمان يصبح العالم غير ماءت، ويصبح الإنسان في حماس دائم للحياة، وكأن الحياة تتحول بالإيمان إلى لحظات من النغم المتصلة والسعادة الدائمة.
هل ينكر أحد أن الإيمان يحوّل الألم إلى رغبة وشوق في معرفة المزيد من أسرار الذي تألم وهو بار!! رب المجد يسوع الذي بآلامه قدس الألم وأعطاه معنىً جديداً.
والموت أليس الإيمان يحوله إلى رحلة لاكتشاف عالم جديد، عالم الخلود الخالي من الغش والرياء!! إن الإيمان يجعل كل العلوم التي نعرفها ونكتشفها ونسعى إلى إدراك أسرارها ما هي إلا مقدمات لشرح السر الأعظم، سر الحياة بعد الحياة.
على ظهر مركب جلست سيدة وقورة كانت مسافرة لزيارة ابنتها، لكن في منتصف الطريق حدث أن هاجت الأمواج فجأة وقامت عاصفة شديدة، اهتز لها القارب حتى كاد أن ينقلب، فتجمع الركاب في وسط المركب وعلا صراخهم، وأخذهم الفزع، ومنهم من أخذ يسب الظروف ويلعن حظه.. أما السيدة فظلت جالسة في مكانها ساكنة خاشعة يرتسم على وجهها ابتسامة هادئة بينما تردد شفاتها كلمات صلاة هامسة، فاستجاب الله لصلاتها وهدأت الرياح ولما استقر القارب وهدأت النفوس اتجه البعض إلى السيدة الهادئة وقالوا لها: كيف احتفظت بهدوئك ونحن نواجه موتاً محققاً! فقالت السيدة في إيمان شديد: الواقع أن الموت كان سيغير البرنامج قليلاً لكنه لم يكن سيعطل خطتي، فأنا كنت ذاهبة إلى ابنتي المتزوجة في زيارة قصيرة، ولكن لي ابنة أخرى توفيت منذ سنوات، فلو أن القارب انقلب بي لكنت الآن أزور ابنتي الأخرى التي هي الآن وديعة في يد الله بدلاً من ابنتي الحية على الأرض.
إنه الإيمان بأن الله قادر أن ينقذنا جميعاً مما يتعبنا، حتى وإذا تركنا فيما لا نريده فهو يعطينا القدرة على الصبر والاحتمال، بل ويعطينا النعمة لتتحول الضيقات إلى بركات والأحزان إلى أفراح، ألم يحفظ الإيمان دانيال عندما أُلقى في جب الأسود! والثلاثة فتية ألم يحفظهم الإيمان من لهيب النار عندما أُلقوا في الآتون فلم يصبهم ضرر! ويوسف الصديق أليس بسبب إيمانه حفظه الله في السجن وخرج منه ليصير ثاني رجل في مملكة مصر بعد فرعون!
ضع في اعتبارك دائماً، أن الله الذي أعطاك الحياة هو الذي سيعطيك الطعام الذي تحيا به في هذه الحياة، وإذا كان الله أعطانا الجسد فلابد أنه سيعطينا ما نلبسه فوق الجسد، ويعطينا أيضا صحة الجسد، ولكن هذا لا يلغي المشاكل والأحزان والتجارب والضيقات، فالمسيح لم يقدم لنا طريقاً مليئاً بالورود، لكنه قدم لنا طريق الصليب، وكل من يريد أن يتبعه عليه أن ” يحمل صليبه ويتبعه ” (مت 16: 24).
ولهذا فإن المسيحية لا تقول للفقير ليكن لك إيمان أن الله سيغنيك لكنها تقول له: إن الله قد يغنيك إذا كان ذلك لخيرك، ولكن لنفرض أن الله لم يرسل لك مالاً فما الذي يقلقك من هذا مادامت عنايته تشملك! وتقول للخائف من المرض والموت قد تمرض وتموت ولكن ما الذي يخيفك من هذا ما دامت لك الحياة الأبدية!
اقطع أغصان الهموم الصغيرة
ماذا تفعل لو أردت قطع شجرة كبيرة؟ لابد أولاً أن تقطع الأغصان الصغيرة ثم الأكبر وبعد ذلك الجزء الأعلى وأخيراً الجذع، أما إذا بدأت بقطع جذع الشجرة الكبير أولاً قبل الأغصان فسوف تسقط الشجرة على الأشجار المجاورة لها وتحطمها وربما تسقط على إنسان وتميته.
أيضاً شجرة القلق الضخمة التي ترعرعت داخل عقلك على مر سنين كثيرة يمكن معالجتها بقطع أغصانها أولاً إلى أن تصل للجذع، فمثلاً تجنب التعبيرات الدالة على القلق، وقلل من الكلمات التي تشير إلى الخوف والاضطراب… في أحاديثك، بل لا تشترك أبداً في أي حديث عن القلق، إنما ليتخلل الكلام عن الإيمان والرجاء كل أحاديثك.
احفظ بعض الآيات التي تعزيك وتقويك كقول معلمنا داود ” إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي”
(مز23:4) “إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي وإن قام على قتال ففي هذا أنا مطمئن” (مز27: 3) ” لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها ” (مت 10: 28).
بهذه الطريقة سيمتلأ عقلك بأفكار الإيمان والرجاء والشجاعة.. فعملية طرد أفكار القلق لها أهميتها، وإن لم تطردها بالتأكيد ستسد عقلك وتعطل فيض القوة العقلية والروحية داخلك، لأن أي فكر إذا ظل مدة طويلة في عقلك من السهل أن تنفذه وتعمل به، وقد أكد الكتاب هذه الحقيقة بقول أيوب ” لأني ارتعاباً ارتعبت فأتاني والذي فزعت منه جاء عليّ ” (أى3: 25).
كما يجب أن تكون إيجابياً مع أفكارك، فإذا عُرض عليك عمل ما لا تقل ” لن أستطيع إنجازه “، بل قل ” أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني”، وإذا جاءك فكر يقول لك ” غداً سيكون لك يوم مشئوم ” قل ” لا، بل سيكون هذا اليوم أفضل من أمس وما قبل أمس “.
أراد رجل أن يبني شاليه على شاطئ أحد البحار، فأحضر عمالاً وبدأوا بالفعل في وضع الأساس لبناء الشاليه، لكن حدث أن هبت الرياح وهاجت الأمواج فتغطى الأساس بالوحل لأنه كان قريباً من الشاطئ، فلما رأى العمال هذا المنظر أصيبوا باليأس وتألموا على ما نتج من خسائر واعتقدوا أن هذا اليوم (يوم مشئوم)، ولا يجب العمل فيه، أما صاحب الشاليه لما نظر حزنهم التفت إليهم وقال: أنا أرى الوحل قد غطى كل الأساس وهذا ما أنتم ترونه أيضاً، ولكني أرى شيئاً آخر لم تنظروه ولم تلتفتوا إليه، فأنا أرى الشمس موجودة في السماء وستسطع بأشعتها بعد قليل وتجفف الوحل، فلنستعد من الآن لنبدأ العمل من جديد.
فحاول أن تستأصل الهموم الصغيرة من حياتك حتى تصل إلى الجذع الرئيسي للقلق، فبهذه الطريقة تستطيع أن تنزع عادة القلق بسهولة من حياتك، وأيضاً كل العادات والأفكار الذميمة.
أهمية النظرة الإيجابية
كلنا نعرف سلبيات القلق التي تصل إلى درجة الإصابة بالكثير من الأمراض النفسية والجسدية، ولكن هل فكرت مرة في اتخاذ موقف إيجابي من المواقف التي تضايقك لتتخلص من القلق؟
الموقف الإيجابي باختصار هو: تحويل كل ما يتعبك ويجعل القلق يتسرب إلى حياتك إلى وسيلة بنّاءة تقوّم بها نفسك وتؤمّن بها مستقبلك، فالطالب قبل الامتحان كثيراً ما يقلق خوفاً من الرسوب، فإذا استسلم للقلق لرسب، أما إذا اتخذ من القلق وسيلة لمضاعفة جهده حتى يحصل على نتيجة أفضل، فلابد أنه سينجح، بل ويتفوق! وربما تُكلّف بأعمال تخشى إنجازها، لكنك لو اتخذت القلق وسيلة إيجابية تجعلك تلتزم بمواعيد وتنهي المهام الموكولة إليك في ميعادها المحدد لأنجزت، بل وأبدعت في كل ما يوكل إليك أو تكلف به.
حاول أن تتخذ من القلق وسيلة إيجابية تحثك على البحث والاكتشاف، عن أفضل الوسائل لمواجهة أزماتك، فداود عندما وقف أمام جليات الجبار ليحاربه بكل تأكيد كان قلقاً، ليس خوفاً منه، ولكن من أجل كثرة التفكير في معرفة أفضل الوسائل التي يمكن أن ينتصر بها على عدوه الشرس، فغالباً ما تساءل قائلاً:
كيف أتغلب على هذا الوحش؟! ما هي أهم نقاط ضعفه؟! ما أنسب الوسائل لبدء الهجوم عليه؟!
وبعد تفكير اهتدى إلى أن الدخول في مبارزة بالسيف والرمح مع رجل بمثل هذا الجبروت وسيلة مصيرها الفشل، لابد إذاً من استخدام وسيلة لم تخطر على باله من قبل، والمقلاع والحجارة فكرة بسيطة ولكنها جديرة بالتنفيذ، وأفضل مكان تصوب إليه هو جبهة ذلك الفلسطيني فهي الجزء الوحيد غير المحصن والذي إذا أُصيب كانت الإصابة في مقتل، فلو كان قلق داود قاده إلى التردد والهرب لقتله جليات قبل أن يهرب، ولكن لأنه استخدم القلق إيجابياً واتخذه وسيلة تقوده إلى التفكير في أفضل الوسائل التي يمكن أن يقضي بها على هذا الجبار انتصر ونزع العار عن بني إسرائيل (مز151).
تطلع دائماً إلى العظماء
ولعل أعظم العظماء الذين عاشوا على الأرض هو رب المجد يسوع، أنظر إليه وتأمل في حياته، كيف عاش، كيف واجه الحياة بكل مشاكلها، ماذا فعل عندما شُتم أو ضُرب أو صُلب؟ لقد احتمل المسيح كل آلام الحياة القاسية بشكر وصبر دون أن يتذمر أو يفقد إيمانه، لأنه كان يعرف جيداً حقيقة العالم المرة وطبيعة البشر الخطاة.
هناك أيضاً عظماء من نفس طبيعتنا البشرية، قهروا اليأس وانتصروا على تحديات العصر، أنظر إلى سيرتهم وتعلم من أسلوب جهادهم، هل سمعت عن (هيلين كيلر) معجزة القرن العشرين! لقد ولدت طفلة جميلة، تتحرك وتضرب بيديها وقدميها وتصرخ كسائر الأطفال.. وتحكي لنا أمها أنها أيضاً كانت ذكية بل كانت أكثر ذكاءً من باقي الأشقاء، لكن هذه الطفلة الجميلة تمرض في شهرها التاسع وتفقد مرة واحدة البصر والسمع والنطق! لا ننكر أنها صارت موضع حب وعطف الجميع، لكنها في نفس الوقت صارت موضع تساؤلهم، ما هو مصيرها في الحياة؟! كيف ستواجه المجتمع وهي تعاني من ثلاث عاهات؟!
لكن لا يأس مع الحياة، فالإيمان والإرادة يغطيان كل ثغرات حياتنا، ويحولان النقاط السوداء في حياتنا إلى ظلال تعطي المساحات البيضاء جمالاً في أعظم أيقونة وهي أيقونة الحياة، فالطفلة الصغيرة بدأت تتعلم القراءة والكتابة عن طريق يديها فحاسة اللمس صارت حاستها الوحيدة التي يمكن أن تتعلم عن طريقها، ثم واصلت مسيرة العلم حتى حصلت على درجة الدكتوراة في القانون، ثم نالت الدكتوراة الثانية في الأدب الإنساني وفي مجال التأليف كتبت عشرة كتب، وزارت معظم بلاد العالم، وعاشت رغم عاهاتها حياة عادية، بل أكثر من عادية، فقد كانت تتمتع بالحياة وتمارس عدة هوايات مثل ركوب الخيل والمشي والسباحة والتجديف … وكانت دائماً تقول: ” أنا عمياء لكنى أبصر أنا صماء ولكنى أسمع أنا خرساء ولكنى أتكلم “
ورحلت (هيلين كيلر) عن عالمنا عام 1968م بعد حياة حافلة طالت 88 سنة، استطاعت خلالها أن تهزم اليأس وتنتصر على قسوة الحياة، وحققت المعجزة وعاشت على أصابعها، لقد رحلت هيلين العبقرية، المضادة لليأس والهزيمة، والمؤكدة للجهاد والانتصار وأيضاً الأمل!
ويعد (إديسون) من العباقرة الذين هزموا اليأس المادي، واليأس النفسي، فقد فشل في دراسته المدرسية ولكنه عوّضها بالدراسة على يد أمه الفاضلة، التي عندما واجهها ناظر المدرسة بخبر فصل ابنها قالت له: ” ابنى يحمل فوق كتفه رأساً فيه من الذكاء أكثر مما في رأسك وفى رؤوس زملائك المدرسين “، كما أنه أُصيب بصمم كامل ولكنه لم يهتم بل قال عبارته الجميلة: ” إن الصمم نعمة وليس نقمة فهو يريح الإنسان من ثرثرة الناس وكلامهم الفارغ ويشجعه على التركيز في عمله “، وبعد أن قدم اختراعاته التي تزيد عن الألف، اشتعلت النيران في كل معامله وحولتها إلى رماد وخسر كل أمواله التي تزيد عن المليونى دولار، إلا أنه لم ييأس وبدأ يعمل من جديد بعد أن نطق بعبارته الخالدة: “هذه كارثة حقاً ولكنها لا تخلو من نفع.. فقد التهم الحريق جهدي ومالي ولكنه خلصنى أيضا من أخطائى.. شكراً لله فنحن نستطيع الآن أن نبدأ من جديد بلا أخطاء..”
هذا هو (إديسون) الذي لم يعرف اليأس طول حياته، بل هزمه كلما حاول الاقتراب منه، ويرحل إديسون عام 1931م بعد أن أهدى العالم النور الذي نقل الإنسان إلى عصر الكهرباء، فهو الذي اخترع المصباح الكهربائي والتسجيل وما يزيد عن ألف اختراع.
ممارسة الوسائط الروحية
الوسائط الروحية أو وسائط النعمة هي بمثابة الأسلاك التي توصل إلينا تيار الروح القدس أو المجرى الحي الذي منه نشرب حليب النعمة الإلهية، فيتقوى إيماننا، ويثبت رجاؤنا، وتشتعل محبتنا لله، وننمو في كل شئ.
هي التي تعطي الإنسان قوة ومعونة حتى يستطيع أن يصمد ضد التجارب التي تأتي عليه.. كما أنها تجعل الإنسان دائماً في حضرة الله، وفي هذا الحضور لا يجرؤ الشيطان أن يقترب إليه، ولا يمكن للقلق أن يتسرب إلى قلبه، أما إذا أهمل ممارستها فإن حرارته الروحية تفتر ويعرض نفسه لمحاربات خطيرة وسقطات كثيرة، وفي وسط هذه التجارب يتسرب إليه القلق ويسيطر على عقله.
من أهم الوسائط الروحية: الاعتراف، التناول، الصوم الصلاة، القراءة في الكتاب المقدس وكتب الآباء.. فإذا اعترفت كن صادقاً مع نفسك ومع أب اعترافك، وإذا تناولت فكن مستعداً ومؤمناً أنك لا تأكل خبزاً وتشرب خمراً، بل جسد الرب المقدس ودمه الطاهر..
أما صومك فيجب ألا يكون امتناعاً عن الطعام الحيواني والاكتفاء بما هو نباتي، لأن هذا لا يقدم الإنسان إلى الله.
كان رجل أعمال ناجحاً، يمتاز بالمهارة والدقة، ويجيد فن التعامل مع الناس.. إلا أنه كان يقلق بشكل مريع، وكان بذلك يُسرع الخطى نحو حالة محزنة لأعصاب خربة وصحة معتلة، لكن حدث في أحد الأيام أن زاره صديق قديم فشرح له مشكلته، فقد كان نوع قلقة ينحصر في شكه الدائم فيما إذا كان ما قاله أو فعله صواباً، ولذلك كان يعيد التفكير في أية قرارات يتخذها إلى أن اضطربت أعصابه، فاقترح عليه صديقه أن يتبع طريقة سهلة في حياته، وذلك بأن ينسى يوماً انتهى ويستقبل اليوم الجديد، وشرح له فائدة وفاعلية مثل هذه الوسيلة…
وتمر الأيام والسنون ويتقابل الصديقان مرة أخرة في بيت رجل الأعمال، فقضيا وقتاً ممتعاً ثم تناولا العشاء، ولما استعدا للخروج لاحظ الضيف وجود سلة للمهملات موضوعة بجانب الباب يعلوها نتيجة، فأشار رجل الأعمال إلى التقويم وقال: والآن سأبدأ ممارسة الطقس المسائي الذي ساعدني على أن أحطم عادة القلق، ثم مد يده وانتزع الورقة الخاصة باليوم وطواها على شكل كرة صغيرة وألقى بها في سلة المهملات ثم أغمض عينيه وصلى صلاة قصيرة.
لقد طوى الرجل ورقة النتيجة وهو في الحقيقة طوى يومه بكل ما فيه من فشل ونجاح، وبما ارتكبه من أخطاء أو أتاه من حسنات، وثبت وجهه نحو المستقبل، وبذلك تخلص من هموم الأمس واليوم.
هناك حقيقة هامة يجب أن تعرفها وهي: إن القلق لأجل الماضي والمستقبل لن يفيدنا شيئاً فالقلق لا يؤثر في الماضي لأنه مضى، والقلق لأجل المستقبل مجهود ضائع، ألا ترى أن كثيرين لا يتمتعون بالحاضر لأنهم مشغولون بالغد؟! فلا هم تمتعوا في حاضرهم ولا هم نالوا سعادة في المستقبل! فالأفضل أن تنسى همومك وتتقدم إلى الأمام، حارقاً جسور القلق خلفك حتى تمضي إلى غير رجعة.