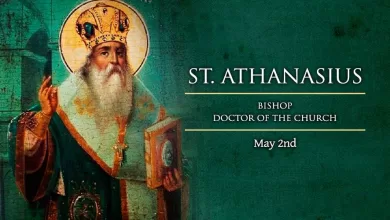أحد الرفاع – ق. يوحنا ذهبي الفم – د. جورج عوض إبراهيم
أحد الرفاع - ق. يوحنا ذهبي الفم - د. جورج عوض إبراهيم
أحد الرفاع – ق. يوحنا ذهبي الفم – د. جورج عوض إبراهيم

أحد الرفاع
من تفسير للقديس يوحنا ذهبي الفم
(على إنجيل متى)
الصدقة:
” احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات ” (مت1:6)
1ـ أن المسيح الآن يطرد الشهوة الأكثر سيطرة من بين كل الشهوات: جنون محبة المجد الباطل، التي استولت على هؤلاء الذين يتممون الوصايا الإلهية شكليًا. هذه الشهوة لا توجد من ذاتها، بل تظهر دائمًا أثناء تتميم الوصايا التي أوصانا بها المسيح. كان ينبغي أولاً أن يزرع الفضيلة، ثم بعد ذلك يجتث المرض الذي يؤثر على ثمارها. لاحظ من أين يبدأ؛ من الصدقة، والصوم، والصلاة. فإن محبة المجد الباطل قد تأتي أثناء ممارسة هذه الفضائل. لقد انتفخ الفريسي قائلاً: ” أصوم مرتين في الأسبوع واعشّر كل ما أقتنيه” (مت12:18). وفي صلاته هذه كان يُظهر افتخاره، ولأنه لم يكن حاضرًا إلاّ العشار، عقد مقارنة بينه وبين العشار قائلاً: ” إني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار” (مت11:18).
لاحظ أيضًا كيف بدأ؟، إنه يتحدث كما لو عن وحش مفترس، من الصعب أن يُمسك، وأيضًا ، من السهل أن يخدع الإنسان غير المتيقظ، لذلك يقول: ” احترزوا من جهة صدقتكم“، وهكذا أيضًا يقول بولس لأهل فيلبي ” انظروا (احترزوا) الكلاب” (2:3). لقد قدّم لنا، الله الآب الذي يشرق شمسه على الأشرار والأبرار، وبكافة الطرق يحثنا على فعل الوصية، ويقنعنا بأن نفرح بوفرة العطية، نازعًا كل الزوان الذي يعطل الزيتونة. لذلك يقول: ” احترزوا أن لا تصنعوا صدقتكم قدام الناس” ثم يضيف ” لكي ينظروكم“. فالمهم ليس هو العطاء ذاته لكن الدافع أو الغرض من العطاء. إن لم يوجد هذا التمييز الدقيق، فإن كثيرين سيترددون في تتميم فضيلة الصدقة، طالما أنه ليست هناك طريقة لكي يمارسونها في الخفاء. لذلك فهو يحررك من هذا الخوف، ويحدد العقوبة والمكافأة، ليس بنتيجة العمل، لكن من خلال الغرض منه. وحتى لا يتساءل أحد قائلاً: ما الذي سوف يصيبني إذا رآني أحد أمارس الفضيلة؟. الرب يطلب منك فكرك وطريقتك في العطاء، لأنه يريد أن يجدّد نفسك ويحررها من أي مرض. وطالما أوضح لهم الضرر الذي يسببه هذا المرض، فإنه يقوّي إرادتهم ثانيةً ويذكّرهم بالآب والسماء حتى لا يزعزعهم بمجرد ذكر الضرر فقط، بل يستحثهم بقوله: ” فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات“. ولم يتوقف هنا، بل استمر أبعد من ذلك، محاولاً أن يحرضهم بأمور أخرى كثيرة. كما قدم لهم ـ من قبل ـ عادات الفريسيين والأمم التي تجلب عارًا على الذين يتشبهون بهم، هكذا هنا يقدم المرائين ويقول: ” فمتى صنعت صدقة فلا تصوّت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون” (2:6).
بالتأكيد لم يمسكوا بوقًا، لكنه أراد أن يشير إلى هوسهم الزائد بالمجد الباطل معبّرًا بذلك عن سخريته واستهزائه بهم. لقد دعاهم “مرائين”، أي “ممثلين”، فالصدقة بالنسبة لهم كانت مجرد قناع، أما قلوبهم فمليئة بالقسوة وعدم الشفقة. فهم يفعلون الصدقة، لا لأنهم يرحمون قريبهم، بل لكي يكسبوا المجد الباطل. وهذه هي قمة القسوة، فالآخر يهلك جوعًا وأنت تطلب المجد الباطل. ليس المهم أن نعطي صدقة، ولكن ما هو غرضنا من إعطاء هذه الصدقة؟
” وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرّف شمالك ما تفعل يمينك ” (مت3:6).
2 ـ وحيث إنه استهزأ بهم بما فيه الكفاية، وأدانهم، حتى يُخجل المستمع، قوّم أيضًا الفكر الذي يعاني من هذا المرض، وقال: ” فلا تعرّف شمالك ما تفعل يمينك“. هنا بالتأكيد لا يقصد الأيدي، بل استخدم الأيدي للتعبير، أراد أن يقول: اعتني بأنك تخفي صدقتك بكافة الطرق، وإن أمكن أن تخفى الأمر عن اليد الأخرى.
ثم تأمل كم يكون الأجر؟. لقد تحدث عن الجحيم الذي يأتي من علانية الصدقة، والآن يتحدث عن الكرامة التي تأتي من العطاء في الخفاء. إذ يريدنا أن نعرف أن الله يوجد في كل مكان. وأن مسيرتنا لا تنتهي في الحياة الحاضرة، بل من الآن تنتظرنا محاكمة رهيبة، عن كل أعمالنا، ومكافآت وعقوبات. وكل ما فعله المرء سواء صغيرًا أو كبيرًا فلن يُخفى حتى لو ظن أنه مخفي عن كل البشر. كل هذا يشير إليه بقوله: ” فأبوك الذي في الخفاء يجازيك علانية” (4:6)، معطيًا إياه بوفرة ما يرغبه بالضبط. يقول: ماذا ترغب؟ هل تريد أن يكون لديك بعض الناس لينظروا أعمالك؟ الآن لديك، ليس الملائكة ولا رؤساء الملائكة، لكن إله الجميع نفسه. إذا أردت أن يكون لديك مشاهدين من البشر، لن يتأخر في تحقيق رغبتك، وبكل كرم وسخاء. إذا أردت الآن سيكون لك عشرة أو عشرين أو مائة إنسان يشاهدك. لكن إذا أخفيت الآن صدقتك عن أعين الناس، سوف يجازيك الله حينئذٍ علانية، في حضور كل المسكونة. إذا أردت أن يري الناس فضائلك، عليك أن تخفيها الآن حتى يراها وقتئذٍ الكل وتحصل على مجد عظيم، فسوف يظهرها الله ويرفعها ويعلنها للجميع. الذين يشاهدونك الآن سوف يدينوك كمحب للمجد الباطل، أما عندما يشاهدونك متوجًا، ليس فقط لا يدينونك بل سوف يمدحونك.
ياللحماقة، أتخسر أجرك بينما في إمكانك أن تطلب الأجر من الله ويكون لك مُشَاهِد إلهي، فأنت حين تفتخر الآن بأعمالك فأنت تطلب الأجر من البشر. فإن كان لابد أن تتباهى، فيجب أن تتباهى أمام الآب، الذي في سلطانه التتويج والعقاب معًا. من هو أكثر تعاسة من ذلك الذي يترك الملك الذي جاء خصيصًا ليرى أعماله، ويتوسل للبشر حتى ينظروا إليه؟! لذلك يأمر، ليس فقط بعدم التظاهر، ولكن يأمر أيضًا أن نجاهد لكي نتمم الفضيلة في الخفاء:
الصلاة:
” ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس، الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصَلِ إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية” (5:6 ـ 6).
للمرة الثانية يدعو هؤلاء “مرائين”، وحسنًا فعل، إذ يدّعون أنهم يصلون إلى الله لكن يظهروا للناس من حولهم، ولا يقفون كما يليق بالمتضرعين، لكن مثل أناس مستهترين. فالذي يتضرع عليه أن يترك الكل، وينظر فقط إلى ذاك الذي عنده المقدرة على تحقيق طلبه. إنما لو تركت الله وأخذت تراقب وتحوم بعينيك في كل مكان حولك، سوف تعود بعد ذلك خالي الوفاض. هل تريد أجرًا؟ إنه لم يقل إن هؤلاء الناس سوف لا يأخذون أجرًا، لكنهم سينالون من الذين يريدون منهم أجرًا أي البشر. الله أراد أن يعطى مكافأة، لكن أولئك طالما يطلبون مكافأة البشر فليس لهم الحق في أن يأخذوا مكافأة الله، خاصة أنهم لم يفعلوا شيئًا لأجلها. أما أنت فانتبه لمحبة الله للبشر، لقد وعَّد أن يمنحنا مكافأة على كل صلاح نطلبه منه.
وحيث إنه قد أدان هؤلاء الذين لم يمارسوا الصلاة كما يليق، وذلك بالنسبة لمكان الصلاة وبالنسبة للدافع الداخلي، وأظهر خزيهم، فقد قدم في النهاية الطريقة الحسنة للصلاة، مانحًا أيضًا المكافأة، إذ قال: ” فادخل إلى مخدعك“.
3 ـ لكن سوف يتساءل شخص: هل يجب أن أذهب للصلاة في الكنيسة؟ نعم ينبغي أن نصلي بكل الطرق، ولكن المهم في الدافع. لأن الله دائمًا يطلب الهدف أو القصد من أعمالنا. لأنه حتى إن دخلت إلى مخدعك وأغلقت بابك وأنت تصلي من أجل التباهي أو الظهور، فسوف لا يفيدك غلق الأبواب بشيء. إذن، لاحظ هنا مدى الدقة التي حدد بها الأمور: ” لكي يظهروا للناس“. إنه يطالبك بتأمين أبواب ذهنك قبل أن تغلق جيدًا أبواب المخدع. إنه من الجيد أن تتخلص من المجد الباطل بالحرى في ساعة الصلاة. كيف نسمع أقوال صلاتنا، عندما ندخل إلى المخدع ومعنا هذا المرض اللعين (المجد الباطل)؟ وإن لم نسمع الكلام الذي نتضرع به إلى الله، كيف نستحق أن يسمعنا الله؟
للأسف البعض يتصرف ـ بعد كل هذا الكلام الكثير الذي قلناه ـ بشكل غير لائق تمامًا أثناء الصلاة. فبالرغم أنهم لا يظهرون بأجسادهم، إلاّ أنهم يُظهرون ذواتهم للكل بأصواتهم، صارخين بصوت عالٍ كأنهم في سوق خادعين ذواتهم بالتمايل والصوت العالي.
ألا ترى أنه حتى في السوق، فإن مَنْ يقترب بمثل هذه الطريقة ويستعطى بأصوات عالية سوف يجعل الشخص الموجه له هذا التوسل يبتعد بعيدًا؟! بينما لو اقترب بهدوء وبطريقة لائقة عندئذ يتأثر بالحرى هذا الشخص ويعطيه للفور إحسانًا. إذن، ليس بتمايل الجسد ولا بحدة الصوت، لكن بالدافع الحسن علينا أن نصلى. ولا أيضًا بضجة ولا بضوضاء بغرض الظهور، حتى يرانا الذين حولنا، ولكن بطريقة لائقة، بانسحاق النفس وبالدموع من الأعماق. هل أنت متألم في داخلك وتضطر أن تصرخ؟ عليك كما قلت بهدوء أن تصلى وتتضرع يا من تتألم ألمًا كثيرًا. تألم موسى النبي وصلى هكذا وسُمع، لذلك قال له الله: ” ما لك تصرخ إلىّ” (خر15:14). وحنة النبية أيضًا لم يسمع أحد صوتها أثناء الصلاة ونالت كل ما تريد لأنها صرخت بقلبها (انظر اصم3:1). وهابيل أيضًا بموته لم يصمت، لكن صلى ودمه صرخ بصوت أقوى من البوق (أنظر تك1:4). إذن، احزن وأنا لا أمنعك؛ مزق قلبك وليس ثيابك، كما ينصح النبي (انظر يؤ13:2)، اطلب الله من أعماق قلبك ” من الأعماق صرخت إليك يارب” (مز1:130). أطلق صرخة من قلبك، واجعل صلاتك سر. ألاّ ترى أن داخل القصور لا يسمع أحد ضجة إذ يسود الهدوء والصمت المكان كله؟ وأنت أيضًا عندما تدخل القصور، ليست الأرضية، بل الأعظم والأرهب من كل القصور الأرضية، أي السماوية، اظهر وقارًا لائقًا جدًا. لأن جوقة الملائكة لها مكان هناك. فأنت بصحبة رؤساء الملائكة ترنم مع السيرافيم. تصطف كل هذه الطغمات بترتيب وتناسق جميل وبخشوع عظيم ترنم تلك التسابيح السرية المقدسة إلى الله ملك الملوك. ليتك تصير أنت واحدًا من هؤلاء عندما تصلى وتتشبه بنظامهم السري. لأنك بالتأكيد لا تصلى إلى البشر بل إلى الله الموجود في كل مكان، الذي يسمع ونحن نتحدث إليه ويعرف مكنونات نفوسنا. إذا صليت هكذا، سوف تنال أجرًا عظيمًا. يقول: “ أبوك الذي يراك في الخفاء يجازيك علانية“.
لم يقل سوف يمنحك، لكن سوف يجازيك، وبذلك جعلك مكرّمًا بشرف عظيم. إن الله الذي هو غير منظور، يرغب في أن تكون صلاتك أيضا غير منظورة. يقول لنا بعد ذلك:
” عندما تصلون لا تكرروا الكلام باطلاً كالأمم” (7:6).
عندما تحدث عن الصلاة لم يحذر فقط من مرض محبة المجد الباطل، بل أضاف أيضًا شيئًا آخر؛ هو تجنب الثرثرة. ومثلما تهكم هناك على المرائين، يتهكم هنا على الوثنيين محذرًا السامع في كل حالة من تفاهة الأشخاص. إنه يسمّى الهذيان ثرثرة، أي عندما نطلب من الله كل ما هو غير لائق، مثل السلطة والمجد والفوز على الأعداء، أو نطلب نقودًا كثيرة، وعمومًا كل الأشياء التي لا تفيدنا بتاتًا. لأن الله يعرف كل شئ نحتاجه، إذ قال:
” لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه ” (8:6).
4ـ بالإضافة إلى كل هذا، يجب أن أنصحكم الآن ألاّ تجعلوا صلواتكم طويلة، لا أقصد بالنسبة للزمن، لكن من جهة كثرة الأقوال. يجب أن نطلب في صلاتنا، نفس الأمور دائمًا بصبر ولجاجة. يقول لنا: ” مواظبين على الصلاة” (رو12:12). والمسيح نفسه قال لنا مثل الأرملة التي استمالت بطلبها القاضي القاسي وغير الرؤوف بلجاجة صلاتها(انظر لو1:18ـ8)، وأيضًا مثل الصديق الذي أتي ليلاً بدون مراعاة وقت النوم، وأنهض صديقه النائم من سريره (انظر لو5:11)، ليس لأنهما كانا صديقان، لكن بإصراره على طلبه. لقد أوصى بأن نصلي إليه بلجاجة، لكن لم ينصح بأن نأتي إليه ونعلن له فقط صلاة تتكون من أعداد لا حصر لها من السطور، هذا ما أشار إليه بقوله ” إنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يُستجاب لهم” (7:6).
وإذا تساءل شخص: إن كان الله يعرف احتياجاتنا، فلأي سبب ينبغي أن نصلى؟ ليس من أجل أن تخبره بهذه الاحتياجات، لكن لأجل أن تدنو نحوه، لتثمر باستمرارك في الصلاة وأيضًا لكى تتواضع وأنت تتذكر خطاياك. هكذا يقول لنا:
الصلاة الربانية:
” فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السموات” (9:6).
لاحظ كيف أنه يُنهض السامع ويذكّره في مقدمة الكلام بكل سخاء الله. لأن من يقول إلى الله ” يا أبانا “، بهذا اللقب يقرّ بغفران الخطايا والبر والقداسة والفداء والتبني والميراث والعلاقة الحميمة بالابن الوحيد الجنس، وعطية الروح القدس. لأنه لا يمكن أن تدعو الله أبًا، إن لم يكن قد حصلت على هذه الخيرات. لقد شدّد إرادتهم بالاثنين؛ بالاستحقاق الذي يعطيه من خلال مناداته بلقب “أب”، وبعظم الخيرات التي يتمتعون بها. وعندما يقول ” في السموات ” لا لكي يحصر الله هناك، بل لكي يرفع المصلى عن الأرضيات وليجعل عينيه محدقةً في الأماكن السامية والمساكن السماوية. يعلمنا أيضًا أن نصلى صلاتنا من أجل اخوتنا، فلا يقول: ” أبي الذي في السموات”، لكن “أبانا”، معلنًا هكذا أن نوجّه تضرعاتنا لأجل الجسد الواحد. وفي أية حالة، لا يهدف المصلي إلى مصلحته الشخصية بل لمصلحة قريبة. بهذه الصياغة قد محا العداوة وأزاح اليأس بعيدًا ونزع الحسد، وأتي بدلاً من كل هذا بأم الصالحات: المحبة. وهكذا أقصى الفروق من بين البشر، وأظهر التساوي في الكرامة بين الملك والفقير، طالما أن الكل مشترك بالتساوي في الأمور العظيمة والجوهرية. هل هناك ضرر يأتي علينا، عندما يربطنا بالانتماء السماوي، حيث لا أحد لديه أكثر من الآخر: الغني من الفقير، السيد من العبد، الرئيس من المرؤوس، الملك من الجندي، الفيلسوف من البربري، والحكيم من الجاهل؟. لقد منح الجميع أصلاً كريم، وجعلنا مستحقين لأن ندعوه ” أبانا “. بعدما ذكّرنا بهذا الكرم وهذه العطية السماوية، والكرامة المتساوية مع اخوتنا و، والمحبة، وذلك بابتعادنا عن الأرض وارتباطنا بالسموات، ليتنا نرى الآن ما الذي ينصحنا به لنطلبه.
” ليتقدس اسمك ”:
تعنى ليتمجد. الله طبعًا مجده كامل وهو دائمًا مملوء مجدًا، لكنه يوصي المصلي أن يسعي لكي يمجد الله في حياته الخاصة. لقد قال من قبل نفس الأمر: ” فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة، ويمجدوا أباكم الذي في السموات” (16:5). والسيرافيم الذين يمجدونه قالوا: ” قدوس، قدوس، قدوس” (إش3:6). هكذا “ليتقدس” يعني يتمجد. اجعلنا مستحقين لكي نحيا بأكثر نقاء، حتى يمجدك الجميع بواسطتنا.
” ليأتِ ملكوتك ” (10:6):
وهذه أيضًا طلبة الابن المعترف بالجميل، لكي لا ينخدع بالأمور المنظورة، ولا يعتبر الأمور الحاضرة ذات شأن هام، لكن عليه أن يسير نحو الآب، وألاّ يشتهي الأمور العتيدة. هذا هو الضمير الصالح والنفس المتحررة من الأمور الأرضية.
5 ـ هذا ما كان يتوق إليه بولس في كل يوم من حياته. لأجل هذا كان يقول: ” نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا” (رو23:8). مَنْ لديه هذا الشوق، فلا أمور الحياة الصالحة يفتخر بها، ولا المؤسفة تقلل من قيمته، لكن كأنه يوجد في السموات وقد تخلص من كليهما.
” لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ” (10:6).
أرأيت هذه الصلاة المتعقلة والهامة؟ لقد أرشدنا أن نشتاق للأمور العتيدة، ونسرع للذهاب إليها. لكن إلى أن يتم هذا، علينا أن نظهر هنا بما سنكون عليه في السماء. ينبغي علينا أن نشتهي السماء والأمور السماوية الأخرى، فينصحنا بأن نجعل الأرض سماءً ونحيا فيها ونسلك كمواطنين سمائيين، هكذا فلنعمل ولنتكلم: لا شئ يعيق وصولنا إلى عظمة القوات السماوية، بسبب أننا نسكن في الأرض، لكن من الممكن أن تحيا هنا وتفعل كل شئ كما لو أنك قد وصلت إلى السماء. وكما أن الكل في السماء خاضع لله تمامًا؛ فالملائكة لا تخضع في أمور وتعصى في أمور أخرى، لكنها مطيعة وخاضعة في كل الأمور، إذ مكتوب: ” باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه” (مز20:103). هكذا جعلنا نحن البشر مستحقين أن نتمم كل شئ كما يشاء وليس جزء من إرادته.
هل رأيت كيف يعلمنا أن نكون فضلاء، إذ يعلن أن الفضيلة ليست مجرد إنجاز خاص بنا، لكن للنعمة الإلهية؟ وأيضًا حدد لكل واحد منا أن نصلي آخذًا على عاتقه مسئولية الاعتناء بكل المسكونة. لأنه لم يقل ” لتكن مشيئتك فيّ أو فينا”، لكن لكل مكان على سطح الأرض، حتى يبيد الضلال ويزرع الحق ويقتلع كل الشر وتأتي الفضيلة ولا تختلف السماء إطلاقًا عن الأرض. لو صار هذا، فسوف لا يختلف ما هو أسفل عن ما هو فوق، بالرغم من أن الاختلاف هو بحسب الطبيعة.
”خبزنا اليومي أعطنا اليوم ” (11:6).
ما معنى ” الخبز اليومي “؟ خبزنا اليوم. ولأنه قال ” لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض“، ثم يتوجه إلى البشر الذين لهم أجساد خاضعة لنواميس طبيعتهم، إذ لا يمكن أن يكون لديهم عدم الهوى (عدم الانفعال) الذي لطبيعة الملائكة، يقول لنا، علينا أن نفعل وصاياه كما يفعل الملائكة، لكنه تنازل من أجل ضعف طبيعتنا، واكتفى بأن نسلك بتدقيق في حياتنا ولم يطالبنا بعدم الهوى. لأن قدرة طبيعتكم لا تسمح بهذا، إنها تحتاج إلى غذاء ضروري. لاحظ كيف ينظر إلى الأمور الجسدية نظرة روحية. لم يقل لأجل الأموال، ولا لأجل الحياة المترفة، ولا لأجل الثياب الفاخرة، ولا لأي شئ مثل هذا، لكن فقط من أجل خبزنا، وحسنًا من أجل خبزنا اليومي، حتى لا ننشغل بخبزنا الذي للغد. لأجل هذا أضاف: ” اعطنا اليوم“، حتى لا نقلق ذواتنا بالانشغال باليوم التالي. لماذا تصرّ على الاهتمام باليوم الذي لا تعرفه؟ وقد تحدث فيما بعد عن ذلك: ” لا تهتموا بالغد” (34:6). إنه يريد دائمًا أن نكون متأهبين ولنا أجنحة مثل الملائكة، معطين للطبيعة البشرية بقدر ما تطلبه الضرورات.
وبسبب أننا نخطئ بعد حميم ميلادنا الثاني، قد عيّن لأجل غفران خطايانا أن نصلى إلى الله محب البشر، ونتوجه إليه هكذا:
” واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضًا للمذنبين إلينا ” (12:6) .
هل رأيت المحبة الفائقة؟! بعد أن محا شرورًا كثيرة وبعد عطيته الكثيرة التي لا تُوصف في المعمودية، جعلنا مستحقين للغفران إذا أخطأنا من جديد. إن هذه الطلبة تناسب المؤمنين، وقوانين الكنيسة تعلم بهذا، وكذلك مقدمة هذه الصلاة (أبانا). مَنْ هو خارج الكنيسة لا يستطيع أن يدعو الله أبًا. وبما أن الصلاة تناسب المؤمنين الذين يصلون ويتضرعون ليغفر الله لهم خطاياهم، فإن التوبة لها فاعلية حتى بعد المعمودية. والدليل على ذلك أن المسيح أمرنا أن نصلى هكذا. إنه يذكّرنا بخطايانا، وينصحنا بأن نطلب الغفران وهو على يقين في الوقت نفسه بأن نوال هذا الغفران هو متيسر. من الواضح أنه يريد أن يعلمنا بأنه يمكننا أن نتطهر من خطايانا بعد المعمودية، ولأجل هذا وضع لنا هذه الطلبة. فمن جهة، أراد أن يذكّرنا بخطايانا حتى نسعى نحو الفضيلة. ومن جهة أخرى، بالغفران للآخرين نتخلص من أي ذِكر للشر. وبوعده لنا بأنه سوف يغفر خطايانا، يخلق فينا آمال صالحة ويعلمنا بأن نصير حكماء بمحبة الله للبشر التي لا تُوصف.
6ـ ” فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضًا أبوكم السماوي“(14:6)، هكذا الأمر ينطلق منا، والدينونة العتيدة تتوقف علينا. اجعل القرار يتوقف عليك، حتى لا يمكن أيضًا لأحد من الناس، عديمي الإحساس، أن يدينك في المحكمة لأجل أي أمر صغيرًا كان أم كبيرًا. فإن غفرت لخادمك سوف تنال أنت هذه النعمة. بالرغم من أنها لا تكون بالتأكيد مساوية لغفرانك؛ لأنك في احتياج لأن تغفر، أما الله فليس في احتياج لشيء. أنت تغفر لخادمك (الذي هو إنسان مثلك)، أما الله فيغفر لعبده. أنت مُعرض لأخطاء لا حصر لها، أما الله فهو بلا خطية.
هكذا يعلن الله محبته للبشر. كان يمكن أن يغفر لك كل خطاياك بدون أن تغفر لأخيك، لكن يريد أن يكرّمك ويمنح لك حشد من الفرص لأنه يحبك. يريد أن يقتلع الرغبات المتوحشة بداخلك ويطفئ شعلة الغضب التي فيك، ويربطك بأخيك من كل جانب.
هل هناك شيئًا تريد أن تقوله؟ هل تألمت ظلمًا من جارك؟ تذكّر أنك تأتي لكي تنال غفرانًا لأجل مثل هذه المظالم. وهذا الغفران الذي تناله ربما لأمور أعظم من الألم الذي سببه لك جارك. ومع كل هذا ينتظرك هناك أجر عظيم، وسوف لا يطلب منك الله جوابًا على إي من أخطاءك. إذن أي عقاب نكون جديرين به، إذ بينما لدينا إمكانية أن يُغفر لنا، ونحن نخون خلاصنا (في حالة عدم غفراننا لأخينا)؟ كيف نكون مستحقين لأن يسمع لنا الله طلباتنا، بينما نحن لا نريد أن نعتني بأنفسنا، لأجل أمور في متناول أيدينا (يقصد أن نسامح الآخرين)؟
” ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين ” (13:6).
هنا يظهر بوضوح مدى ضعفنا محجمًا كبرياءنا، معلمًا إيانا أن نتجنب الخوض في التجارب، وعلينا ألاّ نندفع نحوها. هكذا فإن انتصارنا بعد ذلك سيكون أكثر بهاءً، أما هزيمة الشيطان فستكون أكثر فظاعة. فعندما نظل هادئين منتظرين وقت الحروب سوف نبرهن على أننا لا نحب المجد الباطل، بل نحب سمو الروح.
هنا يدعو الشيطان ” الشرير” حتى نتأهب دائمًا لحرب مستمرة ضده، وأيضًا لكي يُظهر لنا أن هذا اللقب “الشرير” ليس صفة لطبيعتنا. فالشر ليس من تكوين طبيعتنا لكن نتيجة اختيارنا. بينما الشيطان دُعي شريرًا بسبب شره الزائد، وبسبب أنه يشن علينا حربًا بلا هوادة، بدون أن نرتكب شرًا. لذلك لم يقل ” نجنا من الشرور”، بل ” من الشرير“. يعلمنا أن لا نسئ إطلاقًا لاخوتنا في الإنسانية لأجل شر فعلوه لنا، لكن فلننقل عداوتنا لهم، نحو الشيطان، لأنه هو علة كل الشرور.
وطالما حدثنا عن الحروب والتجارب، يشجعنا ثانية ويسمو بنا مذكرًا إيانا بالملك الذي نخضع له، مؤكدًا لنا أنه أعظم قوة من الكل، فيقول لنا: ” لأن لك الملك والقوة والمجد“. بالتالي فإن كان المُلك له، فلا أحد ينبغي عليه أن يخاف، لأن لا أحد يستطيع أن يقف ضده أو يشاركه في سلطته. عندما يقول: ” لأن لك الملك“، يُظهر أن الشيطان الذي يحاربنا هو أيضًا تحت سلطانه. وعندما يحاربنا الشيطان، فإنه يفعل ذلك بسماح من الله. لأن الشيطان أيضًا من عبيد الله، بالرغم من أنه من المتمردين عليه. وما كان يتجرأ على مهاجمة أحد من عبيد الله، إن لم يكن قد أخذ تصريحًا من فوق. ولماذا أقول مهاجمة أحد من عبيد الله؟! فإنه لا يتجرأ على مهاجمة الخنازير، إلاّ إذا أخذ تصريحًا من السماء.
و” القوة “: إذن، إن كنت ضعيفًا للغاية فلك الحق أن تحصل على شجاعة وثقة لأن لك مثل هذا الملك الذي يحقق لك كل شئ بسهولة.
” والمجد إلى الأبد آمين ” .
7 ـ ولا يخلصك فقط من المصاعب التي تأتي عليك، لكن يستطيع أن يجعلك مُمجدًا ومتألقًا. فكما أن قوته عظيمة، هكذا مجده لا يُوصف، وكلاهما أزليان وليس لهما نهاية. أرأيت كيف أعَّد كل شئ ليجعلك مثل الرياضي، جسورًا وشجاعًا؟
لقد أراد أن يُظهر أنه يمقت ويكره تذكار الشر، ويستحسن ـ أكثر من أي شئ ـ الفضيلة المُضادة للشر، ويقود المستمع إلى طاعة الوصية.
” فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضًا أبوكم السماوي. وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضًا زلاتكم ” (15،14:6).
وقد ذكر أيضًا السموات والآب، حتى يشجع المستمع القاسي القلب، إذ له مثل هذا الآب السماوي، وعليه أن لا يسلك سلوكًا أرضيًا لأن دعوته هي من السماء. لأننا لا ينبغي أن نكون أولاده بالنعمة فقط، لكن بأعمالنا أيضًا. ولا يوجد شئ يجعلنا متشبهين بالله بقدر أن نمنح غفرانًا للأشرار ولكل الذين يسيئون إلينا. كما علمنا منذ قليل: أن الشمس تُشرق على الأشرار والأبرار. لذلك أمرنا بأن نصلى جميعنا صلاة مشتركة: ” أبانا” و” ليتقدس اسمك، كما في السماء كذلك على الأرض“، و” خبزنا كفافنا أعطنا“، و” واغفر لنا ذنوبنا“، و” لا تدخلنا في تجربة“، و” نجنا“. هكذا أراد أن نستخدم صيغة الجمع حتى لا يكون لدينا ضد أخينا أي أثر للغضب. فكم يستحقون العقاب الذين ـ بعد كل هذا ـ ليس فقط لا يغفرون، بل يدعون الله لكي ينتقم من أعدائهم، بينا الله يفعل كل شئ حتى لا يكون هناك خصام فيما بيننا؟
ولأن المحبة هي أصل كل الصلاح، فإن الرب يزيل كل ما يفسدها من أي جهة، ويلصقنا الواحد بالآخرين. لا يوجد أحد: لا أب، ولا أم، ولا صديق، قد أحبنا بالقدر الذي أحبنا به الله الذي خلقنا. وهذا واضح جدًا من إحساناته وأعماله. فلو حسبنا بالتفصيل مخالفتنا وخطايانا ليوم واحد، سوف ندرك مقدار المصاعب التي نستحق أن نعاني منها. سوف أترك المخالفات الخاصة التي يفعلها كل واحد، ودعوني أذكر المخالفات المشتركة والتي تحدث الآن؛
مَنْ منكم لم يصلي برخاوة؟!
مَنْ منكم لم ينتابه اليأس؟!
مَنْ منكم لم يحب المجد الباطل؟!
مَنْ منكم لم يتكلم بسوء على أخيه؟!
مَنْ منكم لم يسبب لأخيه شهوة ردية؟!
مَنْ منكم لم يضمر في نفسه شرًا تجاه عدوه؟!
مَنْ منكم لم ينتفخ بقلبه؟!
إن كنا ونحن موجودين في الكنيسة ولفترة زمنية قصيرة نرتكب أخطاء كثيرة، فماذا يحدث بعدما نخرج من هنا؟!
فإذا هبت علينا أمواج كثيرة ونحن داخل الميناء، وعندما نبحر في بحر المتاعب، أقصد السوق والأشغال العامة والاهتمامات العالمية، هل سوف نستطيع التعرف على ذواتنا؟!
لكن لكي نتخلص من خطايا كثيرة، أعطانا الله طريقًا سريعًا وسهلاً، لا يجلب علينا أي متاعب. هل يصعب عليك أن تغفر للذي أخطأ إليك؟!
8 ـ لا تحتاج أن تجوب البحار، ولا أن تسافر أسفارًا طويلة، ولا أن تتسلق قمم الجبال، ولا أن تقترض نقودًا، أو أن تعذب جسدك، بل يكفي أن تريد وسوف تُمحى كل خطاياك.
أي رجاء لك لتخلص، إن كنت لا تغفر لعدوك، بل بالإضافة إلى ذلك تصلى إلى الله ضده، وأنت تظهر كأنك تصلي، بينما تصرخ صراخًا وحشيًا، وتحوّل سهام الشرير ضدك؟ لذلك فإن بولس عندما يتحدث عن الصلاة، لا يطلب شيئًا، بقدر حفظ هذه الوصية: ” رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال” (1تي7:2). فإذا كنت في حاجة إلى رحمة الله، وتتمسك بغضبك بالرغم من أنك تعرف جيدًا أنك بموقفك هذا تطلق سهام الشرير على ذاتك، متى تصير محبًا وتطرد هذا السم الشرير؟! إن لم تدرك حجم هذا الخطأ، افحصه في علاقات البشر بعضهم لبعض، وعندئذٍ سوف تتحقق من مدى الحالة المهينة التي وصل إليها البشر. على سبيل المثال: عندما يأتي إليك شخص يطلب رحمتك جاثيًا على الأرض، وعندما انتهى من توسله هذا، رأي عدوه قادم، فنهض للتو وأخذ يضربه ويتوعده، ألاّ سوف تغضب بالأكثر ضده؟
تأمل؛ إن نفس الأمر يحدث مع الله. وبينما أنت تتضرع إلى الله، تترك تضرعك وتضرب بكلامك عدوك وتحرض المُشرّع (الله) بأن يصب جام غضبه على الذين يسيئون إليك، وكأنك لا تكتفي بمخالفة ناموس الله، بل تريد أن يفعل الله نفس الأمر!! هل نسيت كل ما أعلنه لنا؟ أتظن أن الله مثل الإنسان؟ إن الله الذي يعرف كل شئ ويريدنا أن نحفظ وصاياه بكل دقة، وأنت تبتعد كثيرًا عن فعل الأمور الجديرة بأن تفعلها، فتجعله يتحول عنك ويمقتك، لأن ما تقوله يتطلب أقصى العقوبات.
يوجد كثيرون يهذون إلى هذه الدرجة، حتى أنهم يلعنون ليس فقط أعداءهم بل أولادهم، ويتمنون ـ لو كان في الإمكان ـ أن يأكلوا أجسادهم. لا تقل لي؛ إنك لم تغرس أسنانك في جسد الذي أساء إليك. لقد فعلت شيئًا سيئ جدًا، وذلك عندما أعلنت رغبتك في أن يسقط فوقه غضب السماء، لكي تسلمه للعقاب الأبدي وتدمره مع كل عائلته.
أليس هذا الأمر هو أسوأ من كل اللدغات؟ أليس هو أكثر ألمًا من كل النبال؟ ألم يعلمك المسيح بأن مثل هذه الأمور هي أسوأ من أفواه ملطخة بالدماء؟ كيف بعد ذلك تقترب من الذبيحة؟ كيف تتذوق دم الرب؟ فعندما تصلي وتقول: اسحقه ودمر بيته ودمره من كل جهة، فأنت لم تختلف في شئ عن قاتل أو بالحرى عن وحش مفترس.
9 ـ ليتنا نُوقف هذا المرض، وهذا الهَوَس، ودعونا نقدم محبة للذين أساءوا إلينا، لكي نصير متشبهين بإلهنا السماوي، وسوف نتوقف لو أحضرنا في ذهننا خطايانا الخاصة. ولو فحصنا بدقة كل الأخطاء التي فعلناها في البيت، وفي السوق وفي الكنيسة. على الأقل فنحن نستحق لأجل عدم مبالاتنا هنا في الكنيسة؛ إذ بينما يرنم الأنبياء، ويسبح الرسل، ويكلمنا، نتوه نحن خارجًا ونفكر في أمور الحياة المعيشية. للأسف لا ننصت بهدوء لتعاليم الله، بقدر الهدوء الذي يحتفظ به المشاهدون في المسرح لسماع الأخبار الملوكية. لأن هناك عندما تُقرأ هذه الأخبار يقف الكل: شهود العيان والمديرون والبرلمان والمجلس المحلي، ليسمعوا في صمت كل ما يُقال. وإذا حدث أن تكلم أحد بصوت عالٍ يجلب على نفسه مشاكل مع الملك، ويُحكم عليه بعقاب قاسي. أما هنا فحين نقرأ الأقوال السماوية، تحدث ضجة كبيرة من كل جهة. بالرغم من أن رسائل الرسل هي أعظم من أوامر الملك. والمشهد أكثر وقارًا، لأنه لا يتكون فقط من البشر، لكن أيضًا من الملائكة. لذا الذين يباركون الله ليس البشر فقط، لكن الملائكة ورؤساء الملائكة وكل الطغمات السمائية، وكل ساكني الأرض ” باركوا الرب يا جميع أعماله” (مز22:103).
وعندما تُقال هذه الأقوال يجب أن نسمعها بتقوى ورهبة، ولا نظن أننا نُوجد على الأرض، لكن للأسف نحن نتصرف بضوضاء كما لو كنا في السوق، ونصرف وقت الاجتماع في الحديث. إننا ننصت خارج الكنيسة للأحاديث الصغير والكبيرة، أما في الكنيسة فإننا نظل غير مبالين، وبالإضافة إلى ذلك نلعن أعداءنا في صلواتنا، فمن أين ننال رجاء الخلاص، هل من خطايانا التي نفعلها، بالإضافة إلى الهذيان الذي نقوله في الصلاة؟!
ليتنا نطرد السموم من داخلنا، ليتنا نحل عداوتنا ونصلي كما يليق بنا. دعونا ننال هدوء الملائكة بدلاً من ضوضاء الشياطين. ليتنا نلجم غضبنا أمام كل المظالم التي أصابتنا، طالما نحتفظ في ذهننا بالأجر الذي سوف ينتظرنا بعد تنفيذ الوصية، ليتنا نكبح الأمواج لكي نقضي الحياة الحاضرة بلا اضطراب حتى نصل إلى الرب. لو كان هذا الأمر ثقيل ومخيف، دعونا نجعله خفيفًا ومحبوبًا، وليتنا نفتح الأبواب البهية نحوه. وهذا الذي لم نحققه بالكف عن الخطايا، سوف نحققه بأن نصير مسالمين تجاه هؤلاء الذين أذنبوا إلينا (وهذا ليس ثقيلاً ولا صعبًا). إذ بإحساننا إلى الأعداء نكون جديرين برحمته الجزيلة علينا. لأنه هكذا في هذه الحياة سوف يحبنا الجميع والأكثر من الجميع الله. وسوف يحبنا ويكلّلنا ويجعلنا مستحقين للخيرات العتيدة والتي جميعنا ننالها بنعمة ومحبة ربنا يسوع المسيح الذي له المجد والقوة إلى أبد الآبدين. آمين[1].
الصوم:
” ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيّرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك. لكي لا تظهر للناس صائمًا بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية”[2] (16:6).
يليق بنا أن نئن هنا كثيرًا وننتحب بمرارة، لأننا لا نشبه المرائين فقط، بل تفوقنا عليهم. لأني أعرف كثيرين آخرين لا يصومون ويلبسون قناع أُناس يصومون، والأكثر من ذلك إنهم يتسلحون بعذر أقبح من خطيتهم، قائلين إننا نفعل هذا لكي لا نعثر الآخرين. ما هذا الذي تقوله؟ إن ناموس الله هو الذي حدَّد كل هذا، وأنت تتذكر العثرة؟ وتعتقد أنك تعثر عندما تحفظ الناموس، وتجنب الناس العثرة عندما تخالف الناموس؟ هل يمكن أن تكون هناك حماقة أسوأ من هذه؟ ألا تكفّ عن أن تكون أسوأ من المرائين؟ وعندما تتأمل في فداحة هذا الشر العظيم، ألم تخجل من قوة التعبير في هذه الآية؟ لأن المسيح لم يقل فقط إنهم “كالمرائين”، بل أراد أن يفضحهم أكثر، فقال إنهم ” يغيرون وجوههم“، أي إنهم يفسدون وجوههم ويشوهونها. وإذا قيل إنهم يغيرون وجوههم بسبب التفاخر ومحبة المجد الباطل، فما الذي نستطيع أن نقوله عن النسوة اللاتي يفسدن وجوههن بالألوان والأصباغ من أجل الإيقاع بالشباب؟ وإن كان المراؤون يؤذون أنفسهم فقط، فإن هؤلاء النسوة يؤذون أنفسهن والذين ينظرون إليهن. ولهذا يجب أن نهرب بكل قوتنا من كليهما.
والرب لم يوصينا فقط بألاّ نتباهي بما نفعل، لكن أيضًا أن نحاول جاهدين بألاّ يلاحظ أحد ما نفعل، الأمر الذي شدّد عليه سابقًا. وفي حالة الصدقة لم يشرّع الوصية بطريقة مجردة، لكن قال: ” احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس“، ثم أضاف قائلاً: ” لكي ينظروكم” (1:6). أما في حالة الصوم والصلاة لم يحدد مثل هذا الأمر. لأن الصدقة من المستحيل أن تُخفى بالكامل (على الأقل الذي تُعطى له الصدقة يعرف من هو الذي أعطاه)، لكن من الممكن أن تُخفى الصلاة وكذلك الصوم. وعندما قال: ” لا تعرّف شمالك ما تفعله يمينك“، لا يقصد الأيدي، لكن علينا أن نحترس من أن يلاحظنا أحد. وعندما نصحنا بأن ندخل مخدعنا، لم يحدد المكان الوحيد الذي ينبغي أن نصلي فيه، لكن أراد أن يشير إلى نفس المعنى السابق، أي لا يلاحظنا أحد. هكذا بالنسبة لوصيته بأن ندهن رؤوسنا، لا تعنى ـ على أية حال ـ مجرد الدهان، لأننا بذلك سنكون كلنا مخالفين، خاصة الرهبان الذين يسكنون الجبال ولا يستخدمون الزيت لدهان رؤوسهم. إذن لم يحدد هكذا الوصية. لكن بسبب أن القدماء اعتادوا أن يدهنوا رؤوسهم في كل مناسبة سعيدة ـ وهذا ممكن أن يتحقق منه المرء في زمن داود ودانيال ـ قال “ندهن نحن رؤوسنا” ليس لكي نفعل هذا على الدوام، لكن لنعتني بكافة الطرق وباحتراس شديد أن نخفي أمر صيامنا. ولكي تعلم أن الذي أوصي هكذا بالصوم، قد سبق له أن صام أربعين يومًا وظل مختفيًا عن أنظار الجميع ولا دهن رأسه ولا اغتسل. لقد مارس هذه الوصية بدون أن يطلب المجد الباطل أكثر من أي أحد آخر. هذا ما حدده لنا وما عبّر عنه عندما أشار إلى ” المرائين “. وبهذه الوصية قد رد المستمعين عن فعل هذه الأمور الشكلية التي تنشد المجد الباطل. وشئ آخر أراد أن نفهمه بكلمة ” المرائين “، و”المرائي” هو كالممثل، يؤثر على المشاهدين لفترة، فهو يبدو متألقًا يتابعه المشاهدون، ولكن هم يعرفون حقيقته عندما ينتهي هذا العرض المسرحي، وبذلك يكون قد أعاقنا ـ بهذه الإشارة إلى “الممثل” ـ عن محبة هذه الشهوة الشريرة، أي المجد الباطل. فالأغلبية تدرك أن المرائيين يلبسون قناعًا وإنهم سينكشفون حينما يظهر كل شئ مكشوفًا وعريانًا.
أيضًا بطريقة أخرى يُبعد المستمعين عن المرائين، إذ يقدم وصيته على أنها هينة. فلم يجعل الصيام صارمًا، ولا طلب منا المبالغة في الصوم، لكن شدّد على أن لا يُفقد إكليل هذا الصوم. لأن ما يبدو ثقيلاً في الصوم، هو مشترك للكل حتى للمرائين (يقصد العطش والجوع..)، لأنهم يصومون أيضًا. لكن المسيح ينصحنا بألاّ نفقد أجرة تعبنا من هذا الصوم، فهو لا يضيف شيئًا على أتعابنا، لكن لا يريد أن نرحل بلا أكاليل مثل المرائين.
فلا تمارس الفضيلة من أجل اكتساب المجد من الآخرين، ولا تطيع الله من أجل البشر، بل بالحرى البشر من أجل الله.
1 انتهت هنا عظة رقم 19 (التي تشمل تفسير مت1:6ـ15).
2 من هذه الآيات تبدأ العظة 20 (التي تشمل تفسير مت16:6ـ23).