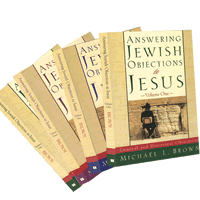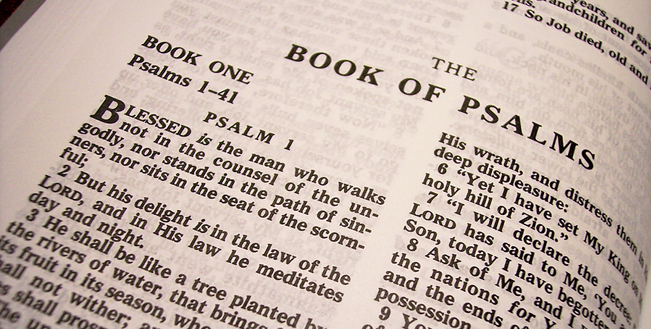so
-
روحيات

لماذا يختبئ الله ولا يتكلم معي؟ James Bishop
لماذا يختبئ الله ولا يتكلم معي؟ James Bishop يطرح الناس هذا السؤال لان الله لم يظهر لهم بالطريقة التي تناسب فكرهم…
أكمل القراءة » -
Matthew

Did Christ come to earth immediately following the Tribulation or sometime later? MATTHEW 24:29
MATTHEW 24:29—Did Christ come to earth immediately following the Tribulation or sometime later? PROBLEM: In Matthew, Jesus represents His coming…
أكمل القراءة » -
Luke

Did Jesus heal the blind man coming into or going out of Jericho? MATTHEW 20:29–34 (cf. Mark 10:46–52; Luke 18:35–43)
MATTHEW 20:29–34 (cf. Mark 10:46–52; Luke 18:35–43)—Did Jesus heal the blind man coming into or going out of Jericho? PROBLEM:…
أكمل القراءة » -
Mark

Who came to talk with Jesus, the mother of James and John or James and John? MATTHEW 20:20 (cf. Mark 10:35)
MATTHEW 20:20 (cf. Mark 10:35)—Who came to talk with Jesus, the mother of James and John or James and John?…
أكمل القراءة » Are believers the light of the world, or is Jesus? MATTHEW 5:14
MATTHEW 5:14—Are believers the light of the world, or is Jesus? PROBLEM: In this passage, Jesus said to His disciples,…
أكمل القراءة »-
Apologetics

Even modern Christian scholars reject the so-called Old Testament proof texts about Jesus. Just check most modern Christian Bible commentaries and translations.
Even modern Christian scholars reject the so-called Old Testament proof texts about Jesus. Just check most modern Christian Bible commentaries…
أكمل القراءة » -
Apologetics

Some of the so-called Messianic prophecies in the Psalms actually speak of the psalmist’s sin and folly. How can you apply this to Jesus?
Some of the so-called Messianic prophecies in the Psalms actually speak of the psalmist’s sin and folly. How can you…
أكمل القراءة » -
Apologetics

If Jesus is really the Messiah, and if he is so important, why doesn’t the Torah speak of him at all?
If Jesus is really the Messiah, and if he is so important, why doesn’t the Torah speak of him at…
أكمل القراءة »