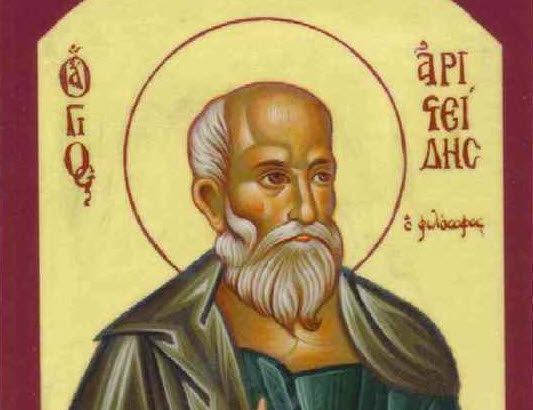العدوى الصالحة – سي إس لويس
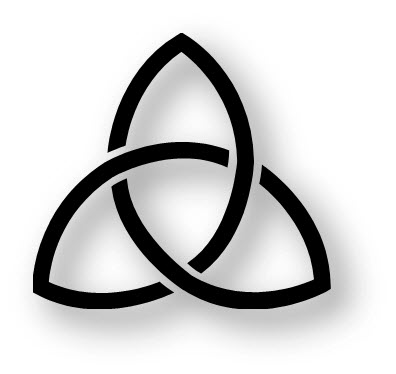
العدوى الصالحة
أستهل هذا الفصل بأن أطلب منك تصور صورة واضحة في ذهنك. تصور كتابين موضوعين على طاولة، أحدهما فوق الآخر. فمن البديهي أن الكتاب السفلي يُبقي الكتاب الآخر في الأعلى، إذ يدعمه. فبسبب الكتاب السفلي، يستقر العلوي على ارتفاع يُقارب خمسة سنتمترات عن سطح الطاولة، بدل أن يُلامسها. ولندع الكتاب السفلي “أ” والعلوي “ب”. فوضعية “أ” تُسبب وضعية “ب”. أهذا واضح؟ والآن لنتصور أن ذينك الكتابين ما زالا على تلك الوضعية منذ الأزل (طبعاً، هذا لا يمكن حدوثه فعلاً، ولكننا نفترضه افتراضاً للتوضيح).
ففي تلك الحالة، تكون وضعية “ب” ناتجة كل حين من وضعية “أ”. ولكن رغم ذلك، ما كانت وضعية “أ” لتنوجد قبل وضعية “ب”. وبكلمة أخرى، فإن النتيجة لا تأتي بعد السبب. من غير ريب أن النتائج دائماً تلي الأسباب: فأنت تأكل الخيار ثم يُصيبك سوء الهضم في أعقاب ذلك. ولكن ليست هذه حال جميع الأسباب والنتائج. وسوف ترى بعد لحظة لماذا أعتبر هذا مهماً.
ذكرت قبل صفحات قليلة أن الله كائن يشتمل على ثلاث شخصيات (أقانيم) فيما يظل كائناً واحداً، مثلما يتكون المكعب من ستة مربعات فيم يبقى مجسماً واحداً. ولكن ما إن أبدأ بمحاولة شرح الكيفية التي بها تترابط هذه الأقانيم، حتى أضطر إلى استخدام كلمات تجعل الأمر يبدو كما لو أن واحداً منها كان موجوداً قبل الآخرين. فالأقنوم الأول يُدعى الآب، والثاني الابن، ونحن نقول أن الأول ولد الثاني أو أنتجه أزلاً، وهذا مدلول التعبير “مولود غير مخلوق”، لأن الناتج هو من ذات طبيعة المُنتج.
ومن هذه الناحية، تكون كلمة “الآب” هي الكلمة الوحيدة الممكن استخدامها. ولكن المؤسف أن هذا الكلمة توحي أنه موجود في الأول، مثلما يكون الأب البشري موجوداً قبل ابنه تماماً. ولكن الحقيقة غير ذلك، فليس الأول والثاني هنا بمعنى السابق واللاحق. لذلك أحسبه أمراً مهماً أن أوضح كيف يمكن أن يكون شيء ما مصدراً أو سبباً أو أصلاً لآخر بغير أن ينوجد قبله. فالابن موجود لأن الآب موجود، ولم يكن قط أي زمان سبق “ولادة” الآب للابن.
ولربما كانت أفضل طريقة للتفكير بهذا الأمر هي هذه. لقد طلبت منك قبل قليل أن تتصور ذينك الكتابين، ولعلك فعلت ذلك. أعني أنك قمت بفعل تصور ونتيجة لذلك تكونت لديك صورة ذهنية. فمن الواضح تماماً أن فعلك التصوري كان السبب، وأن الصورة الذهنية كانت النتيجة. ولكن هذا لا يعني أنك قمت أولاً بالتصور ثم حصلت على الصورة. فلحظة قيامك بالتصور، حصل الصورة. وكانت إرادتك حافظة للصورة أمامك كل حين.
إلا أن فعل الإرادة ذاك والصورة بدءا في اللحظة عينها تماماً وانتهيا في اللحظة عينها أيضاً. فإذا كان هناك كائن ما يزال موجوداً كل حين، وكان دائماً يتصور أمراً واحداً، فإن فعله هذا لابد أن يكون مُنتجاُ كل حين لصورة ذهنية، ولكن الصورة لابد أن تكون أزلية، مثلها مثل فعل التصور تماماً.
بهذه الطريقة، إذا جاز التعبير، علينا أن نفكر في الابن كل حين منبعثاً من الآب انبعاث النور من المصباح، أو الحرارة من النار، أو الأفكار من الذهن. إنه التعبير الذاتي عن الآب: ما يريد الآب أن يقوله. وما كان قط زمانٌ فيه لم يكن قائلاً له. إنما هل لاحظت ما هو حاصل؟ إن هذه الصور كلها، عن النور أو الحرارة، تجعل الأمر يبدو كما لو أن الآب والابن كانا شيئين، لا شخصين. وعليه، ففي نهاية المطاف تبدو صورة العهد الجديد عن الآب وابنه أدق بكثير جداً من أي شيء نحاول أن نستبدله بها.
وذلك هو ما يحصل دائماً حين تبتعد بعيداً عن كلمات الكتاب المقدس. لا بأس في الابتعاد عنها هنيهة لتوضيح نقطة ما. ولكن ينبغي لك دائماً أن تعود إليها. فبطبيعة الحال أن الله يعرف كيف يصف نفسه أفضل بكثير مما نعرف نحن أن نصفه. فهو يعرف أن علاقة الآب والابن أكثر شبهاً بالعلاقة بين الأقنومين الأولين من أي شيء آخر يمكننا أن نفكر فيه. وأهم أمر على الأرجح ينبغي أن نعرفه هو أنها علاقة محبة. فالآب يبتهج بابنه، والابن يرنو إلى أبيه.
إنما قبل المُضي قُدماً، لاحظ الأهمية العملية لهذه الحقيقة. فمختلف أنواع الناس يروقهم جداً تكرار العبارة المسيحة القائلة إن “الله محبة”. ولكن يبدو أنهم لا يلاحظون أن الكلمتين “الله محبة” لا تعنيان أي معنى حقيقي إلا إذا اشتملت الذات الإلهية على شخصين أو أقنومين، على الأقل. فالمحبة أمر يكنُّه شخص لشخص آخر. ولو كان الله شخصاً مُفرداً، لما كان محبة قبل خلق العالم. فطبعاً ما يعنيه هؤلاء القوم حين يقولون إن الله محبة غالباً ما يكون أمراً مختلفاً تماماً، إذ يعنون بالحقيقة أن “المحبة هي الله”.
إنهم يعنون بالحقيقة أن مشاعر المحية لدينا، كيفما وأينما ثارت، وهما كان النتائج التي تُسفر عنها، يجب أن تُعامل باحترام كبير. وربما كان الأمر كذلك، غير أنه أمر مختلف تماماً عما يعنيه المسيحيون بالعبارة: “الله محبة”. فإنهم يؤمنون أن نشاط المحبة الحي الفعال ما زال جارياً في الله منذ الأزل، وهو قد خلق كل شيء آخر.
وبالمناسبة، ربما كان ذلك هو أهم فرق بين المسيحية وباقي الأديان: أن الله في المسيحية ليس شيئاً، ولا حتى شخصاً، جامداً بل هو نشاط فعال نابض: حياة أو حتى دراما من نوع ما. وأكاد أقول، إن كنت لن تحسبني عديم التوقير، إنه نوع من الحركة بين اثنين على إيقاع. ثم إن الاتحاد بين الآب والابن هو أمر حي حقيقي وملموس بحيث إن هذا الاتحاد عينه هو أيضاً شخص أو أقنوم.
في علمي أن هذا مستحيل إدراكه تقريباً، ولكن انظر إليه على هذا النحو: أنت تعلم أنه بين الكائنات البشرية، حين يتحد الناس في عائلة، أو ناد أو نقابة، يتحدثون عن “روح” تلك العائلة أو ذلك النادي أو تلك النقابة. وهم يتحدثون عن “روح” تلك الكيانات لأن الأعضاء الأفراد، حين يكونون معاً، يكتسبون بالفعل طرائق معينة في التكلم والتصرف ما كانت لتكون لهم لو كانوا متفرقين.
(وهذا التصرف الجماعي يمكن بالطبع أن يكون إما أحسن من التصرف الفردي وإما أسوأ منه). فكأنما شخصية مشتركة برزت إلى الوجود. طبعاًن ليس هذه شخصاً حقيقياً، ولكنها بالأحرى تشبه شخصاً فحسب. إلا أن ذلك هو مجرد واحد من الفروق بين الله وبيننا. فالذي يطلع من الحية المشتركة بين الآب والابن هو شخص (أقنوم) حقيقي، بل هو بالحقيقة ثالث أقنوم من الأقانيم الثلاثة التي هي الله.
هذا الشخص الثالث يُدعى، في اللغة التقنية: الروح القدس، أو “روح” الله. فلا تقلق ولا تفاجأ إذا وجدته بالحري أكثر غموضاً أو إبهاماً في ذهنك من الآخرين. وأظن أن ثمة سبباً لوجوب كون الحال كما هو عليه. ففي المسيحية، لا تكون في العادة ناظراً إليه، بل إنه دائماً عامل بك. وإذا فكرت في الآب كشخص موجود “هناك في الخارج” أمامك، وفي الابن كمَن هو واقف بجانبك، مساعداً إياك على الصلاة، وساعياً إلى تحويلك ابناً آخر، فعليك عندئذ أن تُفكر في الأقنوم الثالث كشخص ساكن في داخلك، أو واقف وراءك.
وربما وجد بعضهم أسهل عليهم أن يبدأوا بالأقنوم الثالث ثم يعودوا بأفكارهم إلى الوراء. فإن الله محبة، وهذه المحبة تعمل من خلال البشر، ولا سيما من خلال جماعة المسيحيين بكاملها. غير أن روح المحبة هذا هو، منذ الأزل، محبة جارية بين الآب والابن.
والآن، ما أهمية الأمر كله؟ إنه أمر أهم من كل ما في الدنيا. فإن كامل حركة إيقاع هذه الحياة الثلاثة الأشخاص، أو الدراما أو النموذج المتعلقين بها، يجب أن تُمثل فعلاً في كل واحد منا؛ أو (إن شئنا التعبير بطريقة معاكسة) ينبغي لك منا أن يدخل ذلك النموذج شاغلاً مكانه في الحركة الإيقاعية. وليس من سبيل آخر إلى السعادة التي لأجلها قد صُنعنا. وكما تعلم، فإن الأمور الصالحة، شأنها شأن الطالحة، تُكتسب بنوع من العدوى.
فإن أردت أن تدفأ، ينبغي أن تقف بقرب النار؛ وإن أردت أن تتبلل، ينبغي أن تدخل الماء، وإن أردت الفرح والقوة والسلام والحياة الأبدية، فينبغي أن تقترب، بل أن تدخل أيضاً، إلى حيث تجد هذه الأمور جميعاً. فهي ليس نوعاً من الجائزة التي يستطيع الله، إذا شاء، أن يقدمها إلى أي إنسان. إنها نبع عظيم من الطاقة والبهاء يتدفق من قلب الحقيقة بالذات. فإذا كنت على مقربة منه، يبللك رذاذه؛ وإلا بقيت جافاً. وإذا ما اتحد الإنسان بالله، فكيف لا يسعه أن يحيا إلى الأبد؟ أما إذا كان منفصلاً عن الله، فماذا يسعه أن يفعل سوى الذبول والموت؟
ولكن كيف له أن يتحد بالله؟ كيف يمكننا أن ننجذب إلى قلب حياة الأقانيم الثلاثة؟
لعلك تذكر ما قلته في الفصل الأول من هذا الباب عن “الولادة” والصنع”. فنحن غير مولودين من الله، بل مصنوعون بيده فقط: ففي حالتنا الطبيعية، نحن لسنا أبناء الله، بل مجرد تماثيل (إن صح التعبير). وليس لدينا “زُويي” أو الحياة الروحية، بل فقط “بِيُوس” أو الحياة البيولوجية التي سوف تتوقف وتموت عما قريب. فالآن، هذا هو كامل العرض الذي تقدمه المسيحية: أن في إمكاننا، إذا سمحنا لله بأن يعمل عمله، أن نُقبل إلى الاشتراك في حياة المسيح.
فإذا فعلنا ذلك، فسنكون حينئذٍ مشتركي في حياة “مولودة”، غير مصنوعة، طالما وُجدت كل حيت وستبقى موجودة دائماً أبداً. إن المسيح هو ابن الله. فإن صارت لنا شركة في نوع هذه الحياة، فنحن أيضاً سنصير أبناء الله. وسنحب الآب كما يحبه المسيح، ويمكث الروح القدس ويفيض فينا. فقد جاء المسيح إلى هذا العالم وصار إنساناً لكي يمد الناس الآخرين بنوع الحياة الذي له… بما أدعوه “العدوى الصالحة”. وعلى كل مسيحي أن يصير مسيحاً صغيراً. فليس كامل الغرض من صيرورة المرء مسيحياً بالحق أي شيء آخر سوى هذا!